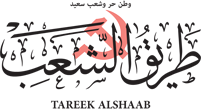الصفحة الثانية عشر
في الذكرى 67 لثورة 14 تموز 1958.. بين تموز الثورة وعراق اليوم: مفارقة المنجز والواقع
عصام الياسري
تمثل ثورة 14 تموز 1958 إحدى أهم المحطات الفارقة في التاريخ الحديث للعراق، ففي ساعات الفجر الأولى من ذلك اليوم، أنهى الجيش العراقي النظام الملكي الذي استمر 37 عاما، معلنا قيام الجمهورية العراقية بقيادة اللواء الركن عبد الكريم قاسم. لم تكن تلك مجرد حركة انقلابية عسكرية، بل، زلزالا سياسيا واجتماعيا غير من ملامح العراق والمنطقة.
كان العراق، منذ تأسيسه كدولة حديثة عام 1921 تحت الانتداب البريطاني، يعيش في ظل النظام الملكي الهاشمي الذي ربط مصيره بالتحالف مع الغرب، لا سيما بريطانيا. وقد واجه النظام تحديات متكررة تمثلت في الاضطرابات الشعبية، التفاوت الطبقي، ضعف التنمية في الريف، وانعدام الحريات السياسية. ازدادت حدة التوترات في خمسينيات القرن الماضي، خصوصا ـ بعد توقيع العراق وتركيا وبريطانيا وإيران وباكستان حلف بغداد عام 1955، الذي فسر على أنه اصطفاف مباشر مع المصالح الغربية في ذروة الحرب الباردة، مما أثار معارضة شعبية واسعة بين صفوف اليساريين والقوميين والعسكريين.
في 14 تموز 1958، قاد عبد الكريم قاسم، بمعية مجموعة من الضباط تحت لواء ما سمي بـ "تنظيم الضباط الأحرار"، للسيطرة على العاصمة بغداد وإسقاط النظام الملكي. تم الهجوم على القصر الملكي. وفي بيان إذاعي شهير، أعلن قيام الجمهورية العراقية، وبدء عهد جديد.
رفعت الثورة شعارات التغيير الاجتماعي والتحرر الوطني ونجحت في تحقيق عدد من التحولات الهامة، من أبرزها: إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية. التحرر من التبعية الأجنبية، وخصوصا ـ لبريطانيا. الخروج من حلف بغداد وتبني سياسة عدم الانحياز. تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل. التوسع في التعليم والصحة بشكل كبير. تقوية الصناعات الوطنية وتقييد نفوذ الشركات الأجنبية. تحسين أوضاع الفلاحين عبر إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي أعاد توزيع الأراضي على الفلاحين. إطلاق الحريات العامة وحقوق المرأة والطفولة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
لكن بالمقابل، واجه النظام الجديد صراعات داخلية خطيرة بين التيارات القومية الشعبوية واليسارية، وتفاقمت الخلافات بين قيادات الثورة العسكريين، لا سيما قاسم وعبد السلام عارف. كما فشل النظام في بناء مؤسسات ديمقراطية راسخة، وظل الحكم محصورا في يد النخبة العسكرية.
تعد ثورة 14 تموز لحظة فاصلة في تاريخ العراق، فهي أول تجربة للجمهورية، وأول محاولة لتقويض البنية الإقطاعية الاستعمارية. ومع ذلك، فإن تقييم إرثها يظل منقسما: هناك من يراها ثورة وطنية تقدمية أعادت الكرامة للعراقيين. وهناك من يراها بداية الاضطراب السياسي والعنف والانقلابات المتعاقبة. في كلتا الحالتين، لا يمكن إنكار أن ما حدث في فجر 14 تموز 1958 قد فتح صفحة جديدة في التاريخ العراقي، غيرت موازين القوى الداخلية والإقليمية...
في الذكرى الـ 67، يجد العراقيون أنفسهم أمام إرث معقد، تتداخل فيه اللحظة الثورية مع تداعياتها الطويلة. فبينما يعيش العراق اليوم تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، فإن استذكار ثورة تموز يظل مناسبة لإعادة تقييم العلاقة بين السلطة والشعب، بين الدولة والمجتمع، وبين طموحات التحرر ومخاطر الاستبداد. لكن من المؤكد بين تموز الأمس وعراق اليوم من حيث لحظة التحول الكبرى ـ في السياق السياسي والاجتماعي: مفارقات الثورة والدولة. كان 14 تموز، يوما للخلاص، بقدر ما كان بداية لسؤال مفتوح: كيف نبني دولة عادلة، حديثة، مستقلة؟
أما واقع العراق المعاصر من حيث ما أنجزته ثورة 14 تموز 1958 خلال سنوات حكمها القصيرة، وبين ما يمر به العراق اليوم من أزمات بنيوية وأحداث أخرت تطور العراق، في ظل تعثر التنمية وتفشي الفساد وتراجع الحريات، بالمطلق، ليس هناك أوجه للمقارنة. وفيما يطل الماضي على الحاضر بسؤال مؤلم: ما الذي تحقق للعراقيين بعد كل تلك التضحيات؟ وهل بات العراق اليوم أفضل حالا مما كان عليه قبل عقود من التغيير والانقلابات والحروب والاحتلال؟ لا شك أن الموازنة بين حقبة ما بعد الثورة وما يشهده العراق المعاصر من أزمات عميقة، تكشف عن مفارقة تاريخية لافتة.
عراق اليوم، دولة غنية، لكنها تعاني من الفقر والفساد. فمنذ الغزو الأميركي في عام 2003، دخل العراق مرحلة عنوانها ظاهريا "التحول الديمقراطي" الهش، لكنه سرعان ما تعثر في مستنقعات الطائفية والفساد وغياب الرؤية الوطنية. ومن أبرز مفارقات الواقع العراقي المعاصر: الفساد المؤسساتي، إذ يعتبر العراق اليوم من بين الدول الأعلى في مؤشرات الفساد المالي والإداري، بحسب منظمة الشفافية الدولية. مئات المليارات من الدولارات أهدرت أو سرقت منذ 2003، دون محاسبة تذكر. شلل مؤسسات الدولة، والمحاصصة الطائفية والاثنية لها أثرها في تعطيل بناء المؤسسات الفعالة.
خاتمة: رغم كل ما يمكن أن يقال عن أخطاء ثورة تموز، فإنها كانت، في جوهرها، حركة نهضوية امتلكت رؤية واضحة لبناء وطن مستقل ومتوازن اجتماعي. أما اليوم، فإن العراق يقف، رغم الموارد الهائلة، على مفترق طرق خطير، بلا مشروع وطني جامع، وبلا قيادة قادرة على كسر حلقة الفساد والتبعية. قد تكون الموازنة بين الماضي والحاضر غير عادلة في بعض جوانبها بسبب اختلاف السياقات، لكن الشعوب تقيس التجارب بالنتائج. ووفق هذه المعادلة، فإن ما تحقق في بضع سنوات بعد 1958 يبدو أكثر رسوخا مما تحقق في أكثر من عقدين لما بعد 2003...
*******************************************
قراءة اليسار الإسباني المتحد لراهن إسبانيا
رشيد غويلب
تمر إسبانيا بأزمة سياسية، وعلى الرغم من ذلك، فإن مواقف الحكومة الإسبانية متميزة، بالمقارنة مع مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. ويمكن الإشارة هنا إلى رفض الخضوع لإملاءات ترامب، بتخصيص بنسبة 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لأغراض العسكرة، وكذلك الموقف المتميز من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب لفلسطيني، فضلا عن اعتماد سياسات اجتماعية أكثر تقدمية، مقارنة بالشركاء الأوربيين. يحكم إسبانيا تحالف حكومي يضم إلى جانب الحزب الاشتراكي الإسباني (ديمقراطي اجتماعي) بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تحالف سومار اليساري بزعامة نائبة رئيس الوزراء يولندا دياز، الذي يضم العديد من الأحزاب والمنظمات اليسارية، لعل أبرزها "اليسار الإسباني المتحد، الذي يشكل الحزب الشيوعي الإسباني قوته الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك تضم المعارضة البرلمانية قوى يسارية خارج تحالف سومار لعل أبرزها حزب بودوموس، الذي ترك تحالف سومار، ولم يشارك في التحالف الحاكم.
ورغم وجود تباينات داخل تحالف سومار، وكذلك مع حزب بودوموس، الا ان تأثير اليسار على مجمل سياسات الحكومة ملموس.
في السابع من حزيران، هدد إنريكي سانتياغو، السكرتير العام للحزب الشيوعي، بمغادرة التحالف الحاكم، إذا وافق سانشيز على تحقيق هدف الناتو البالغ 5 في المائة، خلال قمة الناتو في لاهاي. والمعروف أن سانشيز يحتاج إلى طمأنة حلفائه اليساريين، بسبب تزايد فضائح الفساد داخل حزبه الحاكم، بالإضافة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد فوز اليمين المحافظ في حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة. إن ما حدث يؤكد أن ضغط اليسار يحقق أهدافه، إذا ما تم استخدامه بمصداقية ووضوح عاليين.
قمة الناتو
وافقت إسبانيا على إعلان قمة الناتو، لكنها رفضت في الوقت نفسه الالتزام بتخصيص 5 في المائة من الناتج ا الإجمالي المحلي للعسكرة. أثار هذا القرار غضب الرئيس الأمريكي ترامب، الذي قال إنه سيجعل إسبانيا تدفع ثمن ذلك، وهددها بمضاعفة الرسوم الكمركية.
ويشأن الموقف من القضية الفلسطينية دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في 26 حزيران الفائت، إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورًا. وأكد إن "وضعًا كارثيًا يُمثل إبادة جماعية يتطور في قطاع غزة". إلا أن رؤساء الحكومات أرجأوا القرار إلى اجتماع وزراء الخارجية الأخير.
وقبل اجتماع وزراء الخارجية، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستضغط من أجل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر على توريد الأسلحة إليها، وحظر على منتجات المستوطنات، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية.
بيان اليسار الإسباني المتحد
ردا على تهديدات ترامب، أصدر اليسار الإسباني المتحد بيانا، ادان فيه بشدة تهديدات دونالد ترامب لإسبانيا خلال قمة حلف الناتو في لاهاي. وقال البيان: "لقد أظهر الرئيس الأمريكي بوضوح دوره كطاغية إمبراطوري، مُحذرًا من أن إسبانيا ستدفع "ثمنًا مضاعفًا" في مفاوضات التجارة المستقبلية إذا لم ترفع إنفاقها العسكري إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".
ووصف البيان تصريحات الرئيس الأمريكي بالإهانة لسيادة إسبانيا، وأنها تكشف عن الطبيعة الحقيقية لحلف الناتو، باعتباره أداة للهيمنة في خدمة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، الذي يحول الدول الأعضاء إلى تابعين ملزمين بملء خزائنه.
ورفض اليسار المتحد قرار الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من أن هذا المبلغ أقل مما حدده الناتو، إلا أنه لا يلبي الاحتياجات الحقيقية للشعب الإسباني. وشدد اليسار المتحد على ان الأمر لا يتعلق بنسب مئوية، بل بإنهاء التسلح واستخدام هذه الموارد في الصحة والتعليم والسياسات الاجتماعية.
وطالب اليسار المتحد بانسحاب إسبانيا من حلف الناتو، الذي تتمثل مهمته في تأجيج الصراعات لصالح الإمبريالية الأمريكية، وإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها. ودعا البيان إلى التعبئة الاجتماعية والسياسية للدفاع عن سيادة إسبانيا وحق الشعوب في تقرير مصيرها، في مواجهة ابتزاز ترامب والتصعيد العسكري.
قراءة للراهن الإسباني
أجرت جريدة "المانيفستو" الشيوعية الإيطالية، حوارا مع المنسق الجديد لـ "اليسار الإسباني المتحد" أنطونيو مايلو في 13 تموز 2025. قدم فيه قراءة للتطورات الرئيسية الجارية في بلاده والموقف منها. نقدم في ما يلي عرضا لنص الحوار المنشور في موقع "شيوعيون" الألماني في 14 تموز 2025.
اعتبر منسق اليسار المتحد، إسبانيا نقطة المقاومة الجيوسياسية الوحيدة في أوروبا، داعيا إلى البناء على هذه النقطة مثالا يحتذى به لمقاومة الهيمنة الأوربية بالنسبة للبلدان الأخرى. والمعروف أن اليسار الإسباني المتحد تأسس عام 1986، وهو إطار يجمع بين صيغة التحالف والحزب، اذ يعتبر الحزب الشيوعي الإسباني قوته الرئيسة إلى جانب منظمات يسارية بيئية صغيرة.
أنطونيو مايلو، لغوي ومعلم لاتيني ويوناني، يشغل منصب المنسق العام اليسار الإسباني المتحد بالوكالة منذ أكثر من عام.
إمكانية تفكيك المكتسبات الاجتماعية
منطقيا هذه المكتسبات قابله للتفكيك، إذا توفرت لليمين المتطرف القدرة على ذلك. وليس من الثابت اجتماعيا، أن التقدم المتحقق غير قابل للتراجع، وخاصةً التقدم الذي يُمثل نموذجًا حضاريًا، مثل الرعاية الصحية الشاملة، الذي يمكن تدميره ليصبح حالة عابرة.
ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الحريات الشخصية المكتسبة. إن الفاشيات الجديدة تبني نموذجًا استبداديًا يسعى إلى فرض نوع من وعي قائم على "كفى"، وهو رؤية يمينية متطرفة، ترى ان النظام السائد قد تجاوزنا الحدود. خطاب الهزيمة هذا يدفعهم إلى إحياء مشروعهم الرجعي بشكل ملحمي، بكل ما تعنيه المفردة: رد فعل على التقدم الذي يعتبرونه تهديدًا لنموذجهم الاجتماعي. في هذه الحالة، يجري التحليل، بعيدا من التفاؤل أو التشاؤم، وهما قيمتان ذاتيتان، بل على أرضية المنهج الجدلي. أي أن الأمر سيعتمد على كيفية تنظيم اليسار لصفوفه، وكيفية تعامله، حتى لا يُعتبر صعود اليمين الاستبدادي أمرًا مُسلّمًا به.
وبشكل ملموس، وعلى سبيل المثال، فان تفسير اللحظة التاريخية الراهنة في إسبانيا، على أنها لحظة مقاومة. ان ما سينتج عن هذه المناقشة’ سيحدد المستقبل. حاليا، ومن الناحية الجيوسياسية، ليس هناك في الاتحاد الأوروبي سوى نقطة مقاومة واحدة، هي إسبانيا. يجب أن نبني على هذه النقطة مثالًا للدول الأخرى في مواجهة الهيمنة المضادة.
ليس جميع قوى اليسار الإسباني تقرأ هذه اللحظة بهذه الطريقة، وهذا هو الخطأ، يقول من يسمون أنفسهم "اليسار الحقيقي": "حسنًا، سيصل حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس الفاشي إلى السلطة، وعلينا أن ننظم أنفسنا للمقاومة عند حدوث ذلك". كلا، المقاومة قائمة الآن، وهي لا تعني المساهمة في إسقاط هذه الحكومة. شئنا أم أبينا، ونتمنى لو كانت الحكومة الحالية أكثر جرأة. لكن سياسيًا، هذه هي الفرصة الأمثل حاليًا للدفاع عن نموذج الأمل الديمقراطي.
موقف الحكومة من الأزمة الحالية
بذل " اليسار الإسباني المتحد" جهدًا كبيرً، لكي يلقي رئيس الوزراء خطابه في البرلمان بشأن سبل تجاوز الازمة الراهنة. ويعد الخطاب استجابة أولية لأزمة كانت وما تزال بالغة الخطورة، وتتطلب نهجًا متعدد الجوانب. لكن سياسة الحكومة تُعكس في قراراتها. ولهذا يجب أن تكون مكافحة الفساد إحدى هذه القرارات، وأن تُعالج بحزم وبشفافية مطلقة، وفي المقدمة منها قرارات ولوائح تقضي على الممارسات التي تُغذي الفساد والتي قوّضت النظام السياسي الإسباني لسنوات.
ومع ذلك، لا يعتبر اليسار المتحد الخطاب كافيا، ما لم يكن مصحوب بممارسة ملموسة، ولهذا من الضروري استئناف النقاش حول قانون الموازنة، مع التركيز بشكل خاص على قضية الإسكان، وهي قضية تؤثر بشكل مباشر على الطبقة العاملة. إن اليسار المتحد مقتنع بأن أفضل طريقة حكومية لمعالجة مشكلة سياسية ليست التراجع، بل المضي قدمًا م بعزيمة أكبر.
ويتمنى اليسار المتحد المزيد من إجراءات مكافحة الفساد؛ واقترح 35 إجراءً، بعضها حظي بالقبول. لكن الانطباع العام إيجابي: كان هناك قناعة راسخة لدى جميع القوى الداعمة للحكومة بضرورة تغيير الأداء لضمان الاستمرار.
ولهذا يؤكد اليسار المتحد على ان قضية السكن تُشكّل جوهر التناقضات الاجتماعية، إذ تستهلك الجزء الأكبر من دخل العمل، وغالبًا ما تُقوّض تحسين الأجور أو العقود، وتخفيض ساعات العمل، وغيرها من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف العمل. وهذا ما يجعلها ذات أهمية محورية لأنها تسبق جميع المشاكل الأخرى. فبدون السكن، لا يملك المرء حتى المساحة الكافية لتخطيط حياة آمنة.
أما النقاش الرئيسي الآخر، فيدور حول بناء أنظمة بديلة: نظام أمني قائم على السلام يمنع دوامة الإنفاق العسكري المتزايد باستمرار. ولهذا السبب، يريد اليسار المتحد الحديث عن الميزانية، لأنها تحديدًا تُعالج وتُحسم فيها جميع القضايا التي تحتاج إلى تحسين. ومن المعروف انّ حكومة سانشيز لم تُقر ميزانية منذ عام 2022.
وكذلك يرى اليسار المتحد ضروري المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، إصلاحات لا رجعة فيها، بغض النظر عمن سيحكم في المستقبل. وهنا، يكمن السر في تعزيز الخدمات العامة وحمايتها، وترسيخ الحقوق الأساسية في الدستور. وأن إجراء نقاش جاد حول الإصلاح الدستوري في هذا السياق أمرٌ مثير للاهتمام وضروري للغاية.
الحضور السياسي لليسار المتحد
لا يركز اليسار المتحد حصريًا على وزارة الشباب والطفولة الموكلة إليه، بل يهتم أيضًا بالتعليم والصحة والإسكان والعمل والأمن والدفاع. واليسار المتحد منخرط في جميع القضايا الأساسية.
صحيح ان اليسار المتحد لم يأخذ استحقاقه، خلال عملية تشكيل القوائم الأوروبية. كان هناك موقف من جانب بعض الأشخاص الذين لم يكونوا على قدر المسؤولية وأظهروا نيةً مُعينةً لإذلال اليسار المتحد. ودفع اليسار المتحد ثمن قراره المسؤول: قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية، في عدم مواصلة تجزئة القائمة الانتخابية، مُدركا التداعيات على المستوى الوطني. لكن اليسار المتحد موجود في 1085 بلدية، وله أكثر من 100 رئيس بلدية. هذا يعني أنه واقع ملموس ومتين وذو جذور عميقة في المجتمع المدني، وهو أمر أساسي لأي مشروع سياسي ذي مصداقية.
يجب أن يغير اليسار المتحد نهجه. ويتجاوز منطق الدور المفرط للقيادة الذي ميّز التجربة الفاشلة لتحالف "يونيداس بوديموس"، وكذلك تجربة تحالف "سومار". في أي مشروع يساري، إما أن تطور رؤية مشتركة بجهد مشترك، وإلا سيموت المشروع، كما سيموت سياسا القادة، الذين بسبب الدورة السياسية الحالية، أصبحوا مجرد شخصيات عابرة. سيواصل اليسار المتحد تركيزه على السياسة، ونؤكد دورنا بكل احترام. وإذا وُجدت صيغٌ ومنظماتٌ أخرى تحظى بدعمٍ أكبر، فسيقر اليسار المتحد بدورها. لكن يجب أن ينعكس ذلك بالأفعال، لا بالسيطرة على المؤسسات أو السلطة التي تفرض إرادتها على الآخرين.
قيادة جديدة
ردا على توليه مهام منسق اليسار الإسباني المتحد، خلفا لسلفه البرتوا غارثون، الذي تولى أيضا مهام برلمانية ووزارية، أشار أنطونيو مايلو إلى ان المهام السياسية تنهك المتصديين لها، وخصوصا من يجمع بين أكثر من مهمة حزبية وحكومية. وفي الوقت الحالي، على المرء أن يتقبل حقيقة الإرهاق في نهاية كل مرحلة. ان العام الواحد في الدورات السياسية اليوم يساوي سبع أعوام فعلية. لم نعد نعيش ما يُسمى بالعصر "الفوردي"، حيث كان هناك نموذج قادة يستطيعون الاستمرار بمهامهم 10 أو 15 أو حتى 20 عامًا، على غرار القادة الأسطوريين للأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية.
لقد قضت حقبة ما بعد الفوردية الراهنة على أي يقين في هذا الصدد. ولا ينبغي المبالغة في إرهاق المتصديين للمهام السياسية في نهاية دورة. بوضوح، ان سبب وجودهم في مواقع المسؤولية ليتعبوا، أي يقدموا أفضل ما لديهم في وقت محدود. ومن الأفضل أن يكون هذا أمرًا هيكليًا، وليس مجرد نتيجة إرادة أو ظروف خاصة، بل أسلوبًا أصيلًا في ممارسة السياسة. أن أحد الأخطاء الجسيمة هو ممارسة مسؤوليات في مستويات متقدمة لفترة طويلة. إما أن تُقدم أفضل ما لديك، ثم لا تستطيع البقاء طويلًا. أو أن تُطيل البقاء لأنك، في جوهرك، لم تعد تُقدم أفضل ما لديك..
*********************************************
الصفحة الثالثة عشر
في الأردن.. ناشطة تدخل في اضراب مفتوح عن الطعام
عمان - وكالات
دخلت الناشطة الأردنية، بشرى شاكر العبسي في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد مراكز التوقيف، احتجاجا على توقيفها إداريا منذ نحو أسبوعين، دون توجيه أي تهمة رسمية بحقها أو عرضها على جهة قضائية مختصة.
وتم توقيف الناشطة العبسي على خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي المناصر لغزة، ضمن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الناشطين مؤخرا.
وتم نقل العبسي إلى الحبس الانفرادي كإجراء عقابي بسبب إضرابها، كما تم منعها من استخدام المياه اللازمة للوضوء والاغتسال، مع الاقتصار على تزويدها بمياه الشرب فقط.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت في وقت سابق، إن مئات النشطاء يمثلون أمام القضاة الأردني، ويتم إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف، إلا أنهم بحسب ما قال محامون وناشطون يعاد اعتقالهم عبر وزارة الداخلية باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري "المسيئة"، ويجبر بعض المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامات طائلة.
وفي تقريرها الأخير للوضع الحقوقي في الأردن، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن المحافظين المحليين في الأردن يواصلون استخدام قانون منع الجرائم الذي يعود إلى 1954 لاحتجاز النشطاء، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام هيئة قضائية مختصة.
قاضية أمريكية توقف ترحيل مهاجرين وتنتقد العداء العنصري
كاليفورنيا – وكالات
أوقفت قاضية فدرالية أمريكية في ولاية كاليفورنيا مؤقتاً، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل آلاف المهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا، معتبرة أن الإلغاء "قد يكون مدفوعاً بدوافع عنصرية".
وقالت القاضية ترينا تومسون، إن المدعين "يسعون فقط إلى فرصة للعيش بحرية بلا خوف وتحقيق الحلم الأمريكي"، مضيفة أن ما يُطلب منهم "هو التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم"، مؤكدة أن المحكمة "لا توافق على ذلك".
وكانت إدارة ترامب قد ألغت في وقت سابق وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف مهاجر من هندوراس و3 آلاف من نيكاراغوا، دخلوا الولايات المتحدة بعد إعصار "ميتش" عام 1998، إضافة إلى نحو 7 آلاف نيبالي فرّوا من زلزال مدمر ضرب بلادهم عام 2015.
وتمنح الولايات المتحدة "وضع الحماية المؤقتة" للأجانب الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم بسبب نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف أمنية استثنائية.
كما ألغت إدارة ترامب الوضع نفسه لمهاجرين من دول أخرى مثل أفغانستان والكاميرون وهايتي وفنزويلا، إلا أن تلك القرارات تواجه بدورها طعوناً قضائية.
********************************************
تقرير أمريكي يُكذب ترامب: واشنطن أنفقت 3 ملايين فقط على غزة وليس 60 مليوناً
{رايتس ووتش}: إسرائيل حوّلت توزيع المساعدات الى حمام دم ومصيدة للموت
رام الله - وكالات
تم تحويل عملية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إلى "حمام دم" و"مصيدة للموت"، بعد أن اقامت القوات الإسرائيلية نظاما "عسكريا معيبا" لتوزيع المساعدات في غزة، وفق ما جاء في تقرير نشرته الجمعة منظمة هيومن رايتس ووتش.
وجاء في التقرير إن "عمليات قتل القوات الإسرائيلية للفلسطينيين الباحثين عن طعام هي جرائم حرب".
التجويع سلاح حرب
وقالت المنظمة ان "الوضع الإنساني الكارثي (في غزة) هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل التجويع سلاح حرب - وهو جريمة حرب - فضلا عن عرقلتها المتعمدة والمستمرة لدخول المساعدات الإنسانية وتأمين الخدمات الأساسية".
وبات قطاع غزة مهددا "بالمجاعة على نطاق واسع" وفقا للأمم المتحدة، ويعتمد كليا على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو.
ويذكر أنه بعد حصار شامل فرضته على القطاع مطلع آذار متسببة بنقص حادّ في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل في نهاية أيار بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة وترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.
وأردفت هيومن رايتس ووتش القول: "وقعت حوادث أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بشكل شبه يومي في مراكز توزيع المساعدات الأربعة التي تديرها" مؤسسة غزة الإنسانية.
قتلى المساعدات!
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا قتلوا منذ 27 أيار "أثناء البحث عن طعام".
وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن "ما لا يقل عن 859 فلسطينيا قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بالقرب من هذه المراكز التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية بين 27 أيار و31 تموز، معظمهم قتلهم الجيش الإسرائيلي وفقا للأمم المتحدة".
وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة، في حصيلة محدثة، أن 1373 فلسطينيا قُتلوا، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة منذ ذلك التاريخ.
محاولات يائسة للحصول على الطعام
وتقول بلقيس ويلي نائبة مدير قسم الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش في التقرير "لا تقوم القوات الإسرائيلية بتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة عمدا فحسب، بل إنها تطلق النار يوميا على أولئك الذين يحاولون بشكل يائس تأمين الطعام لعائلاتهم".
وتوضح ويلي، ان "القوات الإسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة والمتعاقدين من القطاع الخاص، أنشأت نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات الإنسانية حوَّل عمليات توزيع المساعدات إلى حمام دم".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى انه "بدلا من تأمين الغذاء للسكان في مئات المواقع التي يمكن الوصول إليها في مختلف أنحاء غزة، فإن آلية التوزيع الجديدة التي أنشأتها مؤسسة غزة الإنسانية تفرض على الفلسطينيين عبور مناطق خطيرة ومدمرة".
كما نقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم: إن "القوات الإسرائيلية تشرف على تنقل الفلسطينيين إلى المواقع من خلال استخدام الذخيرة الحية".
انتقادات دولية
في تناقض صارخ مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ادعى فيها أن الولايات المتحدة قدّمت 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لقطاع غزة، كشف تقرير حديث أن المبلغ الفعلي المصروف حتى الآن لم يتجاوز 3 ملايين دولار فقط.
يأتي هذا الكشف في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لسياسة الحصار الإسرائيلي، مع تقارير موثقة تفيد بسقوط مئات الضحايا المدنيين بالقرب من نقاط توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة، ما دفع عدة دول إلى المطالبة بأن تتولى الأمم المتحدة مهمة الإغاثة بدلًا من الآلية الحالية المثيرة للجدل.
من جهتها، أفادت منصة "بوليتي فاكت" الأمريكية المختصة بتدقيق الحقائق، أن المبلغ الفعلي الموافق عليه هو 30 مليون دولار، وليس 60، وأن ما صُرف حتى يوم الجمعة الماضي لا يتجاوز 10% من هذا المبلغ، أي ما يقارب 3 ملايين دولار فقط.
وبحسب التقرير، فإن البيت الأبيض أعطى الضوء الأخضر لهذا التمويل في أواخر حزيران، بينما نقلت وكالة رويترز عن مساعدين للمبعوث الأمريكي الخاص إلى غزة، ستيف ويتكوف، أن (إسرائيل) وافقت على المساهمة بمبلغ مماثل.
*************************************
موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا
مدريد - وكالات
اجتاحت الطبقة السياسية في إسبانيا موجة استقالات وسط تصاعد التدقيق في صحة الشهادات الأكاديمية، ما أثر على شخصيات من مختلف الأطياف السياسية وبروز دعوات لمزيد من الشفافية.
بدأت الأزمة في 21 حزيران عندما أثار وزير النقل أوسكار بوينتي من الحزب الاشتراكي تساؤلات حول السجل الأكاديمي لنويليا نونيز، وهي نائبة عن الحزب الشعبي المعارض.
نونيز، البالغة من العمر 33 عاما، كانت تدعي حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنجليزية، لكنها اعترفت لاحقا بأنها درست هذه المواد دون استكمال أي من المؤهلات، ما دفعها للاستقالة في اليوم التالي، مؤكدة أنها لم تكن تنوي تضليل الجمهور.
ومنذ ذلك الحين، تعرض عدد من السياسيين لاتهامات بتقديم معلومات غير دقيقة عن خلفياتهم التعليمية.
ومن بين هؤلاء خوان مانويل مورينو، رئيس الحزب الشعبي والحاكم الإقليمي لأندلسيا، الذي اتهم بادعاء كاذب بحصوله على شهادة في إدارة الأعمال.
كما اتهمت بيلار بيرنابي، مندوبة الحكومة المركزية في فالنسيا، بتقديم معلومات غير دقيقة حول حصولها على شهادة في الإعلام.
*****************************************
استقلال القضاء والصراعات الاستراتيجية.. قضية بولسونارو امتحان لسيادة القانون في أمريكا اللاتينية
رشيد غويلب
تحولت محاكمة الرئيس البرازيلي الفاشي السابق جايير بولسونارو إلى خلاف جيوسياسي شامل. وفضيحة دبلوماسية بين البرازيل والويات المتحدة. من جهة تدافع المحكمة العليا البرازيلية عن استقلالها ضد تدخل دونالد ترامب، ومن جهة أخرى يفرض ترامب حظرًا على التأشيرات، ليس ضد بولسونارو، بل ضد المحكمة الدستورية البرازيلية بأكملها تقريبًا. ويرد الرئيس البرازيلي "لولا" بغضب، واصفًا سلوك ترامب بالاعتداء على سيادة البلاد. بالنتيجة نحن امام عملية طمس خطيرة للحدود بين الاختصاص القضائي والدبلوماسية والضغط الجيوسياسي.
تجاوز في السياسة الخارجية
تهمة بولسونارو هي التخطيط والتحضير لانقلاب بعد هزيمته في انتخابات عام ٢٠٢٢. وتعتبر محاكمة بولسونارو اخنبار نوعي للديمقراطية البرازيلية: هل ستتمكن البلاد من محاسبة رئيس سابق استبدادي من خلال سيادة القانون، أم يُفرض ستنهار تحت ضغط سياسي خارجي؟. وتُحوّل العقوبات الأمريكية الأخيرة النقاش ا من المسؤولية السياسية المحلية إلى استعراض دولي للقوة.
كان التجاوز على سيادة البرازيل، والخروج عن أصول السياسة الخارجية واضحا. لقد وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القضاء البرازيلي بأنه "نظام مُستغل سياسيًا"، وأصدر حظر سفر على القاضي ألكسندر دي مورايس وعائلته و"زملاء آخرين في المحكمة". ومع توسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل سبعة قضاة دستوريين آخرين بما في ذلك رئيس المحكمة الدستورية العليا لويس روبرتو باروسو، أصبحت مؤسسة قضائية شرعية ديمقراطيًا، ولأول مرة في التاريخ، خاضعة لعقوبات شبه كاملة من قوة عظمى. أضف الى ذلك شمول المدعي العام باولو غونيت أ، كما أكد المدعي العام خورخي ميسياس، أدى الى تفاقم الوضع. ووصف الرئيس البرازيلي هذا الإجراء بأنه "تعسفي ولا أساس له "، ويمثل فضيحة دبلوماسية ذات أبعاد تاريخية.
إمبراطور غير مرغوب فيه
كشف الحدث طابع العلاقة الأيديولوجية والاستراتيجية الوثيقة بين جايير بولسونارو ودونالد ترامب. ويمثل تدخل ترامب لصالح صديقه الفاشي تجاوزا كبيرًا في السياسة الخارجية وعلى القضاء البرازيلي وابتزازًا اقتصاديًا في شكل زيادة عقابية بنسبة 50 في المائة للرسوم الكمركية على السلع البرازيلية بدءًا من آب المقبل. يقدم بولسونارو نفسه على أنه محارب مناهض للصين ومدافع عن القيم الغربية، وهي صورة تكتسب زخمًا عبر دعم ترامب له في واشنطن. في الوقت نفسه، أصبح بولسونارو عبئًا على العلاقات الخارجية للبرازيل: لا تنظر حكومة الرئيس "لولا إلى سلوكه على أنه هجوم سياسي محلي فقط، بل أيضًا كمحاولة لزعزعة علاقات البلاد الدولية.
يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوترات بين دول الجنوب العالمي، والقوى الغربية. وصف بولسونارو مؤخرًا دول البريكس بأنها "أخوة للديكتاتوريين ومجرمي الحرب"، بينما شبّه "لولا" السياسة الخارجية الأمريكية بـ „التعدي الإمبريالي". في قمة البريكس في ريو، سخر "لولا" من ترامب ووصفه بأنه "إمبراطور غير مرغوب فيه"، وهي صياغة تنطوي على إهانة، يبدو انها كانت محفز لفرض ترامب عقوباته الاقتصادية. جيوسياسا ينقسم العالم بين الحكومات اليسارية في الجنوب التي تؤكد على استقلاليتها، وحكومات الشمال اليمينية واليمينية المتطرفة التي تعتمد على نفوذ واشنطن.
أصبح استقلال القضاء الوطني مادة لصراع عالمي. يؤكد الرئيس البرازيلي والمدعي العام ميسياس أن المحاكم البرازيلية "لا ترهبها التهديدات أو المؤامرات". إلا أن حجم الهجوم غير مسبوق بشمول العقوبات الامريكية ثمانية من أصل أحد عشر قاضيًا في محكمة العليا في البرازيل، ليس بتهمة الفساد أو انتهاكات القانون الدولي، بل بسبب أداء مهامهم الدستورية. وهذا يثير تساؤلًا بشأن قدرة المؤسسات الديمقراطية في دول الجنوب العالمي على العمل باستقلالية في المستقبل، إذا تعارضت مع المصالح الجيوسياسية لدول الشمال.
القضية البرازيلية بمثابة رسالة ً إلى ديمقراطيات أخرى في الجنوب العالمي: هل ستكون واشنطن مستعدة لمعاقبة الهيئات القضائية المستقلة في دول أخرى علنًا إذا لم تلتزم بالسياسة الخارجية الأمريكية؟ تدعم حكومة البرازيل المحكمةَ بوضوح، وهي خطوةٌ استراتيجيةٌ مهمةٌ في الدفاع عن السيادة واستقلالية القضاء. ولكن هذا لا يلغي المخاوف بشأن سيادة البرازيل واستقلال قضائها، اللذان قد يصبحا رهينةَ مصالح جيوسياسية.
لم تعد قضية بولسونارو مسألة قانونية بحتة. فهي تعكس التوازن الهش بين السيادة الوطنية والنفوذ العالمي، وبين استقلال القضاء والحسابات الجيوسياسية. وتنظر البرازيل إلى سلوك ترامب في تخريب الإجراءات البرازيلية من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ليس فقط على أنها تدخل في الشؤون الداخلية، بل انتهاك للسيادة، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب على العلاقات مع الولايات المتحدة. إن كيفية تجاوز البرازيل لهذه الأزمة قد تُحدد مسار دول الجنوب العالمي الآن وفي المستقبل القريب.
***************************************
الصفحة الرابعة عشر
قضية القومية العربية في فكر محمود أمين العالم
صلاح عدلي*
سوف أحاول في هذه المقالة عرض المواقف الفكرية للمفكر المصري الكبير محمود أمين العالِم تجاه القضية القومية كواحدة من بعض القضايا المهمة والملتبسة لتوضيح موقف الشيوعيين المصريين منها، خاصة وأنه يتعرض لمناقشتها بمنهج ماركسي علمي، ويتناولها من جوانبها النظرية والسياسية ويطرحها في إطار رؤية نضالية موضوعية وراهنية في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية.
وفي دراسة مهمة بعنوان “الماركسيون المصريون والقضية العربية” الصادرة في سلسلة كتاب “قضايا فكرية” التي أشرف على إصدارها هذا المفكر الموسوعي العدد (11-12) يوليو 1992، يتناول العالم موقف الشيوعيين المصريين من قضيتين محوريتين في نضال الشعوب العربية، الموقف من قضية القومية والوحدة العربية، والموقف من القضية الفلسطينية. وسوف نقوم بعرض موجز لوجهة نظره في القضية الأولى، مع التأكيد على أهمية قراءة النص الكامل لهذه الدراسة التي تم إصدارها في كتيب بنفس العنوان صادر من دار الثقافة الجديدة.
في بداية الدراسة يرى العالم أنه من الضرورة تصحيح خطأ أو إزالة وهم يعلق بكثير من العقول حول موقف الماركسيين المصريين أو الماركسيين العرب من قضية الوحدة العربية، فالشائع أو الذي يشاع باستمرار وتسعى إلى ضخه في العقول مختلف الأجهزة الرسمية – وكتابات بعض المفكرين للأسف- أن الماركسيين المصريين (والعرب عامة) معادون للوحدة العربية، ومتهاونون -على أقل تقدير- في القضية الفلسطينية.
ويؤكد العالم بعد أن يضرب بعض الأمثلة على أن الحقيقة الواقعية التاريخية الناصعة تؤكد خلاف هذا تماماً، فالحزب الشيوعي المصري كان أول الأحزاب المصرية المنظمة في تاريخنا الحديث الذي نادى بالوحدة العربية منذ عشرينيات القرن العشرين، فهناك وثيقة صادرة عن “عصبة النضال ضد الإمبريالية” التي تأسست عام 1927 في بروكسل، وشارك فيها وفد من الشيوعيين المصريين والعرب، تتحدث “عن حق العرب في القضاء على تقسيم وطنهم، وتكوين دولة موحدة قوية مستقلة وحرة”، وتحيي هذه الوثيقة المناضلين الذين يدافعون عن حقوق الأمة العربية، ثم تنتهي هذه الوثيقة المبكرة عام 1929 بشعارات محددة تقول: “عاش النضال التحرري للشعب العربي، ليسقط الإمبرياليون، ليسقط تقسيم البلدان العربية، لتحيا الدولة الفيدرالية العربية الموحدة”.
وفي برنامج الحزب الشيوعي المصري الصادر عام 1931 ينص البند الثاني مباشرة على “النضال من أجل تحرير الشعوب العربية من القهر الاستعماري، ومن أجل وحدة عربية شاملة تنتظم فيها كل الشعوب العربية الحرة”.
وللتدليل على ثبات واستمرار هذا الموقف يشير محمود العالم إلى حدث هام يتعلق بالوحدة المصرية السورية التي تمت عام 1958، حيث تؤكد الوثائق الثابتة أن الحزب الشيوعي المصري كان من دعاة هذه الوحدة ومن مؤيديها المدافعين عنها، وإن كان قد انتقد الأسلوب البيروقراطي العلوي اللا ديمقراطي في إنجازها، هذا الأسلوب الذي لم يراعِ الملابسات الشعبية والموضوعية الخاصة بسوريا، وهناك وثيقة تعرفها وتشير إليها مختلف الدراسات العربية والدولية التي تؤرخ لهذا الموقف، وهي وثيقة منسوبة إلى “فريد وسيد” وهما الاسمان الحركيان آنذاك لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس. ثم يضيف العالم متعجباً فيقول “ومن العجيب أننا عندما قدمنا للمحاكمة عام 1959 كانت التهمة الموجهة إلينا هي تهمة العداء للوحدة المصرية السورية، وللقومية العربية عامة!”.
وبرغم ما عاناه الشيوعيون من سجن وتعذيب في هذه المرحلة فعندما وقع الانفصال السوري عام 1961 خرج الشيوعيون بمظاهرة ضخمة في مكتب سجن الواحات الخارجة ينددون بالانفصال. وعندما تحدث عبد الناصر عن أخطاء الوحدة ودروس الانفصال بعد ذلك أشار بوضوح إلى “ضرورة مراعاة الملابسات والقسمات الخاصة لكل بلد عند تحقيق أي وحدة. وكان بهذا يتبنى رأياً اتهمنا بسببه بأننا أعداء الوحدة!”.
ويؤكد العالم أن الشيوعيين المصريين يقفون بغير شك من هذه القضية موقفاً مبدئياً ويناضلون من أجلها بحسم وموضوعية ويقفون في مقدمة الصفوف في نضالهم الواعي من أجل إنجازها. ثم يثير العالم سؤالاً كبيراً: “هل معنى هذا أن هناك اتفاقاً عاماً بين الماركسيين المصريين (والماركسيين العرب عامة) وبين بقية الفصائل القومية العربية بالنسبة لقضية الوحدة العربية وقضية تحرير فلسطين، وإجابته على هذا السؤال هي نعم ولا!! نعم من حيث الهدف العام، وهو تحقيق الوحدة الشاملة وتحرير الوطن الفلسطيني.
أما لا.. فتتعلق بمفهوم الوحدة ومنهج وشروط تحقيقها، وكذلك الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية.. وإن كنا نركز في هذا العرض على قضية الوحدة والقومية العربية.
الفرق بين القضية القومية والفكر القومي
وهنا يحرص الكاتب الكبير على التمييز بين أمرين: الأول هو الفكر القومي والثاني هو القضية القومية. ويؤكد: نعم هناك قضية قومية تتعلق بها جهودنا ونضالنا وتضحياتنا، وهي تحرير البلاد العربية جميعها، وتقدمها ووحدتها، ويوضح أن هناك فارقاً بين القضية القومية وبين الفكر القومي الذي يتم الخلط بينه في أغلب الأحيان وبين القضية القومية إلى حد يصبح مرادفاً لها، وهذا غير صحيح وغير دقيق.. فالفكر القومي هو بالفعل فكر يتبنى القضية القومية ويناضل من أجل تحقيقها، ولكنه فكر يغلب عليه الطابع الانفعالي الاستعلائي المثالي، وهو فكر يفتقد الرؤية الموضوعية للتاريخ والمجتمع والواقع عامة، ويتحرك ويسلك متسلحاً بنظرة إرادوية تتغافل عن حقائق الاختلافات والتمايزات العرقية والطبقية والظروف الاجتماعية في بلادنا العربية.
ويرى العالم – دون الدخول في التفاصيل- أن كثيراً من المشاكل والمآسي التي تعرضت، وما تزال تتعرض لها القضية القومية والقضية الفلسطينية، إنما هي بسبب هذا الفكر القومي. والقضية القومية يمكن بل ينبغي أن تعالَج بمنهج آخر هو المنهج العقلاني العلمي الموضوعي الذي تتعدد داخله الاجتهادات؛ والماركسية هي اجتهاد موضوعي جاد بين هذه الاجتهادات التي تتصدى لقضية القومية.
ثم يصل العالِم إلى نتيجة مهمة وموضوعية، وهي أن تسمية أصحاب الفكر القومي وحدهم بالقوميين وسحب هذه التسمية عن الماركسيين أمر غير صحيح وغير دقيق؛ فالماركسيون قوميون كذلك، إنهم ليسوا قوميين فكراً، ولكنهم قوميون نضالاً وهدفاً. ومن هنا ينبع الاختلاف بين الماركسيين وبين مختلف الحركات القومية حول قضية الوحدة العربية والقضية الفلسطينية.
شروط الإطار العام لاستراتيجية الوحدة العربية
إن الوحدة العربية واقع موضوعي تتوفر بعض مقوماته الأساسية من جذور عميقة مشتركة في قلب تاريخنا العربي الإسلامي القديم والحديث، ولغة مشتركة وأرض مشتركة ليس بالمعنى الجغرافي فحسب بل بمعنى التعامل والتفاعل والتبادل كذلك، ولكن هذا الواقع الموضوعي ما يزال يفتقد بعض المقومات الأخرى حتى يتحقق، ولهذا فهو ما يزال إمكانية نضالية وليس واقعاً متحققاً كما يذهب بعض المفكرين، فما أكثر ظواهر الاختلاف التي لا سبيل إلى تجاهلها والوثوب فوقها.
إن القضاء على الاختلافات لا يكون بتجاهلها وإنما بالاعتراف بها وتفهمها تمهيداً للسيطرة المعرفية عليها.
فالبلاد العربية تختلف فيما بينها من حيث أشكال الحكم، والأيديولوجيات السياسية السائدة، ومن حيث الأبنية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة المتعارضة، وهناك اختلافات شاسعة في مستوى المعيشة وحجم السكان ومستوى التطور الثقافي والحضاري والسياسي.
وإلى جانب هذا كله تتسم البلاد العربية جميعاً بسِمتين مشتركتين، هما التخلف والتبعية للرأسمالية الاحتكارية والإمبريالية العالمية، وهما سمتان تفرقان أكثر مما توحدان، وإن كان من الممكن أن تصبحا أرضية مشتركة للنضال المشترك إذ أنهما تضعان شعوب البلدان العربية جميعاً أمام مرحلة ومهمة ثورية واحدة مباشرة وعاجلة هي مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية. إلا أن ما يحد بل يجهض هذه الإمكانية النضالية هو طبيعة الأنظمة العربية البرجوازية التابعة بمراتبها ومستوياتها وتوجهاتها المختلفة.
وفي ضوء هذا الواقع يرى العالم ضرورة وضع إطار عام لإستراتيجية للوحدة العربية رغم هذه الصورة الزاعقة من التمايز والاختلاف والتفاوت بين البلدان العربية. ويحدد بعض العناصر والشروط الأساسية لهذا الإطار في النقاط التالية:
أولاً: لا سبيل إلى وحدة عربية شاملة أو جزئية أو محدودة بين بلدين أو أكثر إذا لم تقم أولاً على أساس وطني تحرري معادٍ للاستعمار والإمبريالية والصهيونية، وهذه هي الأرضية السياسية الأساسية الأولى للوحدة، وهي المدخل الأول الضروري لطريق الوحدة.
ثانياً: لا سبيل إلى تحقيق الوحدة العربية شاملة أو جزئية أو محدودة دون أرضية مشتركة أو متقاربة؛ أي لا يمكن أن تتم وحدة بين دولة ذات توجه اشتراكي يسودها التخطيط والقطاع العام مع دولة ذات توجه رأسمالي تسودها قوانين السوق والمشروع الحر. وهذا هو الأساس الاقتصادي للوحدة الذي يتداخل مع الأساس السياسي الأول.
ثالثاً: لا سبيل إلى تحقيق الوحدة العربية بالباراشوت من أعلى بالقمع أو الغزو من الخارج؛ وإنما يجب أن تتم من خلال تلاحم وتفاعل القوى السياسية الوطنية والتقدمية والمنظمات الجماهيرية والاختيار الواعي الديمقراطي الحر بغير ضغوط ديماغوجية أو قمعية، وهذا هو الأساس الديمقراطي للوحدة.
رابعاً: لا يوجد شكل محدد جاهز للوحدة القومية. وإنما يختلف الأمر باختلاف البلاد وواقعها وظروفها ومستوى النضج الديمقراطي والاجتماعي فيها، فقد تتم الوحدة بشكل دمجي أو كونفدرالي أو فيدرالي بين بلدين أو أكثر، لكن ينبغي أن يخضع الشكل لضرورات الواقع وظروفه وإرادة الجماهير.
خامساً: لا يمكن أن تقوم وحدة صحيحة وصحية على حساب الأقليات العرقية ودون مراعاة لحقوقهم الديمقراطية كاملةً في اختيار شكل الحكم الملائم لهم وحماية تراثهم وثقافتهم. ولا يمكن أن تقوم الوحدة دون مراعاة للتراث الديني والروحي والأخلاقي والثقافي عامة واحترام ما فيه من اختلافات واجتهادات.
هذه هي الشروط الأساسية التي تشكل العناصر والشروط الإستراتيجية للوحدة كما يراها العالم، ولكنه يشير إلى أن هذا وحدة لا يكفي، إذ لا بد أن نحدد أولويات هذه العناصر وأساليب العمل في ظل الظروف الآنية، أي لا بد أن يكون هناك برنامج عمل مباشر وتحديد أساليب إنجازه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الأمين العام للحزب الشيوعي المصري
منصة "تقدم" – 14 تموز 2025
*************************************
قاموس اقتصادي فلسفي.. الدخل القومي
اعداد: د. صالح ياسر
قبل المباشرة في تعريف الدخل القومي (National Income) لا بد من التوقف عند بعض التعاريف التي يتعين التمييز بينها.
الناتج القومي الاجمالي -GNP Gross National Production ويقصد به قيمة سائر السلع والخدمات النهائية بأسعار السوق، والتي تنتج بوساطة عناصر الانتاج في الاقتصاد الوطني (سواء تمت هذه العملية داخل البلد أو خارجه) خلال فترة زمنية محددة (سنة واحدة عادة). وهذا المقياس يساعدنا في تحديد مستويات التطور الاجتماعي (من بينها مستوى المعيشة)، كما يساعدنا على فهم بعض الظواهر الاقتصادية، كالتشغيل الكامل، والبطالة والتضخم. وبذلك يكون الناتج القومي الاجمالي مقياسا لمقدارما ينتجه الاقتصاد في فترة زمنية محددة.
الناتج القومي الصافي -NNP Net National Product ويقصد به الناتج القومي الإجمالي مطروحا منه نفقات الاندثار للأصول الرأسمالية المختلفة التي يمتلكها المجتمع.
الناتج المحلي الاجمالي - GDP Gross Domestic Product ويقصد به قيمة اجمالي السلع والخدمات النهائية بأسعار السوق والمنتجة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة (تكون سنة عادة)، بغض النظر عما اذا كانت تلك السلع والخدمات منتجة بوساطة هيئات وطنية أو أجنبية. واساس تحديد الناتج المحلي جغرافي الطابع أي ما ينتج داخل حدود البلد الواحد.
إنه مقياس للسلع والخدمات التي أنتجها النشاط الاقتصادي في مجموعة خلال فترة من الزمن، ويتم الحصول عليه بتقييم السلع والخدمات التي أنتجت خلال السنة بأسعار السوق ثم تجميع هذه القيم. ويلاحظ استبعاد قيم المنتجات الوسيطة ( Intermediate products ) التي دخلت في منتجات أخرى، وبذلك نقتصر على السلع والخدمات التي أنتجت للإستهلاك النهائي وكذلك سلع الاستثمار وذلك لأن قيم المنتجات الوسيطة دخلت في حساب قيم المنتجات النهائية وادخالها في الحساب يؤدي إلى الازدواج في التقييم. أما المنتجات الوسيطة التي أنتجت خلال السنة ولا تزال كما هي فتدخل قيمها في الحساب. وكلمة إجمالي ( (Gross تعني عدم استبعاد أي مبالغ بغرض الاهتلاك واستبدال السلع الرأسمالية التي تعمل في الإنتاج بسبب تقادمها. ونظرا لأن الدخل الناتج من الاستثمارات التي يمتلكها المواطنون والمؤسسات المحلية والدولة في الخارج لم يحسب ضمن القيمة التي وصلنا إليها واقتصر الامر فقط على السلع والخدمات التي أنتجت في داخل الدولة لذلك استخدمت كلمة محلي Domestic للتمييز بين هذه القيمة وقيمة الإنتاج القومي الإجمالي. ونظراً إلى أننا لم نأخذ في اعتبارنا الضرائب غير المباشرة والإعانات لتعديل القيمة التي وصلنا إليها، لذلك يشار إلى هذه القيمة على أنها الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق ( at market prices ) .
نعود الان الى الدخل القومي.
لفهم ما المقصود بالدخل القومي National Income لا بد من العودة الى المنتوج الاجتماعي الاجمالي حيث يمكن تقسيمه الى القيمة القديمة و القيمة المتكونة من جديد، وذلك من حيث التركيب القيمي للمنتوج. فالجزء الأول أي رأس المال الثابت (ث) يعوض وسائل الانتاج المستهلكة خلال عملية الإنتاج وذلك خلال فترة محددة. أما الجزء الثاني من المنتوج الاجتماعي الاجمالي الذي يبقى بعد تعويض وسائل الانتاج المستهلكة فهو الذي يشكل الدخل القومي للمجتمع. ومن الناحية الطبيعية يتمثل هذا في مواد الاستهلاك ووسائل الإنتاج التي تغطي الاستهلاك والتراكم. والقيمة الجديدة التي تتكون في عام معين تساوي في مقدارها الدخل القومي.
من المعروف أن قياسات الدخل القومي توضح المعدَّل الذي يتغير به اقتصاد البلاد. كما توضح تلك القياسات مدى استقرار الاقتصاد. ويمكن للاقتصاد أن يعاني من عدم الاستقرار إذا تقلب الدخل القومي بصورةٍ كبيرة بين سنة وأخرى. كذلك، توضح أرقام الدخل القومي كيفية توزيع الدخل بين كلٍّ من الأجور والفوائد والأرباح والريع.
يصحِّح كل من الحكومة وقطاع الصناعة ميزانياتهما آخذين في الحسبان مستوى التوزيع، ومعدل التغيير الذي يحدث في الدخل القومي، فإذا تناقص الدخل القومي، على سبيل المثال، يمكن للحكومة أن تخفض من الضرائب، وذلك بهدف إعطاء الناس المزيد من الدخل المتاح للتصرف فيه بالإنفاق. فإذا أنفق الناس هذه الزيادة التي حدثت في دخولهم على السلع والخدمات المنتَجة محليًّا، فإن درجة نشاط الأعمال ستتزايد، ويؤدي ذلك إلى إيجاد المزيد من الوظائف وفرص العمل، الأمر الذي قد يقود بدوره إلى تزايد الدخل القوميّ.
ويعتبر الدخل القومي مؤشرا هاما يدل على القدرة الاقتصادية للبلاد علما ان الأمر الاهم هو كيفية توزيع هذا الدخل بين السكان وهذا الاخير مرتبط بطيعة علاقات التوزيع التي هي انعكاس لعلاقات الملكية السائدة.
************************************
{خطاب الكراهية} حرية التعبير وقصور المواجهة بالقوانين
منع الكلمة لا يمنع الشرور، بل قد يؤجّجها. ضمن هذا الاعتبار، يأتي كتاب "خطاب الكراهية: بين الرقابة القانونية وحرية التعبير" للباحثة الأميركية نادين ستروسن، الصادر حديثاً عن مركز نهوض للدراسات والنشر في الكويت، بترجمة أحمد علي ضبش وأحمد عاطف أحمد. يقع الكتاب في 224 صفحة، ويناقش العلاقة بين قوانين تجريم خطاب الكراهية، ومبادئ حرية التعبير والمساواة.
يركز الكتاب على مدى اتّساق القوانين التي تجرّم هذا النوع من الخطاب، مع الضمانات الدستورية، وإن كانت تحقق هدفها في الحد من التمييز والعنف، أم أنّها تُستخدم لقمع معارضي الأنظمة، والصحافة، والحركات الطلابية، خاصة حين يكون تعريف الكراهية تعريفاً تأويلياً.
ترى ستروسن أنّ قوانين تجريم الكراهية بصياغاتها العامة، قد تؤدي إلى نتائج عكسية تمنح أصحاب هذه الخطابات شعوراً واهماً بالمظلومية. وتعتمد الباحثة في مقاربتها على التعديل الأول للدستور الأميركي أساساً لحماية حرية التعبير.
يتألف الكتاب من ثمانية فصول، يناقش الفصل الأول إشكالية تعريف خطاب الكراهية قانونياً. ويعرض الثاني تعارض القوانين التي تحاربه، مع مبادئ المساواة وصون الحريات. يتناول الفصل الثالث الاستثناءات التي يجيز فيها القانون تقييد الخطاب، كالتحريض المباشر على العنف. ويعرض الفصل الرابع الإشكالات الناتجة عن عمومية الصياغات القانونية. ويبحث الفصل الخامس في تعريفات دقيقة تتجنب غموض القوانين.
أما الفصل السادس فيبحث في الأذى المعنوي للكراهية، عبر مجموعة من الدراسات الإحصائية تناقش الأثر الفعلي للإعلام في عمليات الإبادة. ويدرس الفصل السابع فعالية القوانين، لتقترح الباحثة في الفصل الثامن والأخير بدائل غير رقابية لمواجهة خطاب الكراهية؛ منها التعليم والعمل المجتمعي.
تشير ستروسن إلى حالات قانونية في فرنسا وألمانيا والدنمارك وكندا وكينيا والهند، حيث أُدين أفراد بسبب تعبيرهم عن آراء دينية أو سياسية، واستخدمت القوانين لتقييد حرية المعارضة. وتفرد نقاشاً خاصاً لحالة رواندا بعد إبادة 1994، بالتفريق بين التحريض المباشر، الذي ترى ضرورة تجريمه، وبين خطابات الكراهية العامة التي يمكن نقاشها في أكثر من مستوى.
ويرى الكتاب أن مواجهة خطاب الكراهية تكون أكثر فاعلية عبر أدوات غير رقابية، أهمها الخطاب المضاد. تخلص أيضاً إلى أن حماية حرية التعبير، لا تقويضها، هي ما يتيح للمجتمعات معالجة الظواهر الإقصائية. فالمجتمعات التي تُواجه الكراهية علناً، هي الأقدر على تفكيكها. كما تستشهد بمواقف لرموز في حركة الحقوق المدنية الأميركية، مثل جون لويس وثورغود مارشال، وآخرين ممن رأوا في حرية التعبير أداة للنضال، لا تهديداً له.
الكتاب بإشكاليته الرئيسية، لا يدافع عن خطاب الكراهية، إنما عن حرية التعبير، ويدعو إلى استخدامها لمواجهته، لا لتعزيزه في إجراءات قانونية قد يُساء استخدامها من قبل السلطات السياسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"العربي الجديد" – 11 تموز 2025
**********************************************
الصفحة الخامسة عشر
جديد دار توليب للنشر
(توليب) اسم لدار نشر جديدة تم افتتاحها في شارع المتنبي/ بغداد، بإدارة واشراف القاصة تماضر كريم، وبهدف دعم هذه الدار الفتية والزميلة المبدعة التي تديرها نقدم قائمة بعناوين الكتب التي اصدرتها الدار مؤخراً وهي:
- شهية طيبة/ مقالات لعلي اليساري.
- الحرنكش/ قصص- بهاء البابلي.
- رؤية العالم في شعر المجانين العباسيين/ دراسة في البنيوية التكوينية- أ. د. عامر صلال راهي و /. م. خديجة مجيد.
- سمة المجادلة لدى علماء النفس والشرع والمناطقة/ تأليف محمد احمد عبد الله سليم الفياض.
- قصص تهرب الى مكيشيفة/ قصص علي الصالح.
- كلك ليس لك/ نصوص شعرية- ناصر العقابي.
- اثر من نور/ خطوات تعليم القرآن الكريم/ رحيم عليوي الخزعلي.
- لماذا تغيرت افكاري؟ من عمق الانكسار الى قوة الاكتمال/ تأليف فاروق لفلوف.
- احببتك بما لا يصلح للنجاة/ شعر حميد الزبيدي.
********************************************
جائزة للموتى.. السلطة لا تُحب مَن يكتب وتخشى مَن يقرأ وتلاحق مَن يُفكّر!
د. ياس خضير البياتي
في أوطاننا التي تُزهر فيها الكراسي وتذبل فيها العقول، يبدو أن المثقف العربي وُلد في الزمن الخطأ، واللغة الخطأ، والحي الخطأ، وربما حتى في القارة الخطأ. يعيش المثقف حالة تشبه "الكائن الممنوع من الصرف"، لا يقبله الواقع، ولا يعترف به النظام، ولا تستوعبه الحاشية. يُولد ليتعذّب، يُبدع ليتّهم، ويموت ليُكرَّم. تلك هي المعادلة التي يحفظها التاريخ العربي عن ظهر خذلان.
فبينما يتم تتويج الجهل وتوزيع الأوسمة على صُنّاع الفراغ، يُعامَل المثقف كفيروسٍ خطير يجب احتواؤه، أو كـ “فكرة مزعجة" يجب إسكاتها. السلطة لا تحبّ من يكتب، وتخشى من يقرأ، وتلاحق من يفكر. لماذا؟ لأنه يكتب معرفة، والمعرفة حياة، والحياة أمرٌ خطير في بلاد اعتادت أن تُدار كالمقابر: هادئة، ساكنة، لا ضجيج فيها إلا لمن ينبش.
رأيته بعيني: زياد الرحباني، الذي جاء من رحم فيروز العظيمة، يتلقى وسام الأرز الوطني، لكن وهو مستلقٍ في نعشه، صامتًا لأول مرة، كما لو أن الصمت هو الشرط الوحيد لنيل التكريم في أوطاننا. لم يجدوا وقتًا أنسب لتكريمه من لحظة وداعه. وضعوا الوسام على التابوت، بحنيّة رسمية باردة. كانت الصورة مؤلمة، لا لهيبة الموت، بل لسخرية الحياة. فهنا، الوسام لا يُمنح للموهبة، بل يُمنح مقابل أن تموت أخيرًا!
عربياً، تجد نموذج صلاح عبد الصبور، الذي حوصر حيًا، وامتدح ميتًا. ونجيب سرور، الذي دُفع إلى الجنون، ثم أصبحت قصائده تُدرّس في السر. وفرج فودة، المفكر الذي دفع ثمن كلماته بالدم، ثم أقيمت له الندوات بعد أن صار قبرًا.
وفي الجزائر، الشاعر مفدي زكريا، صاحب النشيد الوطني، عاش منفيًا، وأُهمل في حياته على الرغم من عطائه، وتم تخليد اسمه بعد أن اختفى صوته. وفي سوريا، لم يكن محمد الماغوط مجرد شاعر، بل مرآة متشققة تعكس واقع العرب، لكن ماذا نال؟ عاش فقيرًا، مريضًا، يُضحك الناس ويبكي داخله، ثم مُنح أوسمة بعد أن غادر.
نفس المشهد في المغرب مع المهدي المنجرة، العالم والمفكر، الذي صُنِّف خطيرًا على الأمن الفكري، لأنه كان يُفكر بصوت مرتفع. لم يُحتفَ به إلا بعد موته!
لكن القصة لا تبدأ بزياد، ولا تنتهي عنده. إنها "ترند" تاريخي لا تبطل موضته. اسأل العراق، أرض الحضارات والمكتبات المحروقة. أين علماء العراق؟ أين مثقفوه؟ ستجدهم إما في المنافي، أو تحت التراب، أو في طوابير البطالة ينتظرون قرارًا سياديًا يسمح لهم بالحلم. قامات علمية وثقافية هُشّمت كما تُهشَّم تماثيل الآلهة القديمة، دون أن يرفّ جفنٌ لوزارة، أو ينتبه مسؤولٌ كان مشغولًا بالسرقة.
قائمة طويلة من العمالقة ماتوا مهمومين، مهملين، محاصَرين بالخذلان: غائب طعمة فرمان… روائي المنفى، كتب بغداد من بعيد، وبغداد لم تبعث له حتى تحية. فؤاد التكرلي… الروائي الذي فضح القمع بنصوصٍ خرساء، مات والنخب الثقافية مشغولة بكتابة خطب التعزية.
عبد الرحمن الربيعي… صوت الجنوب المهمَّش، خُذل حيًّا، وحُفرت له جائزة بعد أن دفنوه. عبد الملك نوري موسى كريدي، أحمد خلف، فهد الأسدي … نخبة من الرواة والشعراء، ماتوا دون أن يسمعوا كلمة "شكرًا" من الدولة.
أما إذا دخلنا ميدان الشعر، فالدموع وحدها لا تكفي: حسين مردان… الرجل الذي كتب بروحه، مات غريبًا، لأن الوطن لا يحتمل "زائدَ جرأة". بدر شاكر السيّاب… مبتكر قصيدة التفعيلة، مات على سريرٍ من الألم، تتقاذفه المستشفيات كما تتقاذفنا العواصم. نازك الملائكة… التي علمتنا أن الشعر أنثى، ماتت صامتة، لم تجد حتى أنشودة وداعٍ تليق بها. سعدي يوسف… آخر الغجر الرحّل في عالم القصيدة، مات كما عاش: خارج النص الرسمي.
محمد مهدي الجواهري، الشاعر الذي نُفي وعانى التهميش، لم يجد راحته إلا في الغربة. كُرّم بعد موته بتمثال، لأن صوته في حياته كان يزعج السلطات. هادي العلوي، المفكر الماركسي، مات في منفاه، وجاءت النخبة تتحدث عن "أثره العظيم" بعد أن مات، وكأنهم اكتشفوه بالصدفة. حسين علي محفوظ، عميد الأدب العراقي، قضى حياته بين المخطوطات واللغات، وتُوفي دون أن تُخصص له دولة كان خدمها حتى النهاية مكانًا بحثيًا لائقًا.
عبد الوهاب البياتي … رجل المنفى الدائم، جريمته الوحيدة أنه لم يرضَ أن يكون بندقية فكرية لأحد، فظل عالقًا بين التكفير والتجاهل.
والقائمة تطول وتُبكي، بل تُضحك من شدة البكاء. المثقف في الوطن العربي كائن مؤجل؛ لا تصبح "قيمة وطنية" إلا إذا سكت نهائيًا عن الكلام المباح.
المثقف العربي لا يجد كرسياً في ندوة، لكنه يُمنح تمثالًا بعد موته. لا يستطيع دفع إيجار بيته، لكن اسمه يُطلق على شارع بعد وفاته. لا يجد من يشتري له كتابًا، لكن كتبه تُعرض في المعارض بعد أن يتحلل جسده بسلام. والمفارقة الساخرة أن الجائزة الوحيدة التي يضمنها المثقف في هذه الحياة هي: جائزة ما بعد الموت!
هكذا يُعامَل المثقف في الوطن العربي: إذا قال الحقيقة، فهو "خطر أمني". إذا سكت، فهو "غير فاعل". إذا هاجر، فهو "خائن". وإذا مات… يصبح "رمزًا وطنيًا". عندها، تبدأ مهرجانات التكريم، وتتنافس الوزارات في إرسال باقات ورد إلى قبره، وكأنهم يعتذرون… متأخرين، كعادة العرب مع الاعتذار.
أيها المثقف العربي، لا تتعب نفسك بالكتابة ولا تحلم بالإنصاف. فالتكريم هنا يبدأ حين تنتهي. متْ فقط، وسيتحول صمتك إلى قصيدة، وتابوتك إلى منصة. ستُمنح الأوسمة لأنك لم تعد تشكل تهديدًا. فالمجد في بلادك لا يُمنح للأحياء… بل يُعلَّق على النعوش.
*******************************************
الانفعالي والإدراكي في التلقي المسرحي
عواد علي
من المحاولات التأسيسية المبكّرة، التي اقترحت قراءات للعرض المسرحي في ضوء العلاقة بين منتجه ومتلقيه، بتأثير من جمالية التلقي، محاولة الباحث المسرحي الإيطالي ماركو دي مارينيز في دراسته "الانفعال والتأويل في تجربة المتلقي مع المسرح: ضد بعض الميثولوجيات ما بعد الحداثية". ينطلق دي مارينيز من نقد بعض الدراسات المسرحية التي سمّاها دراسات ما بعد حداثية، خاصةً في ما يتعلق بموقفها من تجربة المتلقي، فهي تختصر هذه التجربة في ما هو انفعالي، أي أنها تعدّ الانفعال بمنزلة التأثير الوحيد للعرض المسرحي على المتلقي، كما تعدّه ظاهرةً مباشرةً ومستقلةً عن العمليات المعرفية الأخرى كالتأويل والتقويم والتذكّر.
إن هذه النظرية الانفعالية تصدر، في نظر دي مارينيز، عن رؤية ساذجة ورومانسية جديدة، لذا حاول بناء تصور مغاير حول تجربة المتلقي، انطلاقًا من قواعد نفسية ومعرفية صحيحة، بلوره في إطار ما سمّاه بـ"التصور السيميو- معرفي في التجربة المسرحية"، هذا التصور الذي يرفض التقابل بين ما هو انفعالي وما هو إدراكي، ويؤكد أن التجربة المسرحية، بوصفها تجربةً جماليةً، ينبغي أن تفهم كمجموعة معقدة من العمليات الإدراكية، التأويلية، الانفعالية، والتقويمية... إلخ، والتي تتداخل كلها، وتتفاعل فيما بينها.
ويستنتج بعض الباحثين من ذلك أن المتلقي، كيفما كان موقعه وعلاقته بالعرض المسرحي، ليس سلبيًا، كما أن تجربة التلقي لديه لا تنبني على معطيات حسية فقط، بل يتداخل فيها ما هو انفعالي، وما هو إدراكي ومعرفي، وإذ يربط هذه العمليات بطبيعة العرض المسرحي، فإنه يلاحظ أن المتلقي عند مشاهدته لعرض مسرحي يحاول تكوين بنية حكائية حول ما يجري أمامه، والعمل على ربطها بالفضاء والشخصيات والزمان، كما يحاول تفكيك بعض العلامات، وإيجاد علاقة بينها من أجل بناء المعنى، لأنه في غياب معنى ما يحس المتلقي وكأنه عاش نوعًا من الانقطاع في اللذة الجمالية والفنية.
لكن ما يثير الاستغراب في دراسة دي مارينيز، التي تهتم، أيضًا، بتطور نظرية "فعل الكلام"، بوصفها نموذجًا سياقيًا تطبيقيًا (تداوليًا) لاستجابة المسرحية، تصنيفه للدراسات التي تختصر تجربة المتلقي في ما هو انفعالي بأنها "دراسات ما بعد حداثية"، إلى جانب وصفها بأنها "تصدر عن رؤية ساذجة ورومانسية جديدة"، علمًا أن الدراسات التي تركّز على الوظيفة الانفعالية، أو التعبيرية في الأدب والفن تعدّ دراسات قديمةً من وجهة نظر النقد الحديث، وكان ريتشاردز قد ميّز في الثلاثينيات من القرن الماضي بين الوظيفة الانفعالية والوظيفة الرمزية للغة، من خلال اهتمامه "بذات المبدع، متأثرًا بإنجازات علم النفس الباهرة آنذاك، ورأى أن الوظيفتين حاضرتان في أي خطاب، وإنْ تفاوت حضورهما، لكنه أكد على أن الأولى هي المهيمنة على الخطاب الشعري" .
وفي مقاله "اللسانيات والشعرية" الذي نُشر بالإنجليزية عام 1960، بحث اللغوي والمنظّر الأدبي الروسي رومان ياكبسون هذه الوظيفة، التي اقترحها مارتينيز، ضمن نموذج العوامل الستة المكونة للفعل الاتصالي، ووظيفة كل واحد منها في الخطاب اللغوي، ذاهبًا إلى أنها "تركّز على المرسِل، وتهدف إلى أن تعبّر بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه، وهي تنزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معيّن صادق أو خادع". وقد ضرب ياكوبسون مثالًا على هذه الوظيفة بممثل قديم، في مسرح استانسلافسكي بموسكو، حكى له "كيف كان المخرج الشهير يطلب منه، حينما كان يؤدي عرضًا تجريبيًا لمسرحية ما، أن يستخرج أربعين رسالةً مختلفةً من عبارة "هذا المساء" بوساطة تنويع التلوينات التعبيرية. وكان قد وضع قائمةً مكونةً من بضعة أربعين موقفًا انفعاليًا، وبعد ذلك تلفظ بالعبارة المذكورة في توافق مع كل موقف من هذه المواقف، التي على المستمعين أن يتعرفوا عليها انطلاقًا فحسب من تغيرات التشكيل الصوتي لهاتين الكلمتين البسيطتين".
وعدّت الباحثة الفرنسية آن أوبرسفلد، في كتابها "قراءة المسرح"، الوظيفة الانفعالية وظيفةً أساسيةً في المسرح، في حال قبولها افتراض أن الفعل المسرحي هو عملية تواصلية، وأن الوظائف الست التي أبرزها ياكبسون مناسبة ليس فقط لعلامات النص، بل أيضًا للعرض المسرحي، مشيرةً إلى أن هذه الوظيفة ترتكز على المرسِل، بحيث يحاول الممثل أن يفرضها بكل إمكاناته الجسدية والصوتية على المتلقي، في حين يعمل كل من المخرج والسينوغراف على ترتيب عناصرها في العرض المسرحي بشكل درامي.
إن دي مارينيز، من دون شك، محق جدًا في رفضه اختزال تجربة المتلقي مع العرض المسرحي إلى الوظيفة الانفعالية، التي ارتبطت بالرؤية الرومانسية، حيث يمتثل هذا المتلقي إلى مقصد منتجي العرض (المؤلف، والمخرج، والممثلين، والفنيين)، في استجابة سلبية لنواياهم، التي تختلف قطعًا عن نوايا العرض ذاته، بوصفه واقعةً فنيةً خياليةً، يضمر مقاصده الخاصة، وله استراتيجيته السيميائية المنفتحة على احتمالات تأويلية كثيرة من خلال عملية التلقي، التي تتطلب تفاعلًا عميقًا مع عناصره البصرية والسمعية الدالة المتنوعة، وفعّالية إدراكية، ليس على المستوى الحسي الشعوري فقط، بل على المستوى المعرفي أيضًا. وهذه الفعالية، إلى جانب المستوى الانفعالي، هي التي تؤدي إلى خلق الشعور بالمتعة.
***************************************
قصيدة الهايكو: الانطباع العفوي والإحساس باللحظة
د. مثنى كاظم صادق
ربما لم يدر في خلد الشاعر الياباني ( باشو ) وهو يحتضر عام ( 1694م ) ويكتب قصيدته الهايكوية الأخيرة قبل موته ( مريضٌ وقت رحيلي / أحلامي تتجول طافية في حقول ذابلة / كفراشة تحلق راقصة ) أقول ربما لم يدر في خلده أن سيتخطى اسمه وطريقة كتابته الشعرية جغرافية بلده إلى جغرافيات أخرى ؛ ليكون أباً ورائداً لجنس أدبي بدأ يأخذ صداه ومداه في الوقت الحاضر وهو شعر الهايكو. والهايكو شكل شعري يكتب من ثلاثة أسطر أو ثلاثة مقاطع مشروطة ــــــــــ الأسطر أو المقاطع ـــــــــ بالانطباع العفوي والإحساس باللحظة الحاضرة ، بتوظيف الألفاظ البسيطة المطروحة في الطريق بمعنى أن شاعر الهايكو لا يعتمد المعاني المطروحة في الطريق فحسب، بحسب مفهوم الجاحظ ،لكنه يعتمد على الألفاظ المطروحة بالطريق أيضاً وأعني بها الألفاظ البسيطة الشائعة؛ لتحقيق نوع من الرؤيوية العالية للأشياء التي حولنا ، بعين ثاقبة متأملة للماحول ، والتماهي معها والانسجام في تكويناتها ، وكينوناتها محققاً ــــــــ شاعر الهايكو ـــــــــ نوعاً من الإدهاش الجمالي النوعي المختلف عن جمال الأجناس الأدبية الأخرى بتقنية واحترافية ومهارة في توصيف الحدث أو المنظر بألفاظ مألوفة ( جداً ) خالقاً لحظة مشهدية متناقضة تبعث على التأمل العفوي بنسج المشاعر والأحاسيس المتدفقة مكوناً انطباعاً ما حول شيء ما. وتشترط قصيدة الهايكو ( الموسمية ) أي توظيف الموسم أو الوقت الذي يحدث فيه هذا الانطباع فضلاً محتويات هذه اللحظة وغالباً ما نجد في قصيدة الهايكو ذكراً للحيوانات وباقي عناصر الطبيعة التي تتبع بالنتيجة هذا الموقف أو ذاك ....
إذن هي قصيدة تجريبية تؤطر ما يحدث لا ما حدث ومن هنا ومن الناحية الأسلوبية نجد الفعل المضارع حاضراً فيها ؛ لما يحتويه من ديمومة واستمرارية على أن هذه الشروط في المجمل هي شروط كبرى ؛ للتفريق بينها وبين القصة القصيرة جداً التي ربما قد تشترك معها في لحظة الإدهاش في الجملة الأخيرة. إن كاتب السطور يختلف تماماً مع من يصف قصيدة الهايكو بـــــــــ (التوقيعة الشعرية) وذلك؛ لأن التسمية تحيلنا إلى (أدب التوقيعات ) الذي شاع في العصر العباسي ، وهو سطور مقتضبة مكثفة يكتبها الخليفة أو الوالي أو القاضي أو القائد إجابة على كتاب يرد إليه وهو تهميش بالمعنى الإداري الحالي....
إن وصول قصيدة الهايكو إلى العالم العربي عبر الترجمات الوسيطة وليس عن طريق الترجمة من اليابانية المباشرة ، لم يمنع من ظهور قصيدة هايكو عربية بدأت تتبلور وتأخذ مكانتها في النوادي الأدبية ولها كتابها وقراؤها ومن رواد كتابتها الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة والشاعر المغربي سامح درويش والشاعر العراقي عذاب الركابي ولطفي شفيق مهدي والشاعرة العراقية بلقيس خالد على سبيل المثال لا الحصر وكذلك برز مترجمون للهايكو كالشاعر والمترجم العراقي عبد الكريم كاصد. في عام 2019 م تم إشهار أول نادٍ عربي للهايكو في المغرب وهو ( هايكو موروكو ) الذي يترأسه الشاعر سامح درويش ، وهذا النادي المغربي سيستضيف عام 2021م جمعية الهايكو العالمية التي مقرها اليابان ؛ ليتجمع شعراء هايكو من أنحاء العالم ؛ لإحياء فعاليات
(هايكوية) ولعل ذلك إن تم سيكون حدثاً أدبياً مهماً إنموذج من شعر الهايكو العراقي :
بلقيس خالد :
الحجرُ حكاياته بيوت / يروي أهلها سرَّهُ الدفين / في زينة النساء.
..................
كم من الحكايا / في ذاكرةِ ضفةٍ/ تركها النهر
.............
إستكانات الشاي / لا حكايات لها / حين تروي عطش الأحبة
******************************************
مِنْ غُرفَةِ التَّحقيق
أجود مجبل
في الحَرْبِ حِينَ تَلاقَيا وتَفارَقا
كَفراشَتَيْنِ تَلاقَتا بِحَريقِ
لَمْ يَستَمِعْ أَحَدٌ إلى أَحَدٍ
وكان الوقتُ في السّاعاتِ غَيْرَ دَقيقِ
كَتَبَ المُؤَرِّخُ
في خليجِ البصرةِ العَربِيِّ
بَحّارٌ بِزِيِّ غَريقِ
قَيْلُولَةً في القاعِ يَأْخُذُ غالِبًا
ويَعُودُ مِنْ ماءٍ هُناكَ عَميقِ
إحدى الصَّبايا مَرَّةً قالتْ لَهُ
: ما ظَلَّ لِلميناءِ أَيُّ طريقِ
لكنْ سَتَنْجُو أَنتَ
كُنْ مُتَأَكِّدًا
لي قالَ هذا طائرُ الفِينيقِ
فامْلَأْ سِنينَ العُمْرِ رَقْصًا نادِرًا
واجْرَحْ سُكُونَ الليلِ بالتَّصفيقِ
الليلُ يَزْخَرُ بالذينَ تَشَجَّنُوا
وبِكُلِّ دَرْبٍ فيهِ قَبْرُ صَديقِ
***
قَتْلى لَنا
ما أَبْصَرُوا جَلّادَهُمْ
مَنْ بَعْدِما مُنِعُوا عَنِ التَّحديقِ
صارُوا خَريفًا عائلِيًّا
فيهِ أَشجارٌ تَمُوتُ بِغُرفَةِ التَّحقيقِ
قَتْلى جَميلونَ استعانوا بالغِناءِ
لِفَهْمِ ما يَجْري مِنَ التَّلْفيقِ
نامُوا على قاعِ الزَّوالِ
لِيُدْرِكُوا معنى غِيابِ رفيقةٍ ورفيقِ
كانُوا الضَّحايا
في بِلادٍ دُونَ ذاكِرَةٍ
وما اعتادَتْ على التَّوثيقِ
يُنْسَوْنَ فيها مِثْلَ أَيِّ نَبِيَّةٍ
وَقَفَتْ بِوَجْهِ القَمْعِ والتَّفسيقِ
سَرَقَ الرُّواةُ الكاذِبُونَ بَريدَها
وقَضَوْا على الآياتِ بِالتَّمزيقِ
خَطفُوا حَقيبَتَها الصَّغيرَةَ
وهي في يَدِها مُعَلَّقَةٌ بَخَيطِ شَهيقِ
أَخْفَتْ بِها أَدَواتِ زِينَتِها
هَواءً جاءَ مِنْ بغدادَ
وَعْدَ بَريقِ
فيها تُخَبِّئُ كُحْلَها العَربيَّ
مَخْلُوطًا بِفَجْرٍ
هادِرٍ وحَقيقي
صَيْفًا خَفيفَ الظِّلِّ مِنْ صنعاءَ
إذْ أَهْدَتْ لَها بلقيسُ قُرْطَ عَقيقِ
وحَبيبُها غَنّى لَها
: يا أَجْمَلَ المَلِكاتِ
إنِّي لَسْتُ أَيَّ عَشيقِ
أَنا مُغْرَمٌ بِكِ يا فَتاتي
مُنْذُ أَنْ وَعَتِ الطُّيُورُ قَداسَةَ التَّحليقِ
آمَنْتُ بِالأُنثى النَّبِيَّةِ
وهي تُنقِذُ شَعْبَها
مِنْ واعِظٍ وصَفيقِ
صَدَّقْتُها في كُلِّ ما جاءتْ بِهِ
حتى دَعاني النّاسُ بالصِّدِّيقِ
فَقُتِلْتُ مُتَّهَمًا بِها
لكنَّهُمْ قالُوا
مُجَرَّدُ مارِقٍ زِنْديقِ
**************************************
الصفحة السادسة عشر
في الهندية احتفال بعيد الصحافة الشيوعية العراقية
الهندية – مرتجى فاضل
أقام المكتب الإعلامي التابع إلى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، أخيرا، احتفالا في مناسبة الذكرى الـ90 لانطلاق الصحافة الشيوعية العراقية، وذلك على حديقة دار سكرتير منظمة الحزب في الهندية الرفيق هادي عودة الكفري.
الاحتفال الذي حضره جمع من الرفاق، تضمن ندوة أدارها سكرتير محلية كربلاء الرفيق مرتجى فاضل، وتحدث فيها مسؤول المكتب الإعلامي في المحلية الرفيق غانم الجاسور.
واستهل الرفيق فاضل، الندوة بمقولة لفلاديمير لينين، تفيد بأن "الصحيفة ليست فقط داعية جماعية أو محرضا جمعيا، بل هي في الوقت نفسه منظم اجتماعي".
وقال أن الصحافة الشيوعية منذ بداية انطلاقها عام 1935 حتى يومنا هذا، مثلت صوت العمال والفلاحين والفقراء والمهمشين والمحرومين، وكافة فئات الشعب دون استثناء، وانها لا تزال تعبر عن أهم القضايا السياسية والاجتماعية والأدبية والفكرية والمطلبية.
بعد ذلك، ابتدأ الجاسور حديثه مبينا أن الصحافة تعد من أدوات الاتصال المهمة في كل العصور، وانها يُفترض أن تكوّن أبعادا فكرية تهدف إلى إصلاح المجتمع وتبني مطالبه الملحة، وأن تعمل على نقل الحقيقة الناصعة.
ثم استذكر الصحفيين الشيوعيين الذين جمعوا بين عملهم النضالي الصحفي والسياسي، بين الثقافة والموقف، بين الحلم والجرأة في تحقيقه.
وأشار الجاسور إلى أن الرفيق فهد نشر الكثير من التقارير والمقالات المعنية بالقضايا المصيرية، في الصحافة العلنية والسرية، وتحت تواقيع عديدة، منها "يسن" و"فتى المنتفك"، وانه كان ينشر مقالات في جريدة "الرأي العام" لصحابها الشاعر الجواهري الكبير.
ثم عرّج على تأسيس الصحافة الشيوعية بانطلاق جريدة "كفاح الشعب" عام 1935، مبينا أن الجريدة كانت تُطبع بجهاز النسخ "الرونيو"، وانها حققت انتشارا واسعا في فضاء الصحافة العراقية "حيث يبلغ عدد النسخ التي توزعها من كل عدد 500 نسخة، ما ساهم في نشر الوعي الطبقي والخطابي المعادي للاستعمار".
وتابع قوله أن "كفاح الشعب" كانت نبراسا تنويريا، وانها انتجت كوكبة من الصحفيين الذين تدربوا فيها واستلهموا منها الروح النضالية من اجل قضايا الشعب وهمومه اليومية، والذين استشهد الكثيرون منهم على مذبح الحرية.
ثم تحدث الجاسور عن جريدة "الشرارة" التي أصدرها الحزب عام 1940، ولم تستمر طويلا. كما تحدث عن جريدة "الأساس" 1948، ثم عن جريدة "اتحاد الشعب" عام 1956، والتي كانت اكثر الصحف انتشارا بين المواطنين "حيث وصل عدد نسخها اليومية آنذاك، إلى 50 ألف نسخة".
بعدها تحدث عن "طريق الشعب"، وكيف انها صدرت بداية عام 1961، ثم توقفت عام 1971 وعاودت الصدور عام 1973، لتتوقف عام 1979 إثر الهجمة البعثية الشرسة على الشيوعيين والديمقراطيين، موضحا أن "طريق الشعب" صارت تصدر خارج العراق وفي إقليم كردستان، ثم بدأت تصدر علنا في البلاد بعد 2003.
واستذكر الجاسور أهم الكتاب والصحفيين في الصحافة الشيوعية العراقية، أمثال صفاء الحافظ وعبد الجبار وهبي ورشدي العامل وحسين قاسم عزيز وثائرة بطرس وفالح عبد الجبار ورضا الظاهر، وغيرهم. كما استذكر الكاتب والصحفي شمران الياسري (أبو كاطع)، وعموده الثابت في الصحيفة وبرنامجه الإذاعي الساخر "احجيها بصراحة يا بو كاطع".
وفي سياق الندوة، قدم عدد من الحاضرين مداخلات، بضمنهم سلام نوري والكفري وباقر عجة.
جدير بالذكر، أن المكتب الإعلامي أجرى في مناسبة عيد الصحافة، لقاء مع الناقد جاسم عاصي، عضو المكتب الإعلامي للحزب إبان سبعينيات القرن الماضي. حيث تحدث عن رفاق كتبوا للصحافة الشيوعية، وعن معوقات كانت تواجه الصحفيين الشيوعيين في تلك الفترة.
*************************************
زيادُ باقٍ ينبض فينا *
مفيد الجزائري
زيادُ .. مات؟
أبداً ، إنما هو الجسد الموجوع المُستنزَف استجار بالسكينة
…..
منذ الحضن الفيروزي ، وزياد يُعشّق نبضَه بنبضنا ، نحن ابناءَ جلدته البشرْ
ْتولّهَ بالحقيقة ، وانكبّ يُقارب بؤسَنا الهائل ، وذلَّنا اللانهائي ، وأحلامَنا الملونة
امتزجت أنفاسُه بأنفاسنا
صار منا وصرنا منه
همومُنا همومُه وتطلعاتُنا تطلعاتُه
وهبَنا ما لا يهِبُ الا أهلُ السخاء والابداع
القلبَ والفكرَ والصدق ، الموهبةَ والاعصابَ والعافية
غنّى لنا ، وذادَ عنا ، وثار على جلادينا ، وشرشح مصاصي دمانا ، ومسح بالوحل وجوهَ المرائين والنصّابين المتربصين دوماً بنا
لمستقبلنا – نحن البشرَ الملايين - انحاز ، ولقضيتنا انتصر.
ولولا انشغاله ، بتمامه ، بنا وبكرامة الانسان فينا وبقضية خلاصنا ، لما استباحت العللُ اللئيمة بدنَه الواهن ، وحرمتنا باكرا من حضوره المتوهج
…..
زياد باقٍ
ينبض فينا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نص قدمته يوم أمس اذاعة {صوت الشعب} التابعة للحزب الشيوعي اللبناني، ضمن بث مباشر مع وعن زياد الرحباني، تواصل النهار بطوله واختتم في السابعة مساءً بوقفة تحية لزياد امام مبنى الإذاعة
***************************************
الأنبار حملة تشجير تُخلّد أثر الجنود
متابعة – طريق الشعب
أعلن رئيس "مركز الفرات" البيئي، صميم الفهد، إطلاق حملة وطنية في الأنبار تحت عنوان "أثر الجندي"، تهدف إلى غرس الأشجار في المواقع التي سبق أن تمركزت فيها وحدات الجيش "تخليدًا لأثر الجنود الذين خدموا في هذه المناطق وتركوا خلفهم بصمات طيبة".
وقال في حديث صحفي، ان "الحملة تنطلق من منطقة شرق الأنبار. حيث كانت هناك مرابطة للجيش تركت خلفها شجرة غرسها الجنود قبل انتقالهم إلى موقع آخر"، مشيراً إلى أن "تلك الشجرة أصبحت رمزًا للأثر الطيب الذي يمكن أن يتركه الجندي، ليس فقط دفاعاً عن الأرض، بل أيضاً في إحيائها وزراعتها".
وأضاف قائلا أنه "من هنا جاءت فكرة الحملة التي ستبدأ فعلياً بداية موسم الزراعة في شهر أيلول، وسنقوم بغرس عدد من الأشجار إلى جانب تلك الشجرة، بدعم ومشاركة متطوعين وسكان المنطقة".
ودعا الفهد وزارة الدفاع إلى التعاون والمشاركة في الحملة. وقال: "نأمل أن تكون وزارة الدفاع شريكًا داعمًا لنا في هذه المبادرة. فالجنود الذين دافعوا عن الأرض يستحقون أن نخلّد أثرهم بعمل بيئي وإنساني مستدام"، موضحا أن "الحملة تمثل رسالة رمزية ووطنية، مفادها أن اليد التي تحمي قادرة أيضًا على أن تزرع".
وتابع قائلا أن "الأجيال القادمة تستحق أن ترى الأثر الجميل لمن سبقها، وعلينا جميعًا مسؤولية في الحفاظ على هذا الإرث"، داعيا المؤسسات والمواطنين في الأنبار إلى المشاركة في الحملة
***************************************
في مقر شيوعيي البصرة احتفاء بالكاتبة والتشكيلية باسمة الحسن
البصرة – طريق الشعب
احتضنت "قاعة الشهيد هندال" في مقر اللجنة المحليّة للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، أخيرا، جلسة احتفاء بالكاتبة والتشكيلية باسمة الحسن، في مناسبة صدور كتابها الجديد الموسوم "وما يليها"، الذي يضم قصصا قصيرة جدا.
الجلسة التي حضرها جمع من المثقفين والأدباء والفنانين، نظمها "ملتقى جيكور" الثقافي، وادارها رئيس الملتقى الشاعر والإعلامي عبد السادة البصري. حيث تحدث عن القصّة القصيرة جداً وكيفية كتابتها والشروط الواجب توفّرها لإنجاحها. ثم عرّج على سيرة المحتفى بها تشكيلياً وأدبياً، مبينا أن "ملتقى جيكور" ضيّف باسمة أكثر من مرة.
بعد ذلك، تحدثت المحتفى بها عن تجربتها الجديدة في اصدار كتاب قصصي، بعد مجموعتين شعريتين.
ثم قرأت قصيدة عن خور عبد الله، فضلا عن مختارات من قصص كتابها الجديد.
وفي سياق الجلسة، قُدمت أوراق نقدية وقراءات انطباعية عن كتاب المحتفى بها، وذلك من قبل خالد خضير، أزهار عيسى محسن، كاظم الجوراني، سهاد البندر وعبد الله الخزاعي. كما قرأ عطوف الحسيني وصلاح عمران ومدير الجلسة، أوراقا بالنيابة عن ناظم المناصير وعلاء العيسى ود. مظاهر العيداني.
وفي الختام، قدمت "دار الأدب البصري" و"مؤسسة النهضة" الثقافية و"مؤسسة ثغر الفيحاء"، هدايا إلى المحتفى بها. فيما قدّم لها "ملتقى جيكور" شهادة تقدير.
******************************************
قف.. كيف سقطت الانظمة؟
عبد المنعم الأعسم
في التاريخ، ثمة حكومات وانظمة وامبراطوريات كثيرة تهاوت باشكال مختلفة، لكن، لأسباب مقاربة: العُزلة عن الأمة، وتحوّل الولاءات لها الى نقمة عليها، فيما يجد الجيران والطامعون، الجامحون، فرصة للتدخل والاحتلال، وشراء الزعامات والقبائل والجماعات الفاسدة، والذمم، ثم تحلّ الزلازل والمذابح، وتجلس فلولهم وأميراتهم وجواريهم على الاطلال تستذكر وتندب.. وكأنني أتحدث عن سقوط الدولة الاموية.. حيث سؤل بعض شيوخ بني أمية عقب زوال دولتهم: ما كان سبب زوال مُلككم؟ فاجاب، في مُختصرات اوردها المسعودي في "مروج الذهب" وذكرها هادي العلوي في مستطرفه (ص77): لأنا شُغِلنا بلذاتنا عن تفقُد ما كان تفَقّدهُ يُلزمنا، فظلمنا رعيتنا، فيسئيوا من إنصافنا، وتمنّوا الراحة منا، وخُرّبت ضياعنا، فخلت بيوت أموالنا" وتحدث عن كبار رجال الدولة بقوله، لقد "وثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم (مصالحهم) على منافعنا، وأمضوا أموراً (صفقات) دوننا، وأخفوا علمها عنّا، وتأخر عطاء (رواتب) جُندنا فزالت طاعتهم لنا، واستدعاهم أعادينا (من الخارج) فتظاهروا معهم على حربنا.. وكان استتار الاخبار عنا (إخفاء ما يُدبر) من أوكد اسباب زوال مُلكنا".
*قالوا:
“ما خاب مَن استخار، ولا ندِم من استشار، ولا عالَ مَن اقتصدْ".
رواه الطبراني
****************************************
عدد جديد من {النصير الشيوعي}
عن رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين، صدر أخيرا العدد (37) آب 2025 من جريدة "النصير الشيوعي".
ضم العدد أخبارا وتقارير عن نشاطات الرابطة في العراق والخارج، وكتابات عن مسيرة الحركة الانصارية وشهدائها، غطت جميعها 12 صفحة ملوّنة.
************************************
بعشيقة تقرأ الكتب
بعشيقة - يوسف رعد
أقام فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في نينوى، مساء أول أمس الجمعة، مهرجانا بعنوان "بعشيقة تقرأ"، وذلك على أرض "بارك بعشيقة"، وبمشاركة واسعة من شخصيات اجتماعية ودينية وناشطين وجمع من هواة المطالعة.
المهرجان الذي تضمن فقرات فنية وثقافية متنوعة، استهل بكلمة ألقاها سكرتير فرع الاتحاد عبد الله عمر، وركّز فيها على خطورة الخطاب الطائفي، مؤكدًا دور الثقافة والوعي في مواجهة الفكر الرجعي والانقسامي.
وإلى جوار طاولات تحمل كتبا باختصاصات متنوعة، وزعت مجانا على الزائرين، شهد المهرجان قراءات شعرية لعدد من الشعراء الشباب، ومعرض صور يوثق الإبادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون على يد إرهاب داعش، فضلا عن معرض رسم حر.
ولاقى المهرجان تفاعلا واسعا من الجمهور. حيث اُعتبر خطوة مهمة لترسيخ قيم المواطنة والانفتاح الثقافي ومواجهة الخطابات الطائفية والمناطقية.