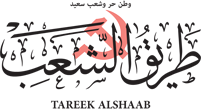الصفحة الأولى
خسائر يومية تتجاوز 5 ملايين دولار بسبب توقف الملاحة الجوية العراق في قلب العاصفة الأزمة الإقليمية تهدد أمننا الاقتصادي والغذائي
بغداد - محمد التميمي
بينما تتصاعد وتيرة المواجهة الإقليمية بين إيران وإسرائيل المعتدية، يجد العراق نفسه محاصراً بتداعيات اقتصادية متزايدة تهدد أمنه الغذائي واستقراره المالي؛ فقد أدى إغلاق المجال الجوي وتعطل المنافذ الحيوية إلى خسائر يومية، تقدّر بعشرات ملايين الدولارات، اضافة لتوقف التبادل التجاري مع ايران.
وسط كل هذا يحذر خبراء الاقتصاد من أن خطط الطوارئ التي تراهن عليها، لن تصمد في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة. وفي وقت يتقلص فيه المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وتتزايد كلفة النقل والاستيراد، سيبقى العراق عرضةً لتداعيات أعمق في حال تطور الصراع واتساع رقعته الجغرافية.
عقم في التخطيط
في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي أن التصعيد الإقليمي المتواصل بين إيران وإسرائيل يضع العراق في دائرة الخطر المباشر، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل من زاويته الاقتصادية حيث باتت أكثر هشاشة في ظل استمرار الحرب، وتعطل حركة الطيران، وتأثر خطوط التجارة والنقل.
وقال الهماشي في حديث لـ "طريق الشعب"، ان "الأزمات الكبرى – سواء كانت حروباً أو كوارث طبيعية – تُصنّف ضمن المخاطر التي يتعامل معها الاقتصاد العالمي عادة من خلال أدوات التأمين وإدارة الطوارئ"، مضيفاً أن "الشركات التجارية الكبرى غالباً ما تكون مؤمّنة ضد هذه المخاطر، لكن الشركات غير المؤمنة ستتحمل الخسائر الكاملة، وهو ما يكشف ثغرات في التخطيط الاقتصادي لدى بعض الفاعلين في السوق العراقي".
وأضاف أن شركات التأمين قد تتراجع عن تغطية بعض الأضرار في ظروف الطوارئ القصوى، مشدداً على أن الأزمة الحالية "لا تقتصر تداعياتها على العراق، بل تمتد إلى دول عدة في المنطقة، إذ تغيّرت مسارات شركات الطيران، وتوقفت مطارات في كل من بغداد ودمشق وطهران وعمّان عن استقبال بعض الرحلات، في حين قلّصت شركات دولية رحلاتها إلى دول الخليج باستثناء الحالات الضرورية".
وفي ما يتعلق بالعراق، رأى الهماشي أن "الوضع الاقتصادي حساس بطبيعته، ويتأثر بأي أزمة، غير أن الصراع المفتوح بين ايران والكيان الصهيوني يحمل تهديداً مضاعفاً، بسبب موقع العراق الجغرافي الحساس يستخدمه الطرفان كممر جوي مباشر، ما يجعل أراضيه ساحةً متداخلة في معركة لا يملك أدوات إدارتها".
تراجع القوة الشرائية للمواطنين
وأضاف ان "القلق يخيّم على الأسواق، والقوة الشرائية تراجعت، والتجار ينتظرون نتائج الحرب بخوف، وسط توقف استيراد كثير من البضائع، وتأخر وصول شحنات أساسية، منها السلع الغذائية والمواد الطبية، في وقت بدأت فيه تكاليف النقل والخدمات بالتضخم".
وتابع الهماشي حديثه بالقول: انه برغم كل هذا "تراهن الحكومة على خطط طوارئ مؤقتة لحماية الأمن الغذائي. إلا أن هذه الخطط تعتمد بالدرجة الأولى على الخزين الاستراتيجي الموجود حالياً، والذي يكفي – بحسب تقديري – لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر فقط. وإذا ما نفد هذا المخزون، فسيصعب جداً إدخال بضائع جديدة في ظل المخاطر الراهنة".
ونوّه الهماشي إلى أن "المنافذ الشرقية، خصوصاً مع إيران، أصبحت مهددة، فيما يظل المنفذ البحري عبر البصرة معرضاً للمخاطر بسبب قربه من مناطق التوتر، وفي حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، فإن صادرات النفط العراقية ستتوقف عملياً، باستثناء خط جيهان التركي، الذي لا يملك القدرة على تصدير كميات كبيرة، ما يُفاقم الأزمة".
واستبعد ان تتمكن خطط الحكومة، خصوصاً وزارة التجارة، من الصمود في حال طال أمد الحرب، لأن العراق يفتقر إلى منظومة استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات الكبرى والمخاطر الطارئة، وهي فجوة لا بد من معالجتها سريعاً قبل تفاقم الأضرار".
خسائر كبيرة
أما الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي فقد حذر من التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن توقف حركة الملاحة الجوية في العراق، مؤكداً أن استمرار هذا التوقف يُكبّد البلاد خسائر مباشرة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات شهرياً، بما يعادل نحو 5 ملايين دولار يومياً.
وقال الشيخلي لـ"طريق الشعب"، إن "الإيرادات المتأتية من مرور الطائرات عبر الأجواء العراقية تُعد مورداً مهماً يعزز الإيرادات غير النفطية للدولة"، مشيراً إلى أن "تعليق هذه العمليات ألحق ضرراً مباشراً بالعوائد السيادية، لا سيما وأن تلك الأجور تُستوفى بموجب اتفاقيات دولية مع شركات الطيران".
وأضاف أن "الخسائر لا تقتصر على رسوم عبور الأجواء فحسب، بل تمتد إلى تراجع إيرادات بيع التذاكر، وتوقف عمليات الشحن الجوي، وتأثر نشاطات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن التزامات العراق المالية تجاه شركات الطيران التي أبرمت عقوداً تجارية قائمة على تشغيل الأجواء والمطارات العراقية".
وأشار الشيخلي إلى أن "الحكومة حاولت احتواء جزء من الأزمة عبر تشغيل مطار البصرة لساعات محددة، وهو إجراء جزئي لا يعوض الخسائر الفعلية"، معربا عن أمله في استئناف العمل في مطارات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وانتقد الشيخلي أداء وزارة النقل في ما يتعلق بإدارة ملف الأجواء العراقية، مبينا أن "الوزارة لم تكن تستوفي أجور مرور الطائرات منذ نحو عقدين، ما يعني أن تصريحاتها بعدم اعتبار تلك الأموال ضمن بند الخسائر تفتقر إلى الدقة".
وتابع ان "هذه الإيرادات كانت تُهدر، وكان من الممكن أن تُسهم في تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للتمويل".
وحول الوضع الأمني وتأثيره على حركة الطيران، نبه الشيخلي الى أن "الظروف الحالية جعلت الأجواء العراقية من بين أخطر المسارات الجوية في المنطقة"، لافتاً إلى أن "المخاطر الأمنية تبرر جزءاً من الخسائر، خاصة في ظل تهديدات غير متوقعة من طرف مثل إسرائيل، الذي لا يلتزم بأي قواعد أو مواثيق دولية، وقد يرتكب أي عمل عدائي دون اعتبار للقانون الدولي".
مرحلة حرجة اقتصاديا
وضمن السياق، أكد المراقب للشأن الاقتصادي حسنين تحسين أن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة تُنذر بتداعيات خطرة على الاقتصاد الوطني، خاصة إذا استمر إغلاق المجال الجوي وتعطلت حركة المنافذ الحدودية.
وقال تحسين في حديث لـ"طريق الشعب"، إن "الاقتصاد العراقي يواجه مخاطر حقيقية في ظل التصعيد الأمني المستمر، وعدم وجود بوادر لوقف إطلاق النار أو تهدئة طويلة الأمد"، مضيفًا أن "استمرار هذا الوضع يعني دخول العراق في مرحلة حرجة اقتصاديًا، خصوصًا مع اعتماده الكبير على الواردات من إيران في السنوات الماضية”.
وأضاف أن “إغلاق المجال الجوي يعطّل نقل المواد الحيوية، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تصل عادة عبر الطيران، ما يؤدي إلى نقص محتمل في هذه المواد وارتفاع أسعارها”، محذرًا من أن “المدة التي سيستمر فيها هذا الإغلاق غير واضحة، ما يضيف حالة من الضبابية والقلق في الأسواق”.
وتحدث تحسين أيضًا عن سيناريوهات أكثر تعقيدًا قد تؤثر بشكل مباشر على الصادرات النفطية، قائلًا: “في حال تطور الصراع وشاركت الولايات المتحدة عسكريًا، قد تقدم إيران على خطوات تصعيدية مثل إغلاق مضيق هرمز أو زرعه بالألغام البحرية، وهو ما سيؤدي إلى شلل تام في صادرات النفط العراقية التي تمر عبر هذا المضيق الحيوي”.
***************************************
راصد الطريق.. خو ما نايمين؟!
مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرّض الجزء السفلي من مفاعل "نطنز" لأضرار مباشرة جرّاء الغارات الإسرائيلية، سارعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في العراق إلى تأكيد امتلاكها منظومات حديثة لرصد وتشخيص الارتفاعات في الخلفية الإشعاعية. لكنها لم تُشر مجرد إشارة، إلى الإجراءات الواجبة عند وقوع طارئ نووي أو إشعاعي، واكتفت بعبارات مبهمة عن "تفعيل الخطط الوطنية والإقليمية".
وفيما يحذّر مختصون بيئيون من احتمال تسرّب الإشعاع إلى مناطق البصرة وميسان وذي قار، اذا استهدف العدوان منشآت إيران النووية، يطالبون ايضا بتكثيف الرصد وقراءة النشاطات الإشعاعية في الجو، وتوفير أجهزة متطورة تواكب خطورة الموقف، خصوصاً وأن زمن بلوغ الإشعاع مدننا العراقية لا يتجاوز 9 ساعات. وهذا يتطلب استنفاراً مبكّراً وإجراءات وقائية صارمة.
مخاطر الإشعاع في العراق لم يجرِ الاستعداد لمواجهتها والتصدي لها، سواء بالارتباط مع تداعيات الصراع المتواصل او لأي سبب آخر.
نقول ذلك لان المتنفذين اعتادوا العمل بعقلية "أشطب يومك"، ولا تعنيهم حياة الناس ما دامت مصالحهم مؤمنة وحساباتهم المصرفية شغالة على قدم وساق.
وأمثال هؤلاء هم من يتسببون في إلحاق الضرر بشعبهم ووطنهم، رغم كل ادعاءاتهم المعاكسة.
***************************************
الصفحة الثانية
الموارد المائية: انخفاض إيرادات المياه من دول المنبع إلى أقل من 40 في المائة
متابعة ـ طريق الشعب
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن أكثر من 70 في المائة من الإيرادات المائية في العراق تأتي من خارج البلاد، وتحديداً من تركيا وإيران وسوريا، مشيراً إلى أن انخفاض هذه الإيرادات إلى أقل من 40 في المائة يؤثر بشكل واضح على كافة المحافظات والوضع المائي فيها.
وأوضح شمال، أن الإيراد المائي المتحقق إلى سد الموصل أمس بلغ فقط 64 متراً مكعباً في الثانية، وهو ما يفاقم الأزمة، لافتاً إلى أن الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الأزمة، تضمنت حملة وطنية من خلال تشكيل خلية أزمة في كل محافظة، يرأسها أحد مسؤولي الوزارة بالتعاون مع الحكومات المحلية في الأقضية والنواحي، إلى جانب إشراك وزارة المالية في كل محافظة معنية.
وبيّن أن الأزمة مرتبطة بأمرين مهمين؛ الأول هو تناقص الإيرادات المائية السطحية، والآخر هو قلة الأمطار خلال الشتاء الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن العراق يُعد الآن من بين أكثر خمس دول في العالم تأثراً بظاهرة الجفاف العالمي.
****************************************
تظاهرة غاضبة تستقبل السوداني جنوبي بابل فلاحو المثنى يطالبون بمستحقات الحنطة ومزارعو ديالى ينتظرون تسويق المحصول
بغداد ـ طريق الشعب
بينما تتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الناتجة عن فشل المنظومة الحاكمة في تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، تتعزز حالة الرفض الشعبي لهذه المنظومة، وتفرز أشكالا مختلفة من الحراك الاحتجاجي في جميع مناطق البلاد ومختلف القطاعات، بعد أن أخذ الوعي السياسي لدى شرائح المجتمع يدفع بعجلة التغيير الجذري الى أمام، باتجاه دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. ومنذ تولي الحكومة الحالية مسؤولية إدارة البلد، يتنامى لدى المواطنين الشعور بالظلم، نتيجة لتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وضعف البنية التحتية، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص.
تظاهرة غاضبة تستقبل السوداني في بابل
وشهدت ناحية المدحتية، جنوبي محافظة بابل، أمس الأربعاء، توتراً أمنياً بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لافتتاح مشروع جديد تابع لاحدى الشركات الأهلية في المنطقة، حيث منعت قوات مكافحة الشغب عشرات المتظاهرين الغاضبين من الاقتراب من معمل السكر العائد لشركة الاتحاد.
وجاءت التظاهرات احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي في الناحية، إذ عبّر المتظاهرون عن استيائهم من غياب مشاريع البُنى التحتية الأساسية واستمرار معاناتهم من نقص الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية.
وأشار المحتجون، إلى أن المناطق المهمّشة بحاجة إلى التفاتة حكومية حقيقية، مطالبين بترجمة الوعود الرسمية إلى خطوات ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية، بدلاً من التركيز على مشاريع لا تمس احتياجاتهم الفعلية.
تظاهرة فلاحية في المثنى
تظاهر مزارعون في محافظة المثنى، امس الأول الثلاثاء، أمام سايلو السماوة، احتجاجا على عدم صرف جزء فقط من مستحقاتهم المالية الخاصة بتسويق المحاصيل بالكامل.
وقال عدد من المحتجين، إن مطالبهم تشمل الإسراع بصرف المستحقات المتأخرة، مؤكدين أن تأخير صرف الأموال من قبل وزارتي المالية والتجارة يؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية، وتحضيراتهم للموسم الزراعي المقبل.
ديالى.. مجلس عزاء على الحنطة
ونظم مجموعة من فلاحي قرى قولاي في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، وقفة احتجاجية مطالبين بشمول أراضيهم في خطة تسويق الحنطة للأراضي خارج الخطة الزراعية.
وقال المزارعون، ان الحنطة مكدسة لديهم وعليهم ديون تصل عشرات الملايين. فيما أكد قائمقام القضاء، وجود 40 ألف طن من الحنطة خارج الخطة في خانقين وضواحيها، مبيناً أن المحافظة رفعت كتاباً لوزارة الزراعة والأمر متروك لرئيس الوزراء.
وقال إياد عامر، أحد المزارعين المتظاهرين: "نحن مجموعة من الفلاحين المتظاهرين نطالب بتسويق محصول الحنطة وشمولنا بالخطة التسويقية أسوة بالمحافظات الأخرى".
وأضاف ان محافظة ديالى هي "أقل المحافظات العراقية شمولاً بالخطة التسويقية، فقد تم شمول المحافظات الأخرى التي خارج الخطة الزراعية إلا محافظتنا لم تشمل بالخطة الخارجية"، مشيرا الى "لدينا حوالي 34 ألف طن الآن لم يوافق عليها مدير التسويق، أما الأراضي خارج الخطة فهي غير مجددة وهذا ليس ذنب الفلاح لأن الأراضي تعود إلى الأجداد، أما الأغلب فهي عقود مادة 140 لم تجدد، والخطة هذه السنة لم تشمل مادة 140".
وناشد أبو قيس العسكري، وهو احد المحتجين، "رئيس الوزراء ووزيري التجارة والزراعة وكل المسؤولين في ديالى أن تحل هذه المشكلة".
فيما قال جواد فيض الله قائمقام خانقين، ان "فلاحي قرى قولاي يطالبون بشمولهم بتسويق الحنطة خارج الخطة الزراعية، فكل عام تضع وزارتا الزراعة والتجارة خطة لشراء الحنطة من الفلاحين الذي لديهم عقود رسمية؛ ففي خانقين يوجد 40 ألف طن من الحنطة خارج الخطة، وقد تم رفع كتاب إلى محافظ ديالى، ثم من محافظ ديالى إلى وزارة الزراعة والأمر الآن بيد رئيس الوزراء".
***********************************
الأزمة الإقليمية تهدد أمن العراق الاقتصادي والغذائي
وأوضح أن “رغم أن أسعار النفط سترتفع حينها، إلا أن العراق لن يتمكن من الاستفادة من هذه الزيادة، لأنه ببساطة لن يكون قادراً على تصدير نفطه، وبالتالي تتحول الأزمة إلى ضربة مزدوجة تضرب قطاع الاستخراج النفطي وتفقد البلاد موردها الأساسي”.
وانتقد تحسين افتقار الحكومة لخطط فاعلة لتنويع الشراكات التجارية، قائلاً: “كان من الممكن التخفيف من آثار الأزمة الحالية لو أن العراق عمل في السنوات الماضية على تنويع وارداته من دول أخرى، وتطوير المنافذ الحدودية الجنوبية، خصوصًا مع المملكة العربية السعودية”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “منفذ عرعر لا يزال الوحيد الفعّال رغم الامتداد الحدودي الواسع بين البلدين، بينما بقي مشروع فتح منفذ الجميمة متعطلاً لسنوات، وهو ما يعكس سوء التخطيط ويؤثر سلباً على سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية التي يعتمد عليها السوق العراقي بشكل كبير”.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، ان استمرار اعتماد البلاد على الاقتصاد الريعي "انتج مجتمعاً استهلاكياً واضعف قاعدة الإنتاج الوطني".
واضاف الحسني، ان الحكومة العراقية لم تتحرك "لتطوير قطاعات الإنتاج الصناعة والزراعة المتنوعة من أجل تنشيط قطاع التجارة الخارجية للدولة، ولتحقيق أعلى قدر من الإيرادات المالية التي تساهم في تحقيق أعلى عائد للدخل الوطني وخزينة الدولة العراقية".
وكانت وزارة المالية كشف في وقت سابق بأن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني وحتى آذار عام 2025 تجاوز 27 ترليون دينار، مع مساهمة النفط بنسبة 91% من مجموع الإيرادات.
وأظهرت جداول صادرة عن وزارة المالية في حزيران الحالي لحسابات الربع الأول من العام، طالعتها "طريق الشعب"، ان النفط ما يزال يشكل المورد الرئيس للموازنة العامة، مما يكرّس الطابع الريعي للاقتصاد العراقي".
ويبقي اعتماد الدولة المستمر على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، يعرض العراق للأزمات العالمية التي تؤثر على أسعار النفط، ما يدفع البلاد إلى اللجوء المتكرر إلى الاستدانة لتغطية العجز، وهذا ما يعكس ضعفاً في إدارة الدولة وصناعة القرار، وعجز المنظومة الحاكمة عن تطوير بدائل تمويلية فعالة.
*****************************************
كل خميس.. خريطة الإذعان العربي في زمن العدوان
جاسم الحلفي
في لحظة مفصلية من صراع الإرادات في المنطقة، وضعت حكومة اليمين الصهيوني الأنظمة العربية أمام طريقٍ واحد لا طريق غيره، هو: الإذعان الكامل عبر التطبيع والانخراط في مشروع الاحتلال بشروطه التوسعية والاستيطانية، والاعتراف بإسرائيل الكبرى كأمرٍ واقع لا يقبل النقاش. ومن يرفض الانصياع جزاؤه العقاب، بالضغوط الاقتصادية، والحملات الإعلامية، والابتزاز السياسي، وربما حتى الفوضى المدبّرة أو الزعزعة الأمنية الموجهة من خارج الحدود. فلم يعد ثمّة متّسع للمواقف الرمادية بعد ان حُسمت المسألة: إما أن تقبل بالتبعية للمشروع الأمريكي–الإسرائيلي، أو تُوضع على لائحة الاستهداف.
ولم يكن خضوع هذه الأنظمة سوى حصيلة طبيعية لبنيتها الداخلية، فهي أنظمة لم تُبنَ على شرعية شعبية، بل على القمع والولاء. لا على مؤسسات دستورية، بل على سلطات أمنية. ومهمتها ليست خدمة الناس، بل ضبطهم. وبوصلتها ليست فلسطين، بل واشنطن. وسقفها ليس العدالة، بل رضا واشنطن، الذي يُدفع ثمنه من خزائن النفط، ويُقبض مقابله صمتٌ مُذلّ. أنظمة ترى في المقاومة خطراً على عروشها، وفي صوت الشعوب تهديداً لـ"هيبة الدولة". وهي تجيد إصدار بيانات الشجب، لكنها تعجز عن قول "كفى". هكذا تحوّل "التضامن" إلى طقس موسمي بلا روح، وتحولت القدس وغزة والضفة إلى مفردات تُنطق علناً وتُدهس سرّاً.
حتى جاء العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، الذي نُفّذ عبر أجواء الدول العربية، ليعرّي كل شيء. فهو عدوان سافر، نُفّذ بوقاحة في وضح النهار، من فوق أراضٍ لم تعترض، ولم ترفع حتى صوت رفض خجولاً. وفي الاثناء لم تكن السيادة منتهَكة فقط، بل كانت مغيّبة تماماً، كأن هذه الدول تخلّت عن كونها دولاً.
وحين جاء الردّ الإيراني، بدا المشهد كاريكاتورياً. فالأنظمة العربية ارتبكت، خافت، صمتت، ثم حاولت تدارك الأمر ببعض التصريحات المائعة. أما إسرائيل، فقد اهتزّت صورتها العسكرية التي طالما قدّمتها كقوة لا تُقهر. الردّ أربكها، أحرجها، وفضح غطرستها. رغم تفوّقها التكنولوجي، خصوصاً في سلاح الجو، مقابل هشاشة الدفاعات الإيرانية وضعف قواتها الجوية. ولولا التدخّل الأمريكي المباشر، دعماً وتنسيقاً ومشاركةً، ومعه الموقف الغربي الموارب، لكان شكل المعادلة قد تغيّر سريعاً وبشكل لافت.
ولم يكن التدخل الأمريكي غطاءً دبلوماسياً فقط، بل كان جزءاً من غرفة العمليات. حيث لم تكتفِ واشنطن بتوفير الغطاء السياسي، بل وقفت في الصفّ الأول تُحرّك أدواتها، وتوُزّع المهام، وتُدير إيقاع المعركة بما يخدم أمن إسرائيل، ولا أحد سواها. وهكذا، فإن العالم اليوم تحكمه القوة لا العدالة. المنظمات الدولية صامتة أو ليس من يعبأ بكلمتها، والمؤسسات الإقليمية مجرّد ديكور سياسي يُستدعى عند الحاجة، ثم يُطوى بصمت.
السؤال اليوم لم يعد :التطبيع أم عدمه؟ السؤال عن مصير منطقتنا برمّتها، من يملك قرارها؟ من يرسم حدودها؟ من يتحكّم في مواردها؟ ومن يُقرّر الحرب والسلم فيها؟
لا يمكن لأمّة أن تحمي كرامتها إذا كانت عاجزة عن حماية مجالها الجوي. فالردّ على العدوان لا يبدأ بالصواريخ، بل بتحرير الإرادة. والهزيمة الحقيقية لا تقع حين تُقصف المدن، بل حين يُسكت صوت الشعوب، ويُحذف حضورها من خرائط القرار.
ولن تتغير الأحوال الا حين تعود الكلمة إلى أصحابها،ُ وتُنتزع السيادة من الطغاة، وتُغلق العواصم أبوابها في وجه المعتدين لا في وجه أبنائها، والا حين يصبح للمواطن صوته، وللشعب رأيه، وللكرامة أهميتها في صنع القرار.
**************************************
الصفحة الثالثة
مليارات خُصصت للصحة ورفوف صيدليات المستشفيات بلا أدوية!
بغداد – تبارك عبد المجيد
في بلد يواجه أزمات متعددة، تتصدر أزمة القطاع الصحي مشهد المعاناة اليومية للمواطن العراقي، حيث أصبح الحصول إلى علاج بسيط يشكل تحديا مرهقا في ظل تراجع الخدمات وندرة المستلزمات الطبية.
وتكشف شكاوى متزايدة من داخل المؤسسات الصحية عن خلل عميق يتجاوز ضعف التمويل، ليطال منظومة إدارية تعاني من الفساد وغياب الكفاءة.
وفي وقت تهدر فيه المليارات على عقود مشبوهة، يُترك المرضى، لا سيما المصابون بالأمراض المزمنة والسرطانية، في مواجهة مصيرهم، وسط نظام صحي ينهار بفعل المحاصصة والولاءات السياسية.
تراجع صحي كبير
وقال الصيدلي الممارس زيد شبيب، إن قطاع الصحة في العراق يشهد تراجعا كبيرا، مرجعا ذلك إلى قلة التخصيصات المالية للوزارة ومؤسساتها، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى أنه حتى الوحدات الصحية التي تم إنشاؤها حديثًا، يعاني أغلبها من التعطيل بسبب سوء الإدارة المالية والإدارية.
وأكد شبيب لـ"طريق الشعب"، أن "الفساد مستشر داخل الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بالعقود الخاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية"، موضحا أن هذه العقود تشوبها الكثير من الملاحظات والشبهات، وتفتقر إلى الشفافية والرقابة.
وأشار إلى حادثة شهيرة جرت في عهد أحد وزراء الصحة السابقين، حين حاول توريد أجهزة ومستلزمات طبية بقيمة تقارب 2 مليار دولار، في حين أن نفس الكميات والمواصفات كانت تُورد سابقا بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يوضح الخلل الكبير في آليات التعاقد وتفاوت الأسعار بشكل غير مبرر.
وشدد شبيب على أن مرضى الأمراض المزمنة والسرطانية هم الأكثر تضررا من هذا التراجع، حيث تؤثر قلة الميزانية المخصصة للصحة مباشرة على قدرتهم في الحصول على العلاج والرعاية المناسبة.
وأضاف ان "ما نعيشه اليوم هو نتيجة نهج إداري قائم على المحاصصة، حيث تُدار المؤسسات من قبل أشخاص لا يمتلكون الكفاءة، بل يمثلون محاصصات سياسية وجهات متنفذة، الأمر الذي أدى إلى حالة من التناحر والصراع داخل المؤسسات، على حساب صحة المواطن العراقي".
معوقات إدارية
وقال الدكتور سعد بداي، عضو نقابة الأطباء، إن مصطلح "السيولة" لا يُستخدم بشكل دقيق عند الحديث عن تمويل المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية، موضحا أن التمويل يتم عبر موازنة الدولة السنوية المخصصة لوزارة الصحة، والتي تُوزع على دوائر الصحة في المحافظات والمستشفيات التابعة لها.
وأضاف البداي في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "مشكلة نقص الموازنات تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي الحكومي، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة المؤسسات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لاستمرار العمل". وتابع انه "في كثير من الأحيان، بل في معظم الأوقات، توجد شحة كبيرة في موازنة وزارة الصحة، وهذا يؤدي إلى نقص حاد في المواد والمستلزمات الأساسية".
وبيّن أن وزارة الصحة منحت بعض الصلاحيات لإدارات المستشفيات للسماح لهم بشراء بعض المواد بشكل مباشر دون الرجوع إلى دوائر الصحة، وذلك ضمن حدود معينة، في محاولة لتجاوز بعض المعوقات الإدارية.
ومع ذلك، أكد أن شح التمويل ينعكس سلبًا على المرضى، حيث يُضطر الكثير منهم إلى شراء مستلزمات طبية من خارج المستشفى لاستكمال عمليات جراحية أو علاجات، ما يثقل كاهلهم ماليًا ويضعف من جودة الرعاية الصحية المقدمة.
معدات طبية بأسعار مضاعفة
من جهته، ذكر الناشط السياسي علي القيسي أن "ما يجري داخل وزارة الصحة من فساد إداري ومالي ممنهج لا يمكن السكوت عنه، لأنه ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وصحتهم".
وأضاف القيسي لـ "طريق الشعب"، أن "عقود بمليارات الدنانير توقع دون رقابة حقيقية، ومعدات طبية تُشترى بأسعار مضاعفة، بينما يعاني المواطن من نقص أبسط المستلزمات في المستشفيات الحكومية، هذا دليل واضح على أن الفساد أصبح جزءًا من بنية الوزارة".
وأشار إلى أن "المشكلة لا تتعلق فقط بالأموال، بل بمنظومة متكاملة من المحاصصة السياسية والولاءات الحزبية التي تحكم عمل الوزارة، وتمنع الإصلاح الحقيقي".
وتابع انه "من غير المقبول أن يبقى المواطن العراقي رهينة لصراعات الكتل وتناحر المصالح، بينما يفقد المريض حقه في العلاج والكرامة".
واختتم القيسي بالقول "نحن بحاجة إلى مساءلة حقيقية، وفتح جميع ملفات الفساد في وزارة الصحة أمام القضاء والرأي العام، وإلا فإن هذا الانهيار سيتواصل، وسيدفع ثمنه الأبرياء من المرضى والفقراء".
***************************************
العراق في الصحافة الدولية
ترجمة وإعداد: طريق الشعب
الحرب وتأثيراتها على النفط العراقي
نشرت صحيفة (The Economic Times) مقالاً حول احتمالات حدوث أزمة عالمية في إمدادات الطاقة جراء تواصل الحرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، أشارت فيه إلى أن وزير خارجية العراق حذّر من أن استهداف إسرائيل لحقل غاز بارس الجنوبي الإيراني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل، خاصة إذا ما رافق هذا الانخفاض في الإنتاج، تصعيد إضافي يؤدي إلى تعطيل الصادرات، والتسبب في التضخم، والتأثير على كلِ من منتجي ومستوردي الطاقة في جميع أنحاء العالم.
مخاطر هائلة
وذكر المقال بأن التحذير العراقي يأتي في ظل المخاوف من إغلاق مضيق هرمز وبالتالي اختفاء خمسة ملايين برميل نفط يوميًا من السوق، يصّدر معظمها من الخليج العربي والعراق، مما تنجم عنه آثار اقتصادية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم في أوروبا، وحدوث مشاكل اقتصادية كبيرة للدول المنتجة ومنها العراق، الذي سيتأثر بقوة في حال تأخر الصادرات أو توقفها. وانسجاماً مع ذلك، أدان العراق بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران واعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال، التي يضر استمرارها بالاستقرار الإقليمي والعالمي.
حقل بارس
وحول أهمية حقل بارس الجنوبي، الذي تتشارك في ملكيته قطر وإيران، والذي أدت الضربة الإسرائيلية للمرحلة الرابعة عشر منه إلى خفض إنتاجه بمقدار 12 مليون متر مكعب في اليوم، بيّن المقال بأن هذا الحقل يُوفر ثلثي احتياجات إيران من الغاز، ويُستخدم في توليد الطاقة والتدفئة والصناعة والتصدير للعراق، وهو جزء مهم من الإنتاج الإيراني من الغاز البالغ حوالي 275 مليار متر مكعب في السنة. وكان متوقعاً أن يؤدي ضربه إلى رفع اسعار النفط بأكثر من 14 في المائة.
غلق مضيق هرمز
ونقل مقال أخر عن الأمر نشره موقع (Basnews)، عن خبير في مجال الطاقة تحذيره من أن عائدات النفط العراقية ستنخفض إلى ما يقرب من الصفر إذا ما أُغلق مضيق هرمز، الذي تُصّدر من خلاله 95 في المائة من النفوط العراقية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب إقليم كردستان إلى تركيا، خاصة وإن البديل البري الوحيد - وهو الطريق إلى الأردن - لا يتحمل تصدير سوى حوالي 100 ألف برميل يوميًا، ويُباع بأسعارٍ مُخفّضةٍ للغاية، فيما يمتاز خط الأنابيب العابر شمالاً بالقدرة على تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميًا. ونصح الكاتب بغداد بالتحرك بسرعة وحل المشاكل مع أربيل فهي مسألة إرادة سياسية حسب تقديره.
الاقتصاد الريعي في زمن الحرب
ولموقع Oilprice.com، كتب تشارلز كينيدي مقالاً حول المخاطر التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد العراقي في حالة تراجع أو ربما انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، أو توقف الصادرات، أشار فيه إلى أن صادرات النفط قد شكّلت 91 في المائة من الإيرادات الفيدرالية العراقية البالغة 107 مليارات دولار في عام 2024، وهي نسبة تجعل البلاد عرضة لأي تقلبات حادة في أسعار النفط او في تصديره، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى دعوة العراق لاعتماد إصلاحات عاجلة، خاصة بعد اعتماده سعراً تقديرياً في موازنته بسبعين دولار للبرميل قبل أن يقفز إلى 84 دولاراً مؤخراً. كما حذر الصندوق من استمرار الخلافات مع حكومة إقليم كردستان بشأن تهريب النفط وتقاسم الإيرادات لأنها مشاكل كبيرة تُعيق الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الكاتب بأن عدداً من المحللين قد حذّروا من جهتهم من أن العراق على شفا انهيار اقتصادي، إذ لا يزال هذا البلد الذي يعّد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط في إيرادات الحكومة الاتحادية، بل هو من أكثر الدول النفطية اعتمادًا على عائدات النفط كنسبة مئوية من إيرادات الموازنة، وهو الأمر الذي دفع بالاقتصاديين إلى دعوة بغداد لتنويع مصادر الدخل كوسيلة للحد من تأثر مالية البلاد بتقلبات أسعار النفط.
إصلاح عاجل
ونقل الكاتب عن بعض المختصين قولهم بأن إيرادات الميزانية العراقية تُظهر نقاط ضعف هيكلية، حيث لا تزال الحكومة عالقة تحت وطأة سوء الإدارة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مما يعيق أي تنمية أو نمو حقيقي، مشيرين إلى أن ضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، يشترط تنويع العراق لمصادر دخله، وخفض الإنفاق العام، والتعامل مع العجز المالي بشكل أكثر فعالية.
************************************
عين على الاحداث
إن كنت ... فكُن ذكوراً
رجحت لجنة الزراعة والمياه النيابية أن تؤدي الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، فيما استبعدت وزارة الزراعة هذه التوقعات وأكدت على أن الانتاج الحالي يغطي حاجة الاستهلاك المحلية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الجميع على وجود مخاطر جدية تواجه الأمن الغذائي في بلادنا، ويؤشرون سعة الفوضى التي يتخبط فيها "أولو الأمر" وافتقادهم لخطط الطواريء، يتساءل الناس عن السر وراء صرف 311 مليار دولار على استيراد الغذاء خلال خمس سنوات، إذا كان الإنتاج المحلي قادراً على تلبية حاجة السوق!
فدوة لعيون الخصخصة
كشفت هيئة النزاهة عن بلوغ مجموع الخسائر في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 42 مليار دينار خلال عامين، مؤكدة على أن 148 حافلة عاطلة عن العمل، من أصل 313 حافلة تـمَّ شـراؤها مؤخراً. وحددت الهيئة أسباب تدهور اوضاع الشركة، بالمنافسة غير العادلة بينها وبين القطاع الخاص، وعدم إصلاح وإدامة المركبات إلى الحد الذي وصلت فيه خسائر الاندثار 22 مليار دينار، وتفشي الفساد وضعف الإدارة. هذا وبات جلياً للناس بأن مؤسسات القطاع الحكومي تواجه مخططات منظّمة تهدف إظهارها كشركات خاسرة لبيعها بالخردة، رغم إن تطوير النقل العام بات ضرورة حياتية للخروج من أزمة الإزدحامات.
غزارة الإنتاج وسوء التوزيع
بيّنت بعض الإحصائيات عن أن العراق الذي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً باحتياطي نفطي يصل إلى 145 مليار برميل، يمتلك 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، و10 مليار طن من الفوسفات، وثلثي الكبريت في العالم، ومليار قدم مكعب من رمال السلكا، وكميات واعدة من الكلس والحديد والنحاس والذهب. هذا وفيما قدّر مستشار رئيس الحكومة قيمة ثروات البلد الطبيعية بأكثر من 16 تريليون دولار، تعاني البلاد من غياب بيئة سياسية وأمنية وتشريعية ملائمة لاستثمار الثروة، وتفتقر لإدارة سليمة لها، مما يعّرض اقتصادنا لهزات متتالية ويُبقي ربع شعبنا تحت مستوى الفقر ويُفقد الباقين الخدمات الأساسية.
كان غيركم أشطر!
شهدت مدن عراقية عديدة مؤخراً موجة جديدة من الاحتجاجات المطلبية، شملت فئات وقطاعات مختلفة، وتوزّعت بين مطالب خدمية وتوظيفية وأخرى تتعلّق بحقوق وظيفية مهدورة، وذلك في مدن بغداد والنجف والمثنى والديوانية والبصرة وغيرها. وبدلاً من الإستجابة الفورية وتلبية هذه المطالب، تم توجيه بعض القوات الأمنية لاستخدام القوّة المفرطة في التعامل مع هذه التظاهرات، معتبرة إياها حالات أمنية وليست حراكاً شعبياً للمطالبة السلمية بالحقوق التي ضمنها الدستور وأنكرتها منظومة المحاصصة والفساد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن العراقيين باتوا يسخرون من القمع لأنهم يدركون بأنه أعجز من أن يثنيهم عن حقوقهم العادلة.
تدرون لا ما تدرون!!
في اليوم العالمي للتصحر، تم الكشف عن تحول أكثر من 70 في المائة من الاهتمام بالعمالة إلى آدر غير منتجة وظهر نحو 40 في المائة من مساحة العالم للتصحر، ما سبّب قتلت بمليارات الدولارات وموجة الهجرة إلى المدن وفي التلوث البيئي واختفاء الكثير من السلالات البرية. مع أخذ هذا بعين الاعتبار الناس في شركة زراعية والقاصرة، سبباً رئيسياً وراء هذه الكارثة، مكثفون "أولي الأمر" بوقفة جديدة لمعالجة المشكلة عبر انتزاع حقوقنا المائية في الرافدين، وتشريع قوانين تربية البيئة، الدراسة الجامعية الأولى ستهلاك المياه بعد تأثير تأثيرات حرق الغاز.
******************************************
الصفحة الرابعة
الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب سوق العمل العمال بين التهميش والتحول الرقمي!
بغداد ـ تبارك عبد المجيد
مع تسارع دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجالات العمل في العراق، يزداد القلق بين أوساط العمال حول مستقبل وظائفهم، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على المهام اليدوية أو المتكررة. ففي غياب سياسات حكومية واضحة لتنظيم هذا التحول، يواجه كثير من العاملين مخاوف حقيقية من الإقصاء أو فقدان مصادر رزقهم، وسط تغير سريع في طبيعة سوق العمل.
ويرى خبراء أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يقدمه من فرص لتطوير الأداء وزيادة الكفاءة، قد يتحول إلى أداة لتقليص الوظائف بدل خلقها، إذا لم يُرافقه وعي مجتمعي وتشريعات تحمي حقوق العاملين.
نظام في اتخاذ القرار
وقال المختص في الأمن السيبراني حسين السعيدي، إن "الحديث عن الذكاء الاصطناعي بات يأخذ مساحة واسعة، خاصة بعد دخوله في مجالات متعددة كالتعليم، الطب، البرمجة، وحتى الصحافة". وأكد السعيدي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية، بل أصبح نظاماً يشارك في اتخاذ القرار أو دعمه، ما يخلق تأثيرات واسعة النطاق على سوق العمل والمجتمع.
وأضاف السعيدي لـ "طريق الشعب"، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير الأداء وتسريع الإنجاز وتقليل الأخطاء، خاصة في البيئات التقنية والطبية. كما أنه يمكن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة من المنافسة في سوق تهيمن عليه الشركات الكبرى، فضلاً عن خلق وظائف جديدة في مجالات مثل تطوير الأنظمة الذكية وصيانتها".
وأردف "لكن، في المقابل، هناك من ينظر إلى هذه التكنولوجيا باعتبارها تهديداً حقيقياً، خاصة للوظائف التي تعتمد على المهارات الروتينية أو اليدوية. ويخشى البعض أن تؤدي زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية إلى فقدان عدد من فئات المجتمع لفرص العمل، لا سيما أولئك الذين لا يمتلكون المهارات الرقمية الكافية".
وبيّن ان "القلق لا يتوقف عند مسألة البطالة، بل يمتد إلى قضايا أكثر تعقيداً مثل التفاوت الرقمي بين الأفراد، واحتمالات الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التكنولوجيا، سواء في المراقبة أو التلاعب بالمعلومات".
وفي ظل هذا الواقع، نوّه السعيدي بأن "العراق يمتلك طاقات شبابية كبيرة، وعقولا قادرة على التأقلم مع التحولات التكنولوجية"، مؤكدا أهمية التوعية والتوجيه، ليس فقط من خلال سياسات حكومية، بل عبر المناهج التعليمية في المدارس والجامعات.
واختتم السعيدي حديثه قائلاً ان "الذكاء الاصطناعي ليس عدواً، لكنه يحتاج إلى إدارة ذكية كي لا يتحول إلى عبء على المجتمع".
تحديات جدية
بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في العراق، ذكر علي محمد، ناشط في قضايا العمال، "إننا نواجه تحديات جدية تتعلق بمستقبل العمال في العراق، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمل اليدوي أو المتكرر"، لافتا إلى وجود "مخاوف حقيقية من أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى تقليص فرص العمل، لا سيما في ظل غياب سياسات حكومية واضحة لحماية حقوق العاملات والعمال، وتأهيلهم لمواكبة التحول الرقمي".
وأضاف لـ"طريق الشعب"، أنّ "العراق بحاجة ماسة إلى وضع خطط استراتيجية شاملة تضمن انتقالًا عادلًا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، دون المساس بكرامة وحقوق الطبقة العاملة. يجب أن تركز هذه الخطط على التدريب المهني، وتحسين البنية التحتية للتعليم، وضمان الحماية الاجتماعية للعمال الذين قد يتأثرون بفقدان وظائفهم".
واختتم بالقول ان "نحن لا نعارض التطور التكنولوجي، بل ندعو إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز العدالة الاجتماعية، لا أداة لتكريس التفاوتات الاقتصادية والإقصاء من سوق العمل".
تأثيرات متسارعة
وتحدث زيد عمر، الخبير في الأمن السيبراني، عن تأثيرات متسارعة تشهدها الساحة العراقية في ما يتعلق باعتماد الذكاء الاصطناعي، خاصة منذ بداية عام 2025، مشيرا إلى أن التحول الرقمي بدأ يأخذ منحى أكثر جدية في العراق، سواء من جانب الشركات أو الأفراد، لا سيما في مجالات العمل والدراسة.
وأوضح عمر لـ "طريق الشعب"، أن "هذا التحول، رغم الفرص الكبيرة التي يتيحها، بدأ يثير القلق لدى العديد من الموظفين، وخصوصا من يعملون في وظائف تقليدية تعتمد على المهام المتكررة، مثل الترجمة والتحرير، حيث أصبحت هذه الوظائف مهددة نتيجة اعتماد الأفراد والشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، المجانية منها والمدفوعة".
وبيّن أن عددا من مكاتب الترجمة في بغداد، أربيل، والبصرة، شهدت تراجعا في الطلب على خدماتها بنسبة تزيد على 35 في المائة خلال عام واحد، بحسب دراسات محلية، بينما تأثر نحو 15 في المائة من العاملين في مجال الترجمة والتحرير بشكل مباشر.
وعلى صعيد المهارات الرقمية، أشار عمر إلى نتائج مسح وطني أظهر أن أقل من 20 في المائة من موظفي القطاع العام يمتلكون مهارات رقمية متوسطة أو متقدمة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإقصاء في حال تسارعت وتيرة التحول إلى العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي بدأ يشق طريقه إلى القطاع الخاص بوضوح، حتى في مهام مثل كتابة المحتوى وتصميم الصور، ما جعله منافسا مباشرا لمصممي الجرافيك، المترجمين، كتاب المحتوى، وصانعي الفيديوهات".
ووفقا لمحادثات أجراها مع شركات عاملة في المجال، فإن 40 في المائة من العاملين في هذه الوظائف تأثروا بالفعل بفعل هذا التحول على مستوى العراق والعالم.
وأشار عمر إلى غياب القوانين الواضحة في العراق التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، محذرا من أن هذا الفراغ القانوني قد يؤدي إلى حالات فصل تعسفية دون وجود حماية قانونية للعاملين، لاسيما أن الشركات تمتلك السلطة الكاملة في قرارات التوظيف أو الاستغناء عن الموظفين.
*****************************************
لا.. لخصخصة مصرف الرافدين
خليل ابراهيم العبيدي
قبل الدخول في أية تفصيلة، نود أن نذكر، بأن مصرف الرافدين كان ولا زال مؤسسة مالية مرموقة، وكان يأتي في مقدمة المصارف العربية لا بل وقبل المصارف الاجنبية التي كانت عاملة في العراق قبل قرارات التأميم لعام 1964، فقد كان موضع ثقة الشركات الأجنبية على ما أذكر، وكان منافسا حقيقيا لمصرف الشرق الاوسط والبنك العثماني والبنك البريطاني والبنك الشرقي وتوماس كوك، وغيرها من البنوك الاجنبية المعروفة آنذاك.
مسيرة المصرف المالية والصيرفية
تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 33 لسنة 1941، برأسمال حكومي قدره 50 ألف دينار عراقي، وكان الدينار آنذاك يساوي 4 دولارات أمريكية. وكان منذ بدايته يتبع نظاما محاسبيا دقيقا ينشر بموجبه كل سنة نشاطه المصرفي والتجاري ونسبة الفوائد وصافي الأرباح بشفافية عالية، ولم يكن يوما مشروعا حكوميا خاسرا، بل مشروعا رابحا من خلال إعلان نشاطاته المصرفية في الصحف المحلية، وكانت ارباحه معلنة، وكانت الفوائد التي يمنحها مجزية بالقياس إلى قيمة الدينار الدولارية آنذاك، هو مصدر ثقة المواطن، و كان يمثل وجه الدولة الناصع في كافة العمليات المصرفية، بدءا من الايداعات وصولا إلى تسهيل نشاطات الدولة في الوصول ماليا إلى المواطن من حيث ضمان وصول الرواتب والاجور، او من حيث تبرئة ذمة الدولة في تعاقداتها الحكومية او في تمويل المشاريع، او الحفاظ على الودائع الخاصة او على ايداعات القطاع العام، او القطاع التعاوني، او موجودات النشاط الخاص المالية، وقد كان للبنك الدولي رأي مشجع في المصارف الحكومية العراقية، سيما مصرف الرافدين، والمصرف كان وسيلة الدولة في تعاملها المالي الدولي إلى جانب البنك المركزي، وله قوة الإبراء الدائمة للدوائر الرسمية في الخارج سواء اكان عن طريق فروعه او من خلال تعامله مع مصارف أخرى، وكان موضع ثقة البنك المركزي في التعريف بالمصارف المراسلة من خلال فروعه أينما وجدت. وأن له ما لا يقل عن 147 فرعا داخليا و8 فروع خارجية ورأسماله المعلن اليوم حسبما هو منشور 238 مليار دينار. ولم نتمكن من الحصول على إجمالي الودائع لديه، وهي تقدر بتريليونات الدنانير. وفيه يضع المواطن المحلي كل الثقة. ولم يحصل ان امتنع المصرف يوما عن صرف مستحقات المودعين كما حصل في العديد من المصارف الأهلية، والسبب هو أن المصرف يعمل بضمانة الدولة.
المصرف لا يخصخص الا بقانون
ان ما تعرض له مصرف الرافدين وشقيقه مصرف الرشيد من نشاطات غير مألوفة في تعاملاتهما المالية والمصرفية كان نتيجة فساد عم أغلب دوائر الدولة، وكان هذا الفساد ولا يزال واقفا على قدميه رغم كل الإجراءات الحكومية، وتسرب إليه من خلال المخالفات المالية والمصرفية وذلك لوجود خلفية إدارية مانعة لمكافحة الفساد وتجاوز التعليمات المصرفية القديمة، غير أن محاولات تخريبه باتت اكثر قوة من مقاومته، والمؤسف ان وزارة المالية لم تعد تتبع ما كان يتبع سابقا، الا وهو ان ادارات المصارف الحكومية كانت تعنين من النخب المشهود لها بالاختصاص والنزاهة والخبرة .
ان التوجهات الحكومية لخصخصة المنشآت العامة الناجحة او حتى الخاسرة هي توجهات خاطئة تقف خلفها منظمات رأسمالية سيئة النوايا كانت ولا زالت عدوة حتى للقطاعات الناجحة ضمن حروب مستمرة لكل قطاع عام في الدول النامية، ونود ان نشير إلى حقيقة وجدتها لدى الشعب العراقي والمصري، تلك هي حب المواطن للقطاع العام، الناجح، ويدعو المواطن في كلا البلدين إلى إصلاح الفاشل، وله قاعدة، الا وهي ان المشروع يكفي ان يوفر الرواتب والأجور لمنتسبيه، خير من الغائه والتلاعب بعائداته. ونود التنويه ان الدول الرأسمالية خلال ازمة كورونا اكتشفت عجز القطاع الخاص في حماية المجتمعات الغربية من الوباء، سيما المستشفيات وشركات دفن الموتى، وشركات إنتاج الجوية واللقاحات، واليوم يجري الحديث حول تقوية دور القطاع العام في الدول الرأسمالية، لأنه الاقدر على مواجهة الازمات، وتضرب الامثال بقدرة الجيوش على المساعدة في أسوأ الظروف. ومنها ظروف الطوارئ.
نحن لسنا في معرض نقد الإجراء فقط، ولكن لماذا هذه النسبة المتواضعة للمساهمة الحكومية.؟ أليس الأسلم أن تكون حصة الحكومة 51 بالمئة، ولماذا كل هذا التنازل عن مضمون سيادة الدولة على قطاعها المصرفي،
أننا نناشد الحكومة للتروي في اتخاذ القرار، لأنها كما نعلم لا تملك حق التصرف بمستقبل المشاريع الحكومية سيما مصرف الرافدين، أذ تم تأسيسه بقانون، لذا لابد أن يغير هيكله بقانون يصدر عن مجلس النواب، وان مساهمات المصارف الأهلية برأسمال هذا المصرف العتيد ستجعله خاضعا لفساد إجراءاتها ولمخالفاتها المالية التي يشكو منها الينك المركزي على الدوام، والمطلوب بدلا من رأسملة المصرف العمل على اعادة هيكلته مجددا وفقا لما تمليه تعليمات ديوان الرقابة المالية وتوصياته، وان ما نرجوه هو إصلاح حكومي جاد يعتمد قوة القانون وتطبيق الاحكام، والحليم تكفيه اشارة الإبهام.
**************************************
وقفة اقتصادية.. قوتان تتجاذبان الاقتصاد العراقي
إبراهيم المشهداني
انطلاقا من تطبيق سياسات اقتصادية فاشلة في مجال التنمية تتبدد الآمال في تحسن النمو الاقتصادي العراقي وتطور قطاعاته الانتاجية المختلفة في المستقبل القريب بالرغم من التدفقات النقدية الكبيرة التي تزيد على 1500 مليار دولار معظمها من تصدير النفط بعد عام 2003 التي تعرضت إلى عمليات استحواذ منظمة عبر ما سميت باللجان الاقتصادية للأحزاب المهيمنة على السلطة ومصادر المال الحكومي والخاص.
فقد سبق أن توقع صندوق النقد والبنك الدوليين أن الاقتصاد العراقي سيتعافى في عام 2021 فالأول توقع أن الاقتصاد العراقي سيحقق نموا بمعدل في 3.6 المائة فيما توقع البنك أن المعدل سيكون 2.6 في المائة ويعزو الاثنان ، وان اختلفا في تقديراتهما ، وخاصة الصندوق أرجع هذا النمو إلى الاصلاحات الجوهرية في الورقة البيضاء ، التي أعدتها الحكومة وقتذاك، على افتراض تحسن أسعار النفط، غير أن البنك الدولي كان أقل تفاؤلا في مخرجات الورقة البيضاء في انجاز بعض الإصلاحات لكن للاقتصاديين العراقيين رأيا أخر، وهم على حق، معتبرين توقعات المؤسستين الدوليتين متفائلة اكثر من اللازم، حيث لم يروا تنفيذا حقيقيا في الإصلاحات للورقة البيضاء سوى سعر الصرف الذي جاء في وقت ومستوى غير مناسبين، كما أن اسعار النفط من الصعوبة المراهنة عليها بحكم ظاهرة التذبذب التي تحصل أحيانا بفعل عوامل دولية غير مسيطر عليها، واستنتجوا من ذلك أن الاقتصاد العراقي واقع تحت تأثير هاتين القوتين .
وحتى لو شهد سعر صرف الدينار العراقي ارتفاعا إزاء الدولار في بعض الأحيان لأسباب ظرفية فانه لا يشي بتحسن حقيقي في المؤشرات المالية بل قد تكون هدنة مؤقتة وهذا ما حصل. إن هذا الأمر إجراء مؤقت مرتبط بالتأثيرات الخارجية وعوامل محلية. ومع ذلك فإن الإقرار باستدامة تحسن سعر صرف الدينار أمام الدولار يعتمد على قدرة البنك المركزي على استخدام احتياطياته الأجنبية من جهة واستقرار أسعار النفط عالميا، ولا نعتقد أن هذا ممكن في ظل انخفاض أسعار البترول عالميا وعلاقته بالدولار بوصفهما صنوان لا يفترقان إلا إذا تم التحول عن الدولار كعملة عالمية في الأمد الطويل.
ومن جهة أخرى فان الاقتصاد العراقي كما هو معلوم يعتمد بنسبة 94 في المائة على تصدير النفط الخام وقطاع النفط كما هو معروف يسيطر على 3 في المائة من القوى العاملة في العراق حسب راي الراحل (د. باقر محمد شبر) على سبيل المثال، كما أن باقي القطاعات تنتج سلعا لا تدخل في التجارة الدولية فهي تركز على انتاج الخدمات التي لا تدخل في السوق الدولي وبالتالي فان العراق يعتمد فقط على تصدير النفط الخام للحصول على العملة الصعبة التي يتسرب جزء كبير منها إلى الخارج عن طريق التهريب وعن طريق المقاولين وهجرة العراقيين.
إن مبعث ضعف التفاؤل في تحقق نمو اقتصادي واعد، بخلاف ما ذهبت اليه المؤسستان المشار اليهما، هو أن المعطيات لا تدل على قيام الحكومة بإجراءات حازمة للتنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو نتيجة للصراع بين القوى السياسية الطامحة للاستحواذ على السلطة وانعكاس ذلك على سباقها وتلهفها للفوز بالانتخابات القادمة وسعيها لتشكيل حكومة تأتمر بأوامرها. مما تقدم بيرز الاستنتاج أن الاقتصاد العراقي يؤسر بين قوتين جاذبيتين التمسك بالريع النفطي وإهمال قطاع الانتاج والاستثمار. لكل ذلك نرى ما يلي:
- تنويع الفروع الصناعية المختلفة وتنميتها لتحقيق التغيرات الهيكلية المرغوبة ضمن القطاع الصناعي وتحقيق التوازن بين فروع الصناعات الاستهلاكية والوسيطة والانتاجية وتعظيم الترابط بينها والاعتماد المتبادل بين هذه الفروع الصناعية الثلاثة.
- إعادة النظر بالسياسة النقدية من خلال إعطاء دور أكبر للجهاز المصرفي للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية عبر التسهيلات الائتمانية والدخول بشكل واسع في عمليات الاستثمار عبر التشجيع على جذب رؤوس الاموال المكتنزة والتي يقدرها الاقتصاديون ب 30 تريليون دينار وهذا يتطلب وضع سياسية ادخارية واضحة تتوافر فيها إجراءات درء المخاطر.
*****************************************
الصفحة الخامسة
من إنشاء الطرق إلى تشييد الأبنية انتهاك محرّمات أكتاف الأنهار بتجاوزات سافرة
متابعة – طريق الشعب
تتعرض محرّمات الأنهار العراقية بشكل عام إلى تجاوزات مختلفة، منها نصب محطات إسالة ومجارٍ بصورة غير نظامية، وإلقاء نفايات ومخلفات، وفتح منافذ، واستغلال الأكتاف بإنشاء أبنية ومنشآت من قِبل متجاوزين، فضلاً عن شق طرق مجاورة للأنهار بشكل يخالف التخطيط العمراني، ما يؤدي إلى حصول حوادث سير. بينما لا تستطيع الحكومة تسييج المحرّمات لحمايتها من التجاوزات، بسبب عمليات الكري التي تجري بين فترة وأخرى، والتي تتم من على هذه الأجزاء من النهر.
ومحرّمات الأنهار عبارة عن مناطق تحيط بالمجاري المائية، وتخضع لقوانين وأنظمة خاصة لحمايتها ومنع التجاوز عليها. وتُستغل هذه المحرّمات في الحفاظ على الثروة المائية ومنع تلوثها وتضررها. كما تُستخدم في إجراء أعمال صيانة الأنهار وكريها.
تجاوزات مختلفة
وتقسم الأنهار في العراق إلى رئيسة وموزعة وحقلية، وهذه يتم تحديدها وفق ضوابط المحرّمات في وزارة الموارد المائية، والتي تقر بأن لكل نهر محرّما، وبعض المحرّمات تصل مسافته إلى 50 متراً، وبعضها 25 أو 15 أو 10 أمتار، وأقلّ محرّم تبلغ مسافته 5 أمتار للقناة الحقلية الصغيرة التي ليس فيها أي فرع – وفقا لمعاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، غزوان السهلاني.
ويؤكد السهلاني في حديث صحفي أن "الأنهار بصورة عامة تتعرض إلى تجاوزات عدة، فبالإضافة إلى التجاوز على الحصص المائية من نصب محطات وفتح منافذ، هناك استغلال لأكتاف الأنهار من خلال إنشاء الأبنية من قِبل متجاوزين أو إنشاء مشيدات ثابتة ضمن المحرّمات، في مخالفة لقانون استغلال الشواطئ".
ويضيف قوله: "كذلك هناك تجاوزات كثيرة من خلال إنشاء مشاريع الطرق على محرّمات الأنهار. فالمفروض أن يكون التبليط خارج تلك المحرّمات، لكن ما يحدث هو أنه بسبب وجود دور سكنية قرب الأنهار، في أماكن يصلح إنشاء الطرق عليها، تقوم دوائر الطرق والبلدية باستغلال المحرّمات في إنشاء الطرق"، مبينا أن "الغاية من وجود المحرّمات هو استخدامها في صيانة الأنهار وتنظيفها أو توسيعها، وإعادة تصميمها وتبطينها. لذلك من الضروري الإبقاء على هذه الأماكن وعدم التجاوز عليها". ويشير السهلاني إلى أن "موافقات تقليص المحرّمات النهرية، تُمنح بشروط ولحالات حرجة في مناطق محددة، بحيث لا تؤثر على أعمال تنظيف النهر ولا على توسعته مستقبلاً، وفي حال تم إعطاء استثناء باستغلال المحرّمات فهو يُعطى على شرط ترك مسافة لا تقل عن 10 أمتار من حافة أي نهر، ولمقطع معين من المجرى المائي، وليس على طوله".
عدم الالتزام بالمسافات المحددة
من جانبه، يرى عضو لجنة النقل البرلمانية زهير الفتلاوي، أن "المسافة التي تُترك ضمن شروط إقامة مشاريع الطرق على الأنهر، لا يتم الالتزام بها. لذلك يلاحظ وجود طرق ملاصقة للأنهر في مخالفة واضحة لقانون الموارد المائية. بينما لا تستطيع الحكومة تسييج تلك الأجزاء لغرض حمايتها، بسبب استخدامها في كري الأنهر".
ويضيف في حديث صحفي قوله أن "مرور السيارات قرب الأنهر مع عدم وجود إشارات مرورية واضحة وإنارة للطرق قد تسبب حوادث سير، خاصة لمن يسلك الطريق لأول مرة. حيث يتفاجأ السائق بوجود بزل أو نهر أمامه. لذلك من الضروري توسعة القناطر الواقعة على الأنهار والمبازل".
ويوضح الفتلاوي أن "الكثير من المبازل يلاحظ أنها تأخذ من الجرف (أكتاف الأنهار) بسبب عدم تغليف هذه الأجزاء، والأمر من مهام وزارة الموارد المائية"، لافتا إلى "عدم صرف تخصيصات الوزارة من الموازنة الاتحاد حتى الآن، عدا التخصيصات التشغيلية، كما هو الحال في بقية الوزارات".
خطورة سير المركبات قرب الأنهر
يعتبر سير المركبات على الطرق التي تقع إلى جوار الأنهار خطيراً. لذلك ينبغي قيادة المركبة بحذر في تلك الأماكن، والأفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان. أما إذا كان الطريق رسمياً وبحالة جيدة وسالكا، فيمكن السير عليه بسرعة 60 إلى 80 كيلومترا في الساعة - وفق مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر.
ويعزو العقيد أسباب تكرار الحوادث قرب الأنهر إلى "عدم التزام السائق بالتعليمات والقوانين المرورية، وعدم الانتباه أثناء قيادة المركبة. كما أن السير عكس الاتجاه، خاصة على هذه الطرق، قد يكون مميتاً. لذلك يعاقب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 بغرامة قدرها 200 ألف دينار عراقي على هذه المخالفة".
ويدعو شاكر، السائقين عند قيادتهم مركباتهم على جوانب الأنهر أو حتى في الطرق الرئيسة والسريعة، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم ارتكاب أي مخالفة قد تؤدي إلى الحوادث، مثل استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة، أو تجاوز السرعة المحددة، وغير ذلك.
******************************************
الخدمات منعدمة والحياة لا تُطاق هجرة جماعية من أقدم أحياء الدجيل
متابعة – طريق الشعب
يشهد حي الوحدة في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، تدهوراً كبيراً في واقع الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وشبكات المجاري، ما دفع عشرات العائلات إلى إغلاق منازلها والنزوح إلى مناطق زراعية تتوفر فيها مقومات العيش الأساسية، بعد أن تحولت الشوارع والساحات إلى برك لمياه المجاري ومكبات للنفايات، وغابت عنها مظاهر الحياة. وكثيرا ما تكررت الوعود من جهات حكومية بشمول تلك المنطقة بمشاريع الجهد الخدمي، إلا أن ذلك لا يُنفذ فعليا على أرض الواقع، الأمر الذي يُهدد بإفراغ المنطقة من سكانها، في ظل مطالبات شعبية واسعة بإدراجها على جدول خطط الإعمار العاجلة. يقول المواطن فراس جاسم الحياني، أن "منطقة حي الوحدة، إضافة إلى منطقة 57، منكوبتان من الناحية الخدمية"، مبينا في حديث صحفي أنه "قبل سنتين، زار فريق الجهد الهندسي المنطقة، وتم التواصل مع رئيس الوزراء من أجل اتخاذ اللازم في شأن الواقع الخدمي، لكن لم تسفر تلك التحركات عن أي نتائج حتى اليوم". ويؤكد أن "عائلات كثيرة نزحت بسبب غياب الخدمات الأساسية، واتجهت نحو المناطق الزراعية لتوفر الحد الأدنى من الخدمات هناك"، لافتا إلى ان "منطقتنا كانت تعج بالسكان. أما اليوم فقد أصبحت شبه مهجورة". فيما يقول المواطن عمار عادل، أن "أطفالنا كانوا سابقا يلعبون في الأزقة، وكانت الحياة تدب في المنطقة. أما اليوم فقد أصبحت مهجورة، وهي التي كانت تُعتبر جزءا من تراث قضاء الدجيل، لكونها من أقدم مناطقه".
وأوضح أن "غياب خدمات الكهرباء والماء والمجاري، أجبر السكان على مغادرة منازلهم، والانتقال إلى مناطق أخرى"، مطالبا الجهات الحكومية بمنحهم حقوقهم الخدمية الأساسية، وألا تقتصر إجراءاتها على زيارات ما قبل الانتخابات!
إلى ذلك، قال مدير بلدية الدجيل علاء عبد الهادي، أن "حي الوحدة ومنطقة 57 تمثلان أولوية على جدول مشاريعنا"، موضحا في حديث صحفي أن "تأخر إعمار المنطقتين كان سببه عدم اكتمال مشروع شبكة المجاري. أما اليوم فقد اكتمل المشروع ولم يتبق سوى ربط مجاري الامطار. حيث وصل العمل إلى مراحله الأخيرة".
وتابع عبد الهادي قوله أنه "تم إعداد كشوفات متكاملة للمنطقة، وسيتم شمولها بمشاريع الجهد الخدمي أو أي مشاريع مستقبلية أخرى. نعد الأهالي بأن الأولوية ستكون لهم، وأن الحلول أصبحت قريبة".
*******************************************
مرصد بيئي: 40 في المائة من أراضي العراق متصحرة
متابعة – طريق الشعب
كشف "مرصد العراق الأخضر" المعني بالبيئة عن تعرض نحو 40 في المائة من أراضي العراق للتصحر، منّوها أيضا إلى تحوّل أكثر من 70 في المائة من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ غير منتجة.
وقال في بيان صحفي أول أمس الثلاثاء، في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 17 حزيران، أن "نحو 40 في المائة من مساحة العراق الإجمالية تأثرت بظاهرة التصحر، بعضها بحاجة إلى ماسة إلى مشاريع تحريج واسعة للحد من التدهور البيئي". وأضاف أن "نسبة التصحر لم تقتصر على الأراضي العامة فقط، بل طالت الأراضي الزراعية أيضًا. حيث تحولت 70 في المائة منها إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة نتيجة الجفاف وسوء إدارة المياه". وأشار المرصد إلى أن فرق الرصد الميدانية المنتشرة في جميع المحافظات وجدت أن محافظة ذي قار تعد الأعلى من حيث معدلات التصحر والنزوح السكاني، نتيجة تراجع الغطاء النباتي وشح المياه.
في المقابل، سجلت محافظة نينوى أدنى مستويات التصحر، بفضل طبيعتها الجغرافية المعتدلة، وزيادة الاهتمام الشعبي بمشاريع التشجير وزراعة الأحزمة الخضراء. وأكد المرصد أن "استمرار هذا الاتجاه دون تدخل حكومي وإقليمي عاجل قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية خطيرة"، محذرًا من أن "تصاعد الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن سيزيد من الضغط على الخدمات والبنى التحتية".
ويعد التصحر من أبرز التحديات البيئية التي يواجهها العراق في السنوات الأخيرة، في ظل انخفاض معدلات الأمطار، وتقلص واردات المياه من دول الجوار، إلى جانب ضعف إدارة الموارد المائية على المستوى المحلي.
********************************************
اگول.. هل سنودع دجلة؟!
حسين النجار
يدير جميع المسؤولين المتنفذين وجوههم عن نهر دجلة، حين يعبرونه بمواكبهم الجرارة خلال الجسور التي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة. فليس في استطاعة احد ان يواجه النهر بحاله المزري هذا، حيث يصارع سكرات الموت!
لا اعتقد ان احداً منهم يعجبه هذا الحال، هم وجميع البغداديين والعراقيين الذين تربطهم بهذا النهر حكايات وذكريات، لكنهم مع ذلك لم يتحركوا قيد انملة لإنقاذه واعادته إلى الحياة. فالأمر ليس بأيديهم بل خرج عن السيطرة.
لقد عقد قادة البلد اجتماعات مختلفة مع الجانبين التركي والايراني، وبحثوا في مختلف الامور السياسية والاقتصادية، حتى في ما يخص المياه، لكنهم في الواقع لم يتمكنوا من الحصول على حصة عادلة من المياه.
وفي الداخل، بات الفساد يهدد ما تبقى من مقتربات النهر، بفعل البناء المشوّه على جانبيه في مراكز المدن وضواحيها وقرب الجسور. ومن ابرز المتهمين في ذلك القيادات السياسية المتنفذة التي اشترت قطع اراض واسعة على الجانبين، وحولتها الى قصور فارهة، ومطاعم وفنادق كبيرة.
ومن اجل عدم كشف الحقيقة، لوحظ ان هناك عمليات كري وتنظيف لأجزاء معينة من النهر بالقرب من الجسور التي يُسمح بعبورها سيرا على الأقدام، لكن لا يحق لأي مواطن الاقتراب من تلك الأجزاء، ولا حتى التقاط صور للأراضي التي ظهرت في النهر!
قد يأتي اليوم الذي ننعى فيه دجلة، ولا نستغرب إذا ما كان كاتب النعي من أولئك الذين قاموا بقتله!
*****************************************************
شكر وعرفان
أتوجه بالعرفان والامتنان المقرونين بالشكر الجزيل، لجميع الرفاق والأصدقاء الذين غمرونا بفيض من مشاعر التعازي الطيبة وصادق المواساة، ولجميع من شارك في تشييع عميد الأسرة الفقيد الكبير السيد حسام الشلاه، ولمن ساهم في مراسم الدفن وحضور مجلس العزاء، وبينهم الرفيق رائد فهمي وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ومحلية بابل للحزب ومنظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد، والأعداد الغفيرة من الأصدقاء محبي الفقيد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وبينهم الصديق العزيز الدكتور جعفر عبد الأمير الياسين الذي أقام مجلس عزاء آخر.
لقد كان لعبارات التعزية والتأبين والمواقف النبيلة الصادقة والتضامن الإنساني معنا، أبلغ الأثر في تخفيف الكثير من معاناة الفقدان المؤلم، متمنين للجميع الصحة والسلامة وألّا يصيبهم مكروه في عزيز عليهم.
عن الأسرة
رشاد الشلاه
17/06/2025
**************************************
مواساة
- بمزيدٍ من الحزن والأسى، تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في بابل، الشخصية الوطنية المعروفة كاظم مصطاف عبد الأمير، الذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.
كان الفقيد من المناضلين الذين نذروا حياتهم للحزب، مدافعًا عن قضايا شعبه ووطنه، ومتمسكًا بمبادئه حتى اللحظة الأخيرة من حياته. وهو شقيق الشهيد الأنصاري ناظم مصطاف (ملازم سامي)، الذي ارتقى شهيدًا في معارك قوات الأنصار في جبال كردستان، في واحدة من أشرف صفحات النضال الوطني.
والفقيد والد كلٍّ من بهاء وصفاء وعلاء وإيهاب. وقد ترك في نفوس محبيه وأصدقائه أثرًا طيبًا وذكريات لا تُنسى.
له الذكر الطيب، ولعائلته ورفاقه الصبر والسلوان.
- بمزيد من الحزن والأسى تتقدم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في واسط، بالتعازي إلى الرفيق علي محسن، بوفاة والدته.
للفقيدة الذكر الطيب على الدوام، ولعائلتها الصبر والسلوان.
- تعزي اللجنة الأساسية للحزب الشيوعي العراقي في قضاء الصويرة صديق الحزب احمد ابو سامان، بوفاة ولده.
للفقيد الذكر الطيب ولذويه الصبر والسلوان.
******************************************
الصفحة السادسة
موسكو تحذر من التدخل الأمريكي وألمانيا تشعر بالامتنان! العدوان الصهيوني يتواصل على الشعب الإيراني
متابعة – طريق الشعب
واصلت إيران شن هجمات صاروخية على إسرائيل، مخلفة أضراراً ما دية وبشرية كبيرة، فيما استهدفت طيران الاحتلال الإسرائيلي العاصمة الإيرانية طهران، وتبادل الطرفان تحذيرات لسكان منطقتين في طهران وتل أبيب.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية، أن "30 صاروخاً سقطت على مناطق مختلفة وسط إسرائيل منذ منتصف ليلة الثلاثاء"، فيما قال جيش الاحتلال، أمس، إن "أكثر من 50 طائرة حربية شنت خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على إيران".
طهران لن تستسلم
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أمس الأربعاء، إن بلاده "لن تستسلم أبدا أمام الضغوط وحذر من أضرار لا يمكن إصلاحها في حال التدخل الأميركي.
وقال في كلمة متلفزة أن "إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا، وستعاقب على ذلك"، وأضاف "عليهم أن يعلموا أن إيران لن تستسلم وأن أي هجوم أميركي سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها". في إشارة إلى إمكانية التدخل الأمريكي في العدوان على الشعب الايراني
وفي تطورات العدوان، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس، أن حالة المنشآت النووية في بلاده "جيدة". وأفاد بتعرض منشأة فوردو النووية إلى أضرار طفيفة دون أي تلوث اشعاعي، فيما حدث تلوث إشعاعي داخل منشأة نطنز ولم يتنشر خارجها بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي.
تحذير من الدعم الامريكي
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمه، الثلاثاء، أن التقديرات في تل أبيب تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينضم إلى الهجمات على إيران. وتابع أن "ترامب سيرغب في أن يُذكر كشخص شارك، ولم يقف على الحياد".
واعتبر المسؤول الذي لم يشأ الكشف عن اسمه، أنه "إذا لم تنضم إلينا الولايات المتحدة فلن نتمكن سوى من إلحاق ضرر محدود بمنشأة فوردو النووية". وحسب هيئة البث، فإن "تغيّر نهج ترامب قد يشير إلى نيّته الانضمام للهجوم على إيران".
والثلاثاء، قال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": على إيران "الاستسلام غير المشروط"، و"ليس لدي رغبة في المفاوضات مع إيران".
وفي السياق، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الاربعاء، من "أن المساعدة العسكرية الأمريكية المباشرة لإسرائيل ربما تزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري".
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إن "روسيا تحذر الولايات المتحدة من تقديم مثل هذه المساعدة لإسرائيل، أو حتى التفكير في تقديمها". وأضاف أن "موسكو على اتصال بكل من إسرائيل وإيران".
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن إعصار يجتاح العاصمة الإيرانية طهران، معتبرا أن من خلال هذا المسار يتم سقوط الديكتاتوريات.
وتابع كاتس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": أن "إعصار يجتاح طهران. يتم قصف رموز القوة وتنهار، وقريبا أهداف أخرى، مع فرار أعداد غفيرة من السكان. هكذا يتم سقوط الديكتاتوريات".
وأضاف: "يجب أن يتذكر المصير الذي حل بديكتاتور جارة إيران (العراق) الذي تعامل بهذا الأسلوب ضد إسرائيل".
نقص في الصواريخ الاعتراضية
وتشير التقديرات إلى وجود معاناة في الجانب الإسرائيلي يتمثل في نقص في الصواريخ الاعتراضية الدفاعية، وفقاً مسؤول أميركي في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال". وذلك في ظل استمرار إطلاق الصواريخ الإيرانية ووصولها إلى إسرائيلي.
وفي هذا الشأن، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن "إيران تعتمد في ردها على الهجوم الإسرائيلي على كثافة الصواريخ ونوعيتها بهدف إنهاك منظومات الدفاع الإسرائيلية التي تعجز عن حماية المدن بشكل كامل".
وقال العميد جوني إن" الصواريخ الإيرانية تساقطت بشكل مؤثر وفاعل وحققت إلى حد كبير توازنا مع الهجمات الإسرائيلية على إيران".
ومن أسباب إنهاك وضعف المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية أيضا أنه يتم تشغيلها -ولليوم السادس من الحرب- بشكل مكثف ومتواصل وعلى مساحة إسرائيل لتأمين حد أدنى من الحماية، وقد رجح العميد جوني أن يتواصل إنهاك المنظومات الدفاعية الإسرائيلية مع استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية، لكنه لم يستبعد أن يقدم حلفاء إسرائيل وأولها الولايات المتحدة دعما لها بهذا المجال.
ممتن للعدوان!
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن إسرائيل تقوم حاليا بالعمل القذر نيابة عن الغرب بأكمله، وأشار إلى أنه ممتن للإجراءات الإسرائيلية ضد إيران.
وعبر ميرتس عن احترامه لجيش الاحتلال! وقيادته لإقدامهم في العدوان على الشعب الإيراني وقال: "لولا ذلك، ربما كنا سنشهد رعب هذا النظام لشهور وسنوات، وربما بعد ذلك مع وجود سلاح نووي بين أيدينا".
وأشار ميرتس إلى أن عودة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، يعني أنه "لن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التدخلات العسكرية".
وتابع "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قد يكون على جدول الأعمال"، وعبر عن اعتقاده بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع إنهاء تلك المهمة بشكل كامل "لأنه يفتقر إلى الأسلحة الضرورية، لكن الأميركيين يمتلكونها".
فيما نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، تأكيده أن ألمانيا أوضحت لإيران أنه "لم يفت بعد أوان الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان دافيد فاديفول، إن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يهدد بجر دول أخرى إلى النزاع.
*****************************************
غزة.. مجازر جديدة بحق المجوّعين
متابعة – طريق الشعب
أفادت مستشفيات غزة باستشهاد 32 فلسطينيا في قصف إسرائيلي موسع على قطاع غزة منذ فجر أمس الاربعاء، بينهم 11 من منتظري المساعدات.
ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخياما تؤوي نازحين وتجمعات لمواطنين، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في مدن شمال ووسط وجنوب القطاع.
عودة قافلة الصمد
أعلنت قافلة الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة، أمس، مغادرتها ليبيا والعودة إلى تونس، بعد إطلاق سراح آخر شخص من أعضاء القافلة، والذين تم توقيفهم من قبل الحكومة.
وقال نبيل الشنوفي، في حديث صحفي، "إنهم في طريق العودة إلى تونس". وأضاف: "انطلقنا من مدينة زليتن الليبية عائدين إلى تونس، بعد "إفراج سلطات شرق ليبيا عن آخر الموقوفين من المشاركين في القافلة".
والثلاثاء، شددت القافلة في بيان "أنها لن ترجع من ليبيا إلى تونس إلا مع عودة كل الموقفين من ناشطي القافلة"، لافتة إلى أن سلطات شرق ليبيا كانت تحتجز 3 ليبيين لديها، حتى يوم أمس.
مناطق الأمان تتقلص
وفي كارثة إنسانية جديدة تتكشف فصولها تحت جنح الظلام، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقليص مساحة منطقة المواصي التي سبق أن حددها كمنطقة آمنة لنزوح سكان جنوب قطاع غزة وأجزاء من شماله.
وبينما يعيش مئات آلاف الفلسطينيين في ظروف صعبة داخل المواصي، جاء هذا القرار ليزيد من معاناتهم، إذ طُلب من عدد كبير منهم النزوح مجددا نحو مناطق غرب رفح، وسط انعدام مقومات الحياة.
ويتواصل تصعيد الاحتلال بإصدار إنذارات متكررة بإخلاء أحياء في خان يونس، كان أحدثها مساء الثلاثاء، حين قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "إلى كل الموجودين في أحياء الجلاء، مدينة حمد، والقرارة 5 و6.. الإخلاء فورا إلى منطقة المواصي".
وأضاف أدرعي أن الجيش سيعمل بقوة شديدة في تلك المناطق لتدمير قدرات الفصائل الفلسطينية، وفق ادعائه.
*****************************************
دعوة أممية لإنقاذ اتفاق السلام في جنوب السودان
جوبا – وكالات
حذرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن "اتفاق السلام المجدد في جنوب السودان لعام 2018 يواجه تهديدات كبيرة بسبب تصاعد الهجمات العسكرية والعمليات القمعية التي يقوم بها النظام، إضافة إلى وجود القوات العسكرية الأجنبية في البلاد".
وأكدت اللجنة أن "الوضع في جنوب السودان يهدد بتفكيك الاتفاق بشكل كامل، مما يعمق الانقسام ويزيد من حدة العنف".
وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، في بيان، إن "العنف المتزايد يدفع اتفاق السلام إلى حافة الانهيار، مشيرة إلى أن أي انهيار لهذا الاتفاق قد يؤدي إلى تفتيت البلاد بشكل أكبر".
ودعت الأطراف الإقليمية وخصوصاً الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية لمعنية بالتنمية (إيغاد) إلى تكثيف الضغط على قادة جنوب السودان لوقف التصعيد العسكري وتطبيق الاتفاق بشكل كامل.
****************************************
حزب الشعب الفلسطيني: الاحتلال يستغل التوترات ويمعن في حرب الإبادة
القدس – طريق الشعب
حذر حزب الشعب الفلسطيني، من استغلال الاحتلال الإسرائيلي حربه العدوانية على الشعب الإيرانية، لإطالة أمد الإبادة بحق الشعب الفلسطيني والمضي في خطط تهجيره.
وقال الحزب في بيان، حصلت "طريق الشعب" على نسخة منه، "بينما يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة على شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، يتعمد هذا الاحتلال بكل منظومته الفاشية، باستغلال التوترات الإقليمية التي يتسبب بها وحربه العدوانية على إيران، للإمعان في جرائمه وتنفيذ مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية، مستغلاَ تركيز الاهتمام الدولي على الصراع العسكري مع إيران وخطر نشوب حرب إقليمية واسعة".
وحذر الحزب من خطورة استمرار صرف الأنظار واهتمام العالم عن حرب الإبادة، وتنفيذ المخططات الاستعمارية وجرائم التطهير العرقي وخلق وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في الأراضي الفلسطينية، كما حذر من خطر "تراجع مكانة القضية الفلسطينية"
ودعا الحزب القوى السياسية الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى مواصلة وتكثيف الحراك على كافة المستويات من أجل كسر الجمود المتنامي حيال العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية، وجدد البيان إدانة العدوان العسكري على الشعب الإيراني، مؤكداً انه "حلقة من حلقات العربدة والغطرسة العسكرية الأمريكية -الإسرائيلية ضد الشعوب المنطقة وسيادة دولها، واستمراراَ لمساعي الهيمنة الامبريالية عليها".
**************************************
قمة مجموعة السبع.. اتفقت على دعم إسرائيل وانتهت بدون نتائج ملموسة
رشيد غويلب
انعقدت قمة مجموعة السبع، التي استضافتها جبال روكي الكندية في ألبرتا، كاناناسكيس غربي كندا، في الفترة من 15 إلى 17 حزيران 2025.
لقد أسفرت قمة مجموعة السبع في كندا عن نتيجة ملموسة لا علاقة لها بالقمة: وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاقية لخفض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرًا على الواردات من المملكة المتحدة.
ما الذي دفع ترامب لإبرام الاتفاقية؟ الجواب يكمن في تعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي، لمنعها من العودة إلى فلك الاتحاد الأوروبي، الذي لديه مشاكل في التبادل التجاري مع أمريكا ترامب. لقد نقلت تقارير صحفية قول ترامب إنه وقَّع الاتفاقية مع البريطانيين "لأنني أحبهم"، وفي الوقت نفسه همس بأنه سعيد جدًا بالاتفاقية الجديدة "مع الاتحاد الأوروبي".
دعم غير مشروط لإسرائيل
لم يتفق رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا العظمى، واليابان إلا على أمر واحد: بيان حول "التطورات الأخيرة بين إسرائيل وإيران". وفيما يتعلق بهذه "التطورات" - بينما يتحدث آخرون عن حرب عدوانية تنتهك القانون الدولي - جاء البيان في ثماني جمل موجزة فقط، مؤكدين "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ومؤكدين دعمهم "لأمن إسرائيل". وأعربوا عن اعتقادهم بأن "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب الإقليمي" هو إيران، ولطالما أوضحوا "أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا". وأعقب ذلك إشارة عابرة إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ربما لا يكون أمرًا سيئًا، قبل أن تُعرب الجملة الأخيرة، الأطول نوعًا ما، عن قلق بالغ بشأن "أسواق الطاقة الدولية". ويبدو أن المسودة الأصلية احتوت على المزيد، لأن ترامب رفضها. ولم يوافق عليها إلا بعد حذف بعض العبارات التي لم يكن محتواها معروفًا.
في مواجهة الصين
كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي ترأس الاجتماع بسبب رئاسة كندا لمجموعة السبع، قد قرر منذ البداية، وخلافًا لما هو معتاد، عدم إعداد وثيقة ختامية للقمة. ونظرًا للخلاف بين دول المجموعة، أعد سلسلة من الموضوعات التي قد يمكن الاتفاق عليها، وبالتالي عكس شيئًا من الوحدة بين بلدان المجموعة. كانت إحدى هذه الموضوعات تتعلق بالمواد الخام النادرة، وهي موجهة بشكل أساسي ضد الصين، مما جعل كارني يعتقد بأن ترامب سيكون راضيًا عنها. وجوهر النص هو تطوير استراتيجية مشتركة في ضوء هيمنة الصين على السوق، وخاصة في المعادن النادرة، من أجل ضمان الإمدادات المستقبلية للشركات الغربية من مصادر أخرى. وعندما غادر ترامب مساء الاثنين مكان الاجتماع، عائدًا إلى البيت الأبيض، لم يكن قد وقَّع على أي نص مقترح.
حرب أوكرانيا
نشأ الخلاف المتوقع حول الحرب في أوكرانيا. لم يُرحب ترامب بتأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المبالغ فيه بشأن حزمة العقوبات الثامنة عشرة للاتحاد الأوروبي ومحاولتها الضغط عليه للموافقة على خفض سقف أسعار النفط الروسي. واشتكى الرئيس الأمريكي من أن العقوبات كلفت الولايات المتحدة مليارات الدولارات. واعتبر ترامب استبعاد روسيا من مجموعة الثماني، التي كانت لا تزال قائمة آنذاك "خطأ فادحًا". وقال ترامب إنه لو كان الأمر بيده، لكانت روسيا لا تزال عضوًا في مجموعة الثماني، ولما اندلعت حرب في أوكرانيا. لكان "العدو" موجودًا "على الطاولة" على الأقل. ومع ذلك، لم يكن متأكدًا على الإطلاق مما إذا كانت روسيا "عدوًا آنذاك". لا بد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعاه كارني كضيف، كان يغلي غضبًا في داخله. وبعد ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعلن الثلاثاء، عن عقوبات جديدة ضد روسيا.
بالإضافة إلى زيلينسكي، دعا كارني أربعة رؤساء دول وحكومات من خارج دول مجموعة السبع: رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وهذه المرة، على الأقل، لم يضطر رامافوزا إلى الاستماع إلى اتهامات سخيفة أو مشاهدة مقاطع فيديو تحتوي على أدلة ملفقة على "إبادة جماعية" مزعومة ضد البيض في جنوب أفريقيا، كما جرى مؤخرًا في البيت الأبيض.
سخر ترامب من تفسير الرئيس الفرنسي لعودته المفاجئة إلى البيت الأبيض، بكونها مرتبطة بمحاولة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بالقول: إن "ما سيفعله أكبر من ذلك بكثير". وختم قائلًا: "إيمانويل دائمًا ما يخطئ في كل شيء". وسخر من زعماء أوروبا تعليقًا على صورة في أروقة المؤتمر جمعتهم وهم يشربون الماء، "الأوروبيون مغرورون فقط لأنهم شربوا الماء معًا دون أن يمزقوا بعضهم البعض."
*******************************************
الصفحة السابعة
قراءة في جديد المكتبة اليسارية {دراسات ماركسية معاصرة} و {فكّر عالمياً وتصرّف محلياً}
د. إبراهيم إسماعيل
ربما كانت سعادتي متميزة، وأنا أنهمك في قراءة إصدارين جديدين لكاتبين ماركسيين، لا لأني أعرفهما وتعلمت مما كتبوه، ولا لأن نشاطهما الفكري هذا جاء مكملاً لمسارهما النضالي كمثقفين عضويين فحسب، بل ولأهمية الموضوعات التي عالجتها هذه الكتب، في سياق التناقضات المتزايدة التي تعصف بالعالم المعاصر من جهة، ومع تبخر أحلام "أو ربما أوهام" العراقيين، من أن يُفضي سقوط البعثفاشية لقيام بديل ديمقراطي من جهة مكملة، وما تستدعيه تلك المتغيرات من تحليل متجدد للبنية الاقتصادية والاجتماعية للنظام الرأسمالي وتوابعه، وكشف الآليات التي تمكّنه من الإفلات من أزماته الدورية، واستخدام النظرية أداةً للتغيير الثوري عبر فعل نضالي، يحقق تفكيكاً لبنى السيطرة والاستغلال، ومن خلال تبني رؤى بديلة لعالم أكثر عدلاً ومساواة.
كتاب {دراسات ماركسية معاصرة}
وأنا أقرأ هذا الكتاب، للصديق رشيد غويلب، والصادر عن دار البعد الرابع في النجف، تذكرت ما قاله الشاعر العظيم ناظم حكمت، من أن "أجمل الأيام تلك التي لم نعشها بعد وأجمل الزهور تلك التي لم تتفتح بعد وأجمل القصائد تلك التي لم تُكتب بعد"، إذ شعرت بأن أعمق وأصدق حديث عن الماركسية واليسار، هو الذي لم يرو بعد، لاسيما بعد زلزال التسعينيات الذي أفضى لانهيار تجربة اشتراكية القرن العشرين. وجاء شعوري هذا من متابعتي لحجم المرارة التي غشيت العقول، بعد فشل التجربة السوفيتية في الصمود بوجه العولمة المتوحشة، والإرهاق الذي تعرضت له حركة الفكر في الدول الرأسمالية المتطورة، والتراجع المؤلم أمام اللوثيان القومي والديني في دول حركة التحرر الوطني، وما فرضه اتساع تلك الغشاوة من ضرورة اعترافٍ شجاعٍ بالأخطاء والخطايا، وتقييم نزيه، لما تقادم من الفكرة بحثاً عن بدائل حيًة له، أو لما بقي منها، يتدفق نبضاً ويهدي قدماً السائرين.
ويأتي الكتاب شاهداً على ذلك، فقد نجح الباحث رشيد غويلب، والمعروف بتفاؤله الثوري وتعامله النقدي مع الواقع الاجتماعي، في التقاط مجموعة من الدراسات والأبحاث المنشورة في لغات أجنبية، فترجمها إلى العربية وأعدّها واضحة للقراء، ليس على أساس أسماء المفكرين الذين عالجوا مشكلات راهنة برؤية نقدية ثورية، تُساءل ماركس الكلاسيكي وتبث فيه روحاً معاصرة فحسب، بل وأيضاً بناءً على الموضوعات التي بحثوها وأدوات التحليل الماركسي التي دأبوا على تطويرها، وذلك بغية الكشف عن العرى التي لا تنفصم بين اليسار المعاصر وبين القيم الانسانية النبيلة، وتحديد الأبعاد التي يعبّر بها هذا اليسار عن العدالة والحرية في زمن الخراب، والتي لم تعّد تنحصر في الاقتصاد فقط، بل وباتت تشمل القيم الثقافة والروحية ومعطيات التاريخ والجغرافية وغيرها.
وصار الكتاب بهذا مصدراً مهمًا لمن يرغب في متابعة تطور الفكر الماركسي في القرن الحادي والعشرين، ومفتتحاً يحفّز النقد والتحليل الذين يثريان النقاش الفكري والسياسي، ليس لتفعيل المشروع الماركسي فقط، بل ولتحديثه وتفكيكه وإعادة بنائه، وقبل هذا وذاك لإعادة قراءته في ضوء التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة، كأزمة الرأسمالية المتأخرة والانعكاسات الاجتماعية للنيوليبرالية، وتحولات الطبقة العاملة وانفصالها الجزئي عن الدور الثوري الكلاسيكي، والهيمنة الإمبريالية في عصر العولمة والإنتقال لما بات يصطلح عليه بالإقطاع التقني.
ونجح الصديق رشيد غويلب في تبويب الكتاب، حين قسّم موضوعاته إلى خمسة أقسام، ضّم الأول منها دراسات معاصرة حول لينين، المصدر الملهم الأبرز لتجديد الماركسية، حسب تعبير جورج لوكاتش، وذلك من أجل تفكيك تراثه الفكري وإعادة قراءته كأعظم قائد ومنظر استراتیجي وتكتیكي ماركسي في القرن العشرین، وإستلهام جوهر ذلك التراث في النضال الطبقي الراهن، وبعيداً عن "اللينينية" التي أراد بعض تلامذته استخدامها تعويذة لتحصين خيباتهم وأخطائهم، وهو ما تجلى في أبيات بريخت عنه حين قال (أنتم يا من تجعلون صورة إیلیتش ثابتة، عشرون مترا في قصر النقابات، لا تنسوا ثقب حذائه أیضاً، ذلك الذي شھده الكثیرون، شارة الفقر، یتھادى إلى سمعي، أنه یشیر إلى الغرب، حیث یعیش الكثیرون، الذین یعرفون من حذائه، أن إیلیتش واحد منھم).
في القسم الثاني، اختار الكاتب أربعة موضوعات عن القائدة الشيوعية الفذة روزا لوكسمبورغ، تمحورت حول أبرز معالم تراثها النظري وقدراتها في المتابعة النقدية للفكر والممارسة وفي استشراف المستقبل. وجاءت الموضوعات لترينا آراء روزا بثورة أكتوبر وقضية التحالف بين البروليتاريا والفلاحين والديمقراطية الاشتراكية والتحرر والعدالة والتطور الرأسمالي. ورغم تقادم بعض تلك الأراء اليوم، بفعل التطور التاريخي، فإن لروزا الكثير مما يمكنها أن تنصح به اليسار المعاصر.
وخصص الكاتب القسم الثالث لموضوعات عن الحرب والسلام، استمدت أهميتها من الدور الذي لعبه اليسار وما يزال في الدفاع عن السلام ونبذ الحرب، والكفاح العنيد ضد سباق التسلح وتوسيع الأحلاف العسكرية وتبصير الناس بالمخاطر الكبيرة على البلدان التي تنخرط فيها. وبسبب المخاوف الكبيرة من امتداد لهيب الحرب الروسية الأوكرانية لأوربا، وربما للعالم، جاءت الموضوعات لتؤكد على أن الیساریین لا يحددوا طبیعة الحرب على أساس من أشعلها أو یخضعوا للسردیة السائدة حولها، بل على ماھية المصالح السیاسية الطبقية المرجوة من ورائھا، ويعّدون كل حرب إجرامیة إذا لم تكن حرباً دفاعیة صریحة. وأشارت بعض الكتابات إلى المواقف الماركسية التي تبنتها أطياف اليسار ولاسيما الأوربية منها، من الحرب ومخاطرها اليوم.
في القسم الرابع جمع الكاتب ثلاثة عشر موضوعاً تتعلق بحركة اليسار العالمية اليوم ومعالم التجديد التي باتت تتسم به وأبرز اخفاقاتها ونجاحاتها. وشمل ذلك ما يسمى بالمد الوردي في أمریكا اللاتینیة، في البرازيل وتشيلي وكولومبيا والسلفادور وبيرو وغيرها، ونمو نفوذ أشباه البرولیتاریا وتأثيرهم على الحراك الاجتماعي، وأبرز ما تطرحه المرحلة من أسئلة طبقية، وطبیعة الحركة الاجتماعیة التحرریة المضادة للرأسمالیة، والتحدیات التي تواجه الیسار، وطبيعة النسوية الماركسية، وقضايا العلمانية ودور الدين، إضافة إلى قراءات في تراث أنجلس وغرامشي ولوكاتش.
وكانت موضوعات القسم الخامس المتعلقة بالرأسمالية والاشتراكية اليوم، مكملة للأقسام السابقة من خلال ما قدمته من تصورات معاصرة عن أكبر قضايا التاريخ حيوية وارتباطاً بمستقبل البشر. ولهذا جاء القسم السادس والأخير والذي ضّم مواضيع تتعلق بالفاشية الجديدة والاستبداد اليميني الرجعي، والنمو الدراماتيكي له في العالم وخاصة في الدول الأمبريالية، ليشير للمخاطر الهائلة التي تهدد هذا المستقبل، والمسؤوليات التاريخية التي تقع على عاتق اليسار لمواجهة هذه المخاطر ووأدها، كما سبق له وفعل ذلك قبل ثمانية عقود. فإلى جانب استعراض استراتيجية اليسار الفرنسي والجبهة الشعبية واليسار الإيطالي لمواجهة الفاشية الصاعدة في هذين البلدين، جاء النص التاريخي الذي كتبته المناضلة الشيوعية الألمانية المعروفة عالميا كلارا زيتكن، قبل 100 عام، ليضع علامات مضيئة أمام يسار اليوم في صراعه مع الفاشية الجديدة، لاسيما بتحذيرها من أن الفاشيين يمكنهم أيضًا حشد الجماهير في ألمانيا والوصول إلى السلطة، خاصة وإن الفاشية مازالت تمثل حتى بنسختها الجديدة، العدو الأقوى والأكثر شراسة للبروليتاريا، وأن هزيمتها تشكل ضرورة أساسية، لا بسبب ترابط ذلك مع الوجود التاريخي للبروليتاريا، كطبقة يجب أن تحرر البشرية من خلال التغلب على الرأسمالية، بل وأيضاً لأن الانتصار عليها يرتبط بالخبز وظروف العمل ونمط حياة ملايين وملايين المستغَلين.
وختاماً، لا بد من كلمة إمتنان وتقدير للصديق الكاتب رشيد غويلب على جهده المتميز، كما أني موقن من أن كثيراً من قراء الكتاب سيشاطرونني هذه المشاعر.
كتاب {فكر عالميا ً وتصرّف محلياً}
لعل أول من استخدم هذه العبارة كان ديفيد بروير مؤسس أصدقاء الأرض، كشعار لمؤسسته العام 1971، وهناك من ينسبها إلى رينيه دوبوس أو فرانك فيذر الكندي أو عالم اللاهوت الفرنسي جاك إلو، حيث أراد الجميع تجاوز الأطر الضيقة للهوية والمكان، والانفتاح على وعي أممي مع الحفاظ على جذور الفعل الميداني المحلي.
وكان الصديق الباحث فرحان قاسم على حق تماماً حين أطلق العبارة على إصداره الجديد، عن دار جلجامش في بغداد، إذ يستغرق بجميع صفحاته التي زادت عن المائتين، في البحث عن ممارسة يسارية ترتكز على المنهج العلمي وعلى مشتركات اليسار عالمياً ووطنياً، وتستفيد من تراثه الغني لتحفيز أجياله الجديدة على التخلص من تشتتها وتشظي أساليب نضالها، وتبني رؤية مشتركة في مواجهة سيل التحديات التي تجابهها في صراعها مع الرأسمالية، سواء على الصعيد الفكري أو في الممارسة النضالية اليومية، ومن ثم ربط كل هذا العام بخصوصية المجتمعات التي تعيشها حركة اليسار في كل بلاد على حدة، بكل تاريخها وثقافتها وتركيبتها الاجتماعية ومعالم الصراع الطبقي الذي يعتمل فيها.
ضّم الكتاب سبعة فصول، اختص الأول بالنظرية السياسية بشكل عام، تعريفها، وخصوصية النسخة الماركسية لها والتي أُدخل عليها مفهوم "الدولة ومؤسساتها وقضايا الصراع الطبقي والثورة ونمط التنظيم والاستراتيج والتكتيك"، المتعلقة بقضية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، متوصلاً إلى تعريف يقول بأن "النظرية السياسية هي مجموع النظريات والآراء والتكتيكات والأساليب والآليات التي تستخدمها الطبقات المهيمنة على السلطة لتأبيد سيطرتها على المجتمع بكافة طبقاته وفئاته وشرائحه". وهي بهذا تتخذ ستة أشكال، نظرية الديمقراطية الليبرالية، ونظرية العقد الاجتماعي، والنظرية الماركسية، والنظرية الفوضوية، والنظرية النسوية، والنظرية البيئية.
في الفصل الثاني تمت مناقشة نظرية الرأسمالية السياسية في الممارسة، والأساليب التي تعتمدها لتثبيت أركان هيمنتها: كالنظام الدولي الكلاسيكي والمعاصر، وتبعية دولة أو دول لغيرها من القوى المهيمنة عالمياً، وتأجيج سباق التسلح على حساب التنمية الاجتماعية، والحروب كأداة لتحقيق اهداف رأس المال في توسيع الأسواق والموارد والأرباح، والفتوحات والإكتشافات الجغرافية، وتطوير قوى الإنتاج لمضاعفة فائض القيمة، وإطلاق أكبر حملات للخداع الأيدولوجي والحرب الثقافية والدعائية، وتشجيع التخادم مع الفاشية كسيف قمع وتضليل، وتبني الهجرة لتوفير قوة عمل رخيصة، وتشديد الهيمنة على دول الأطراف عبر القروض، وأخيراً تكييف القانون والشرعية الدولية ومنظماتهما الأممية لخدمة الهيمنة الإمبريالية.
وقدم الكاتب مناقشة متميزة في الفصلين الثالث والرابع لممارسة اليسار والتحديات المعاصرة التي تواجهه ونظرية الرأسمالية السياسية في الممارسة وأثر المنظرين الماركسيين، مثل لينين وروزا لوكسمبورغ و غرامشي ومدرسة فرانكفورت وجورج لوكاتش وغيرهم، على مستوى التنظير المجرد وعلى مستوى الممارسة، وبالتزامن مع مراحل تطور الرأسمالية، مشدداً على تغير طبيعة الصراع الطبقي داخل المجتمعات الصناعية وبينها وبين مجتمعات الدول التابعة، ومؤكداً على أن الرأسمالية لم تعد تُدار ضمن حدود الدول، بل باتت تنتج أزماتها وتعزز سيطرتها عبر سلاسل إنتاج عالمية، وأدوات مالية عابرة للحدود، وإيديولوجيات ذات طابع كوني. وفي هذا السياق، يغدو من غير المجدي – بل من غير الممكن – خوض صراع طبقي فعال دون رؤية عالمية، تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الاقتصاد المعولم، واستراتيجيات الشركات الكبرى، وأدوار الدول التابعة.
وفي سياق التحديات التي تواجه اليسار المعاصر، أشار الكاتب لمجموعة منها، تحديد المفاهيم كالرأسمالية والاشتراكية والموقف من الرقمنة والديمقراطية والليبرالية والطبقة الوسطى. كما وجد بأن مما يواجه اليسار أيضاً، مهام رسم السياسات المناسبة فيما يتعلق بالعولمة الاقتصادية والعمالة الرخيصة والسيادة الوطنية وخراب البيئة ومحاولات محو الخصائص الثقافية.
واستعرض الباحث نسخ اليسار التقليدية القديمة وأطيافه المعاصرة والمتجددة، متوصلاً للإقرار بوجود صعوبة في تحديد تعريف لليسار، جراء تعدد المعايير وتغير المواقع في أوقات زمنية أو الانتقال من ضفة لأخرى في منعطفات صارخة أو غائمة، مشيراً إلى أن مفهوم اليسار اليوم بات يغطي طيفاً واسعاً من الآراء كالأحزاب الشيوعية والاشتراكية الديمقراطية والحركات الاجتماعية والراديكالية وأنصار البيئة والحركات النسوية وبعض منظمات المجتمع المدني. وبالتأكيد، خلق هذا المفهوم الواسع صعوبات جمة في رسم نظرية سياسية تساعد اليسار على توحيد أهدافه وأشكال كفاحه.
وبعد أن خلص الكاتب إلى أن ما يميّز اليسار عن غيره، يكمن في التزامه بهدف تجاوز الرأسمالية عبر تشريك الاقتصاد والتنظيم الديمقراطي للمجتمع وتحقيق المساواة والإدارة الاجتماعية، اي بناء الاشتراكية، طرح جملة من الأفكار التي يمكن أن يتبناها اليسار اليوم في مواجهة حالات الإحباط التي تعاني منه بعض أطيافه، وضبابية المعالجات التي تتبناها، محدداً مجموعة من القضايا ذات العلاقة بمستلزمات نظرية الممارسة، كتكثيف الحوارات بين ممثلي حركات اليسار وتخليص هذه الحركات من نخبويتها وتبني استراتيجية عولمة الديمقراطية والعمل على تحرير بلدان الأطراف من التبعية إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تطرق الكتاب إلى أهمية اختراق المؤسسات الأيديولوجية البرجوازية وتوسيع الحراك الشعبي وتمتين العلاقة مع الحركات الاجتماعية، سواء ذات الأهداف الكونية أو المرحلية أو المحددة، والتمسك بالاشتراكية هدفاً بغض النظر عن سبل الوصول اليها. واختتم الباحث كتابه بالدعوة إلى عولمة التضامن وتحديد مهمتين متوازيتين لأطياف اليسار المختلفة، تتمثلان في خلق مؤسسات أيديولجية خاصة بها لمواجهة الرأسمالية واختراق المؤسسات الأيديولوجية البرجوازية وتوظيفها أو بعضها لصالح المشروع اليساري.
ورغم أن الكتاب قد أكد مراراً على إن أي نسخة من هذا المشروع، لا يمكن أن ترى النور إذا ما ظلت معلقًة في سماء التحليل النظري، ولم تتجذر في حياة الناس اليومية، في حاجاتهم، وخبراتهم، وأشكال مقاومتهم، بقي هو الآخر بحاجة للمزيد من ربط العالمي بالمحلي والتركيز الأكبر على إعادة صياغة العلاقة بين التحليل النظري الأممي والعمل السياسي المحلي، وللمزيد من التأمل في كيفية تفعيل الماركسية اليوم بوصفها أداة تحليل وممارسة من أجل تجاوز ما يعيشه العراق من خراب، وهذا ما نتطلع اليه في نتاجات الصديق الباحث فرحان قاسم القادمة، موجهين له، نحن القراء الشغوفين، تحية أمتنان وتقدير.
***************************************
الصفحة الثامنة
ولاية كيرالا الهندية ذات الحكم الشيوعي تقضي على الفقر المدقع / اتول تشاندرا
ترجمة واعداد : نادر رضا
بينما تتعمق اللامساواة في أغلب الدول حول العالم، برزت ولاية كيرالا الهندية التي يبلغ عدد سكانها قرابة 33 مليون نسمة ومساحة تقارب مساحة سويسرا كمنارة أمل. ومن المقرر أن تصبح كيرالا أول ولاية في الهند تقضي تمامًا على الفقر المدقع بحلول تشرين الثاني، ٢٠٢٥.
في منطقة غالباً ما تسمع فيها طبول الحرب، خاصة بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، لا يمكن المبالغة في أهمية وقف إطلاق النار المستدام. فبينما تتصدر المناوشات العسكرية والمواقف القومية العناوين الرئيسية، فإنها تحرف الانتباه والموارد الحيوية عن المعارك الحقيقية ضد الفقر والأمية والبطالة والأزمات الصحية العامة. لا تكمن عظمة الأمة في ترسانتها من الأسلحة، بل في رفاهية شعبها. يمكن ان تتيح اتفاقية وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في مايو ٢٠٢٥ فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والتحول من الاهتمام بالنزاعات الحدودية إلى بناء مجتمعات عادلة ومنصفة. وفي هذا السياق، تؤكد الخطوات الرائدة لحكومة ولاية كيرالا في القضاء على الفقر ما يمكن تحقيقه عندما تختار الحكومات الرفاهية بدلاً من الحرب، والاستثمار الاجتماعي بدلاً من الإنفاق العسكري.
في عالم يعاني من تفاوت راسخ، برزت ولاية كيرالا الهندية كمنارة أمل. بحلول نوفمبر 2025، من المقرر أن تصبح كيرالا أول ولاية في الهند تقضي تمامًا على الفقر المدقع، وهو إنجاز أعلنه رئيس الوزراء بيناراي فيجايان بعد نجاح دهرمادام (الدائرة الانتخابية الأولى الخالية من الفقر المدقع في الولاية). هذا الإنجاز ليس مجرد انتصار إحصائي، بل شهادة على عقود من السياسات المستوحاة من الاشتراكية التي أعطت الأولوية للتنمية العادلة والديمقراطية الشعبية والكرامة الإنسانية. تقدم رحلة كيرالا رؤى حاسمة حول كيفية تمكين الاستراتيجيات النظامية القائمة على المجتمع من انتشال الملايين من الحرمان، مما يثبت أن الفقر خيار سياسي وليس واقعًا حتميًا.
يستند نجاح كيرالا إلى منهجها التشاركي الدقيق في تحديد الفقر ومعالجته. فبعد إطلاق "مشروع القضاء على الفقر المدقع" (EPEP) في مايو 2021، وضعت الولاية معيارًا عالميًا في الدقة. وفقًا لـ "المراجعة الاقتصادية" الصادرة عام 2024 عن مجلس تخطيط ولاية كيرالا، بدأت المبادرة بترشيح 118,309 أسرة فقيرة من الأحياء المحلية، تلاها عملية تتحقق في أربع مراحل:
فحص لجان فرعية تابعة للحكم المحلي (LSG)، مقابلات وجهاً لوجه، المصادقة من قبل جمعيات الأحياء (مجالس القرى المحلية)، مراجعة عشوائية بنسبة 20 بالمائة لضمان الدقة.
ركز المسح على أربعة مؤشرات: (نقص الغذاء، الدخل، السكن، والرعاية الصحية)، مع استبعاد الأسر المشمولة بالفعل ببرامج الرعاية الاجتماعية لتجنب الازدواجية.
كشف الإحصاء النهائي عن وجود 64,006 أسرة تعيش في فقر مدقع، 81 بالمائة منها تقيم في المناطق الريفية. سجلت منطقة ملابورام أعلى عدد (8,553 أسرة) بينما سجلت كوتايام أقل عدد (1,071 أسرة). أثرت الأزمات الصحية على أكثر من 40,000 أسرة، بينما عانت 34,523 أسرة من انعدام الأمن الغذائي، و15,091 أسرة تفتقر إلى سكن لائق. وقد وجهت هذه الأرقام عملية وضع خطط مصممة خصيصاً لكل أسرة، تجمع بين الإغاثة الفورية (طرود غذائية، رعاية صحية طارئة) والدعم قصير الأجل (سكن مؤقت، مساعدات توظيف) وحلول طويلة الأمد (تدريب على المهارات، سكن دائم). على سبيل المثال، تلقت الأسر التي تواجه حالات طارئة علاجاً مجانياً عبر مستشفيات كيرالا الحكومية المجددة، بينما حصلت أسر أخرى على فرص للعمل الحر من خلال التعاونيات.
ركائز الإرث الاشتراكي في كيرالا
يستند إطار مكافحة الفقر في كيرالا إلى تاريخ طويل من الإصلاحات الهيكلية التي قادها الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) والجبهة الديمقراطية اليسارية (LDF). وقد أسهمت هذه الإصلاحات في انخفاض كبير في معدلات الفقر بالولاية من 59.79 بالمائة في سبعينيات القرن الماضي إلى 11.03 بالمائة فقط بحلول عام 2011. وقد تحقق هذا التحول من خلال مجموعة من الابتكارات السياسية التي أعادت تشكيل علاقات ملكية الأرض ونظام الحكم، وآليات تقديم الرعاية الاجتماعية، والأدوار الجندرية.
كان الإصلاح الزراعي حجر الزاوية في تقدم كيرالا الاجتماعي، حيث قضى الاصلاح الزراعي على التراتبية الهرمية الإقطاعية الراسخة من خلال منح حقوق ملكية الأرض للمزارعين المستأجرين، وفرض سقوف على حيازات الأراضي، وإعادة توزيع الأراضي الفائضة على العمال الزراعيين المعدمين. وهذه الإجراءات قوضت الهيمنة التقليدية لكبار ملاك الأراضي من الطبقات العليا، وحسّنت بشكل كبير مستويات المعيشة في المناطق الريفية، وعززت القوة التفاوضية للفلاحين والعمال الزراعيين.
أدّت تجربة كيرالا في اللامركزية الإدارية إلى تعميق المشاركة الديمقراطية وتعزيز القدرات المحلية. ومن خلال تفويض صلاحيات مالية وإدارية واسعة لهيئات الحكم المحلي (LSGs)، مكّنت الولاية مجالس البانشايات (مجالس القرى المحلية) من تصميم وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع المحلي. أثبت هذا الهيكل فعاليته الحاسمة خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم إنشاء مطابخ مجتمعية بسرعة وساهم المتطوعون في توصيل الوجبات للمحتاجين. كما ساهمت عملية اللامركزية في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوعي السياسي بين المواطنين، وزيادة المساءلة في تنفيذ السياسات.
يشكِّل التركيز طويل الأمد للولاية على الصحة العامة والتعليم قاعدةً صلبةً للتنمية البشرية. فقد أعادت "مهمة أردرم" (Aardram Mission) التي أُطلقت عام 2017 إحياء مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال دمج خدمات الصحة النفسية والرعاية من الصدمات النفسية، مما جعلها أكثر سهولةً وملاءمةً للمرضى. أما معدل الإلمام بالقراءة والكتابة البالغ 96.2 بالمائة في كيرالا فهو ثمرة عقود من الاستثمار في التعليم الشامل، والتدريب المهني، والمدارس الحكومية، مما أسهم في إيجاد قوى عاملة أكثر وعياً، وأكثر مهارةً، وأفضل صحةً.
كان تمكين المرأة عنصراً أساسياً في نموذج التنمية في كيرالا، لا سيما من خلال برنامج كودومبشري (رفاهية العائلة) الذي أُطلق عام 1998. يضم البرنامج أكثر من 4.5 مليون عضوة، مما يجعله أحد أكبر مبادرات التخفيف من حدة الفقر وتمكين المرأة بقيادة نسائية في العالم. ومن خلال الجمع بين تمويل المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال والزراعة الجماعية والحكم المحلي، مكّن البرنامج مئات الآلاف من النساء من تأمين سبل العيش وتحدي الهياكل الاجتماعية الأبوية.
تكمل هذه الجهود برامج ضمان اجتماعي قوية تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة. فمبادرات مثل "أغاثي راهيثا كيرالا" (كيرلا الخالية من البؤس) توفر شبكة أمان شاملة، تقدم معاشات لكبار السن، وبدلات للإعاقة، ومنحاً دراسية لأطفال المجتمعات المهمشة. تعكس هذه البرامج التزام كيرالا ببناء دولة رفاهية تُعطي الأولوية للشمولية والكرامة والحماية الاجتماعية.
التشابه مع نماذج الاشتراكية الصينية
تحاكي إنجازات كيرالا الحملة الصينية غير المسبوقة للقضاء على الفقر. إذ تلتقي جهود كيرالا المستهدفة للقضاء على الفقر المدقع مع برنامج الصين للتخفيف من حدة الفقر. في حين بدأ المسار الأوسع للصين في الحد من الفقر أواخر سبعينيات القرن العشرين، شهدت الفترة بين 2014 و2020 دفعة حاسمة لإنقاذ الأكثر تهميشاً – أولئك الذين كانوا يعانون من الفقر المطلق - عبر نموذج حوكمة منسق، قائم على البيانات، ومتجذر محلياً. ويجسد مشروع كيرالا للقضاء على الفقر المدقع (EPEP) الذي أُطلق عام 2021 العديد من المبادئ والممارسات المؤسسية نفسها، المتأصلة في قيم التخطيط الاشتراكي، ومسؤولية الدولة، والحوكمة التشاركية.
العنصر الرئيسي المشترك بين النموذجين هو التحديد الدقيق للفقراء. بدأت حملة الصين بمسح وطني ضخم في عام 2014، حدد 89.62 مليون فرد يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وبالمثل، أجرت كيرالا عملية تحقق متعددة المستويات من خلال مؤسسات الحكم المحلي، وجمعيات القرى، ومراجعات اجتماعية لتحديد 64,006 أسرة تعيش في ظروف الفقر المدقع.
يتمثل القاسم المشترك الثاني في التركيز على خطط مكافحة الفقر المخصصة لكل أسرة. في الصين، حصلت كل أسرة محددة على استراتيجية مخصصة تشمل توليد الدخل، التدريب على المهارات، الوصول للرعاية الصحية، الدعم السكني، وفي بعض الحالات الترحيل الطوعي.
تبنت كيرالا نموذجاً ثلاثياً مماثلاً:
- الإغاثة الفورية (مثل الطرود الغذائية والمساعدات الطبية الطارئة)
- الدعم قصير الأجل (السكن المؤقت، المساعدة في التوظيف)
- الحلول طويلة الأمد (السكن الدائم، التدريب المهني، العمل الذاتي عبر التعاونيات)
تميز النموذجان أيضاً بدور قوي لهياكل الحكم المحلي في تقديم الحماية الاجتماعية. في الصين، تم نشر أكثر من 3 ملايين مسؤول وقائد حزبي على المستوى المحلي لتنفيذ ومتابعة جهود القضاء على الفقر على مستوى القرى. أما في كيرالا، فقد أصبحت مؤسسات مثل مجالس القرى المحلية المنتخبة، جنباً إلى جنب مع حركة (العائلة المزدهرة) بقيادة النساء، جهات فاعلة رئيسية في تحديد الاحتياجات، تقديم الخدمات، وضمان المساءلة.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. فعلى الرغم من القضاء على الفقر المدقع، تواجه الصين فجوات الدخل بين المناطق الحضرية والريفية، بينما تعاني كيرالا من ارتفاع تكاليف المعيشة وشيخوخة السكان. كشفت دراسة أجريت عام 2024 من قبل مركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أن ما يقرب من ثلث الأسر الفقيرة جداً انزلقت إلى الفقر بعد صدمات كبرى، مثل وفاة العائل أو حالات الطوارئ الصحية الخطيرة. وأوصت الدراسة بالتعرف الاستباقي على الأسر المعرضة للخطر وإنشاء "صناديق إغاثة الأزمات" على مستويات الحكم المحلي لمنع الانتكاس – وهو تذكير بأن الفقر ظاهرة ديناميكية تتطلب اهتماماً مستمراً.
ما بعد الفقر: إعادة تعريف التنمية
إنجاز كيرالا في القضاء على الفقر المدقع يُرسي الأساس لمواجهة مجموعة أوسع من التحديات الهيكلية التي تزداد صلةً بالجنوب العالمي. هذه التحديات ليست مجرد نتيجة للتقدم التكنولوجي، بل لكيفية اندماج هذه التقنيات في أنظمة اجتماعية واقتصادية غير متكافئة. يقدم التوجه السياسي المتطور في كيرالا رؤى قيمة حول كيفية تبني الدول للابتكار مع إعطاء الأولوية للمساواة والاستدامة والرفاه البشري.
مع بدء تحول الأتمتة والذكاء الاصطناعي في أسواق العمل، تبنت ولاية كيرالا في الهند موقفًا استباقيًا. بدلًا من مقاومة التغيير التكنولوجي، تستثمر الولاية في قطاعات ناشئة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. على سبيل المثال، تهدف مبادرة "شبكة كيرالا للألياف البصرية" (KFON) إلى توفير إنترنت عالي السرعة مجانًا أو بأسعار معقولة للمجتمعات المحرومة، مما يُسهل الشمول الرقمي ويفتح فرص عمل جديدة. في الوقت نفسه، تعزز الولاية حماية العاملين في اقتصاد المنصات، بما في ذلك إنشاء مجالس رعاية اجتماعية للعاملين المستقلين مثل سائقي السيارات وموظفي التوصيل. هذه المبادرات تتردد فيها عناصر من استراتيجية الصين "الازدهار المشترك"، التي تشمل جهودًا لتنظيم عمالقة التكنولوجيا والحد من عدم المساواة في الثروة عبر الضرائب وإعادة التوزيع.
يستند التزام كيرالا بالتنمية المستدامة إلى نموذجها للحوكمة اللامركزية. من خلال تعزيز سلطات "بانشايات" (المجالس المحلية) والحكومات الذاتية المحلية، تضمن الولاية أن تكون التنمية تشاركية وملائمة للسياق المحلي. على سبيل المثال، تدمج "مهمة هاريثا كيرالا" حماية البيئة في التخطيط المحلي من خلال تشجيع تجميع مياه الأمطار، والزراعة العضوية، وإدارة النفايات على مستوى المجتمع. هذا النهج يتوافق مع استراتيجية الصين لإحياء الريف، التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية وبرامج الإرشاد الزراعي والاستثمار في البنية التحتية لسد الفجوات بين الريف والحضر معًا، تؤكد هذه المبادرات التزام كيرالا بنموذج تنموي يضع التنمية كهدف، وليس الإنتاج أو الربح فقط. ومن خلال الجمع بين العدالة الاقتصادية والاستدامة البيئية والكرامة الإنسانية، تشق الولاية طريقًا يتحدى المقاييس الرأسمالية التقليدية للنجاح. هذا النهج يشير إلى إمكانية إعادة توجيه التنمية نحو الصالح العام، والملكية الاجتماعية، والحوكمة التشاركية – مبادئ يتردد صداها عبر سياقات متنوعة في دول الجنوب العالمي التي تسعى لمستقبل أكثر إنسانية وشمولاً.
*************************************
الأحزاب الطائفية واختطاف الديمقراطية في السودان: من الولاء الموروث إلى أدلجة المؤسسة العسكرية وتفكيك الدولة
ضياء الدين محمد أحمد
تمهيد:
منذ فجر الاستقلال، لم تعرف الديمقراطية السودانية طريقًا مستقيمًا. فقد تم اختطافها مبكرًا من قبل تحالف بنيوي جمع بين الاستعمار، والطائفية، والبرجوازية الصغيرة النفعية، والمؤسسة العسكرية. ولم تكن الأحزاب الكبرى مثل "الأمة" و"الاتحادي الديمقراطي" تعبيرًا عن قوى اجتماعية صاعدة ذات مشروع وطني، بل كانت امتدادًا لزعامات دينية ما قبل حداثية، تحالفت مع الاستعمار وتواطأت مع العسكر، وشكلت غطاءً سياسيًا لاستمرار البنى التقليدية والطبقية، على حساب المأسسة والتحديث.
- مفهوم الحزب السياسي وشروطه:
الحزب السياسي، وفقًا للتعريف الماركسي، هو أداة تنظيم ووعي طبقي، يُعبّر عن مصالح فئة اجتماعية محددة، ويعمل ضمن برنامج معلن، يستند إلى قاعدة جماهيرية. بينما كانت الأحزاب الطائفية تفتقر إلى هذه الشروط، معتمدةً على الولاء الشخصي، والرمزية الدينية، والامتيازات الموروثة.
- الجذور الاستعمارية للطائفية السياسية:
اتبعت الإدارة البريطانية سياسة "فرِّق تسُد" عبر دعم طائفتي الأنصار والختمية.
تم تمكين هذه الزعامات دينيًا وسياسيًا واقتصاديًا في الريف، ما كرّس نفوذها حتى بعد الاستقلال.
تم تحويل المدارس، والأوقاف، والإدارة الأهلية إلى أدوات تعبئة طائفية.
- الطائفية كأداة للهيمنة: من البركة إلى الزعامة السياسية
انتقلت الطائفية من سلطة روحية إلى سلطة سياسية، دون أن تمر عبر شروط الحداثة.
انعدم البرنامج السياسي لصالح الشعارات الغيبية، والولاءات الموروثة.
استخدمت الإدارة الأهلية لتثبيت الحكم المحلي الطائفي، مقابل تقويض المشاركة السياسية الشعبية.
- استغلال الدين في السياسة: صعود الإسلام السياسي من رحم الطائفية
مثّل الإخوان المسلمون تطورًا "أيديولوجيًا" للطائفية التقليدية، مع الحفاظ على ذات البنية الاجتماعية.
تحالف الإسلاميون والطائفيون في لحظات حاسمة لتقويض الديمقراطية، مثل تمرير قوانين الشريعة، أو دعم الأنظمة العسكرية.
أُعيد إنتاج الدين كأداة قمع طبقي، بدل أن يكون مرجعية أخلاقية لتحرر الإنسان.
- العلاقة العضوية بين الأحزاب الطائفية والعسكر:
تورطت هذه الأحزاب في دعم أو السكوت عن كل الانقلابات العسكرية تقريبًا.
في انقلاب عبود 1958، تم حل البرلمان باتفاق بين العسكر والطائفيين.
في انقلاب النميري 1969، استخدم الإسلاميون الشعارات الدينية للتعبئة ضده، ثم تحالفوا معه لاحقًا.
انقلاب البشير 1989 كان ثمرة تخطيط مشترك بين الجبهة الإسلامية، وبعض مراكز القوى
- من البنية الطائفية إلى أدلجة المؤسسة العسكرية: العسكر كحارس للهيمنة الطبقية
لم يكن دعم الأحزاب الطائفية للعسكر مجرد تكتيك سياسي، بل هو تعبير عن وحدة مصالح مادية وأيديولوجية. فالمؤسسة العسكرية، منذ تأسيسها، كانت جزءًا من مشروع الهيمنة، تنحاز دومًا لحماية الامتيازات الطبقية التي تجسدها الطائفية والبرجوازية الصغيرة الطفيلية.
تم إفراغ الدولة من مضامينها التنموية والاجتماعية، وتحويلها إلى جهاز أمني–بيروقراطي لحماية النظام القائم.
تَغذّت المؤسسة العسكرية على الريع، والتحويلات، والتدخلات الأجنبية، مما رسّخ تبعيتها البنيوية لمصالح النُخب الطائفية ورأس المال العالمي.
تمت أدلجة المؤسسة العسكرية عبر خطاب قومي- ديني يُجرّم الاحتجاجات الشعبية، ويُحرم التنظيم النقابي، ويُشيطن الوعي الطبقي.
- الطائفية والإسلام السياسي: تناوب على السلطة لا صراع على المشروع.
رغم الخلافات الشكلية، ظل التياران الطائفي والإسلاموي يتناوبان الأدوار في خنق أي أفق ديمقراطي حقيقي.
ففي جوهرهما، يتفقان على:
رفض بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة والمؤسسية.
استخدام الدين كوسيلة للشرعنة لا للتحرر.
إقصاء القوى الثورية، والعمال، والمهمشين من الفعل السياسي.
انقلاب 1989 لم يكن قطيعة، بل ذروة منطق التحالف، حيث وفّرت الطائفية الغطاء الاجتماعي، وقدّمت الجبهة الإسلامية "الأيديولوجيا القمعية" والأدوات التنظيمية للدولة الأمنية.
- تفكيك الدولة وترييف المركز: الطائفية كضد للحداثة والديمقراطية
قادت هذه التركيبة إلى إعادة إنتاج دولة فاشلة:
تم ترييف المركز سياسيًا واجتماعيًا لصالح شبكات الولاء الطائفي والقبلي.
تفككت مؤسسات الدولة وتحولت إلى أدوات جباية ومحاصصة ومحسوبية.
حوربت النقابات، وتعرضت الجامعات للتجريف، وتم تدمير البنية الصناعية لصالح اقتصاد طفيلي.
النتيجة: غياب أي مشروع وطني للتنمية، وتآكل العقد الاجتماعي، وانفجار الحروب في الأطراف، التي طالما استخدمتها النخب الطائفية والعسكرية كأوراق تفاوض.
- ما بعد الثورة: الثورة المضادة بوجه طائفي-عسكري متجدد
رغم تفجر الوعي الثوري في ديسمبر 2018، أعادت النخب الطائفية والعسكرية تنظيم نفسها:
تم الالتفاف على الثورة عبر شراكة صورية، ضمنت بقاء جهاز الدولة العميقة.
عاد خطاب "الوسطية الطائفية" لتجميل تحالفات قديمة مع الإسلاميين والعسكر.
حُوصرت قوى الثورة الحقيقية، وشُيطنت لجان المقاومة، وتم تجريف المجال السياسي مجددًا.
- تفكيك النظام لا تغيير الوجوه.
لا معنى لأي ديمقراطية دون قطيعة مع البنية الطائفية ومؤسسة العسكر، فالمسألة ليست استبدال الجنرال أو الزعيم، بل تفكيك تحالف الهيمنة الطبقية المتجذر في:
الامتيازات الموروثة (الطائفية).
أدوات القمع (العسكر).
الأيديولوجيا الدينية السلطوية (الإسلام السياسي).
إن مهام التحول الديمقراطي في السودان تفرض:
بناء أدوات سياسية جديدة تعبّر عن الطبقة العاملة والمهمشين.
تفكيك اقتصاد الريع، واستعادة الدولة من قبضة العسكر والرأسمالية الطفيلية.
إعادة تعريف المواطنة والدين والدولة على أسس تحررية، مدنية، واجتماعية.
*****************************************
الصفحة التاسعة
أرنولد يقدم منهاجاً تدريبياً متكاملاً استعداداً لمباريات ملحق المونديال
بغداد ـ وكالات
أكد مدير المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة، يوسف فعل، أن المدرب الأسترالي للمنتخب الوطني، غراهام أرنولد، قدّم منهاجاً تدريبياً متكاملاً إلى الاتحاد، يجري حالياً دراسته من أجل تهيئة كل المتطلبات اللازمة لتنفيذه استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وقال فعل في تصريح للوكالة الرسمية، إن "أرنولد أبدى حماسة كبيرة لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال، ويؤمن بقدرات المنتخب العراقي، خاصة بعد أن وجد في العراق بيئة مناسبة لتطبيق أفكاره التدريبية".
وأضاف فعل أن أرنولد، فضّل البقاء في بغداد لمتابعة مباريات الدوري العراقي عن كثب، بهدف اكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل المنتخب في المرحلة المقبلة. وختم بالقول إن القائمة المقبلة للمعسكر التدريبي أو المباراة الودية ستكون حصيلة هذه المتابعة الدقيقة، وستضم اللاعبين الأكثر جاهزية من النواحي الفنية والبدنية والذهنية.
*****************************************
دوري نجوم العراق الشرطة يقترب من حسم اللقب للمرة الرابعة تواليا
بغداد – طريق الشعب
تتواصل منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق للمحترفين أيام الخميس والجمعة والسبت، في مرحلة حاسمة قد تشهد تتويج فريق الشرطة بطلاً للدوري للمرة الرابعة توالياً، في حال فوزه على نفط البصرة وتعثر غريمه الزوراء أمام الكرخ.
تنطلق اليوم الخميس ثلاث مباريات ضمن الجولة، حيث يستضيف فريق القاسم نظيره ديالى على ملعب النجف في تمام الساعة السابعة مساءً، في مواجهة يسعى فيها كلا الفريقين لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.
وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً، يلتقي الكهرباء مع النجف على ملعب الزوراء، في حين يحتضن ملعب الشعب الدولي مواجهة مرتقبة بين القوة الجوية وأربيل، وهي مباراة ذات طابع تنافسي عالٍ نظراً لموقع الفريقين وطموحهما الآسيوي.
يحل المتصدر الشرطة ضيفاً على نفط البصرة غداً الجمعة، في مباراة مفصلية قد تضع "القيثارة الخضراء" على منصة التتويج إذا ما عاد بالنقاط الثلاث، شرط تعثر الزوراء الذي يواجه فريق الكرخ في التوقيت ذاته وعلى ملعبه.
تُختتم الجولة مساء السبت، بإقامة لقاءين مهمين؛ حيث يستضيف الكرمة فريق دهوك عند الساعة السابعة مساءً، فيما يشهد ملعب الفيحاء مواجهة جماهيرية تجمع الميناء بالطلبة.
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تعديل مواعيد مباريات الجولة 36 بسبب موجة الحر المرتفعة التي تؤثر سلباً على أداء اللاعبين وسلامة الجماهير والملاكات التدريبية.
وأوضح الاتحاد في بيان مقتضب، أن قرار التعديل جاء حفاظاً على سلامة المشاركين، مشيراً إلى أن المواعيد الجديدة ستُطبق اعتباراً من هذه الجولة.
مع اقتراب ختام الموسم، تتجه الأنظار إلى منافسات هذه الجولة الحاسمة التي قد تحدد مصير اللقب، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة ما إذا كان الشرطة سينهي السباق مبكراً، أم أن الحسم سيتأجل للجولات الأخيرة.
******************************************
دهوك يتهم لاعبه بيتر كوركيس بالتمرد ويمنحه مهلة قبل اللجوء إلى القضاء
دهوك – وكالات
اتهم نادي دهوك الرياضي، أمس الأربعاء، لاعبه بيتر كوركيس بـ "التمرد" بعد امتناعه عن التواجد في صفوف الفريق، رغم استحقاقات حاسمة تلوح في الأفق، مانحاً إياه مهلة 5 أيام للتراجع عن قراره والالتحاق بالفريق، قبل اتخاذ خطوات قانونية بحقه.
وقال أمين سر النادي، جاسم محمد حاجي، إن "اللاعب بيتر كوركيس أبلغ الإدارة بعدم رغبته بالاستمرار مع الفريق، رغم محاولاتنا المتكررة لإقناعه بالعدول عن قراره"، مضيفاً أن "النادي لم يقصر مع اللاعب، وسدد له جميع مستحقاته المالية".
وأوضح حاجي أن "الإدارة منحت كوركيس مهلة خمسة أيام على أمل عودته، لاسيما وأن الفريق مقبل على ثلاث مباريات مصيرية"، مشيراً إلى أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقد احترافي مع النادي يمتد حتى الأول من تموز 2026.
وتابع: "في حال انقضت المهلة من دون عودة اللاعب، فإن النادي سيلجأ إلى الطرق القانونية لحسم الموقف، إذ إن بيتر كوركيس يعد من العناصر المهمة في الفريق ويمتلك إمكانيات فنية جيدة، ومن واجبه احترام العقد وعدم دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات صارمة".
****************************************
فريق الشرطة لكرة السلة يستعد للمشاركة في بطولة العالم بالولايات المتحدة
بغداد – طريق الشعب
يستعد فريق الشرطة لكرة السلة، للمشاركة في بطولة العالم للفرق الشرطوية، التي من المقرر انطلاقها في 28 من حزيران الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة منتخبات شرطوية من مختلف دول العالم، وسط أجواء تنافسية قوية.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أن "اللواء الركن محمود أبو التمن، ممثل وزير الداخلية، قام بزيارة إلى تدريبات الفريق التي أُقيمت على قاعة الشعب المغلقة في بغداد، حيث أثنى على جهود اللاعبين والكادر التدريبي".
وأكد أبو التمن خلال لقائه بالفريق، أن "هذه المشاركة تمثل فرصة لإبراز الوجه الرياضي والانضباطي لمنتسبي وزارة الداخلية في المحافل الدولية"، مشيداً بـ "روح الالتزام والانضباط التي أظهرها اللاعبون، والتي تعكس صورة مشرقة عن الرياضة الأمنية العراقية".
وأضاف أن "الوزارة مستمرة في دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في تعزيز الروح الإيجابية والاحترافية لدى المنتسبين، سواء على المستوى المحلي أو الدولي"، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على تحقيق نتائج مشرّفة ورفع اسم العراق عالياً في البطولة.
***************************************
برشلونة من قمة العائدات إلى شفير الإفلاس.. أزمة اقتصادية تهدد مستقبل عملاق كاتالونيا
برشلونة – وكالات
في عام 2019، دخل نادي برشلونة التاريخ بتحقيقه عائدات سنوية تجاوزت حاجز المليار دولار أمريكي، ليصبح أول نادٍ في العالم يصل إلى هذا الرقم، وسط شعبية متنامية رغم غيابه عن الألقاب القارية منذ تتويجه الأخير بدوري أبطال أوروبا في عام 2015.
لكن هذا الإنجاز المالي لم يصمد طويلاً، إذ سرعان ما وجد النادي الكتالوني نفسه غارقًا في ديون هائلة كادت أن تجره إلى إعلان الإفلاس، مما دفع رابطة الليغا الإسبانية إلى فرض قيود مالية صارمة، شملت تخفيض سقف الإنفاق ورواتب اللاعبين، خاصة بعد التراجع الاقتصادي الكبير الذي خلفته جائحة كوفيد-19.
ورغم محاولات رئيس النادي الحالي، خوان لابورتا، منذ انتخابه عام 2021 لإعادة التوازن الاقتصادي واستعادة القدرة التنافسية للنادي، إلا أن الأزمات الإدارية والمالية ما تزال تلقي بظلالها على برشلونة، خصوصاً بعد تعذر تسجيل بعض اللاعبين مثل داني أولمو وفكتور باو، والتصريحات الأخيرة لرئيس الليغا خافيير تيباس التي شككت في قدرة النادي على التوقيع مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الأزمة الحالية تعود جذورها إلى فترة إدارة جوسيب ماريا بارتوميو (2014–2020)، والتي تميزت بتغييرات متكررة في الإدارة الرياضية، بلغت خمسة مدراء رياضيين في ست سنوات، وسلسلة من التعاقدات غير المدروسة التي أثقلت كاهل النادي.
وشهدت تلك الفترة أيضاً ارتفاعاً حاداً في كتلة الأجور، إذ وصلت إلى أكثر من 50 بالمائة من إجمالي العائدات السنوية. ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "إلموندو"، فإن ليونيل ميسي وحده تقاضى نحو 555 مليون يورو بين عامي 2017 و2021، إضافة إلى مبالغ ضخمة صرفت على العمولات ووكلاء اللاعبين.
ورغم الإنفاق الهائل، لم يتمكن برشلونة من تحقيق إنجازات توازي ما حققه في الحقبة الذهبية (2005–2015)، والتي اعتمد فيها بشكل أساسي على لاعبي الأكاديمية دون كلفة مالية كبيرة.
وبسبب تراجع المداخيل، اضطرت إدارة برشلونة للامتثال لقرارات الليغا، التي فرضت سقفًا للإنفاق بلغ 204 ملايين يورو في بداية الموسم الماضي. ورغم التحسن الطفيف في الوضع المالي مطلع عام 2025 بعد جولة استثمارية ناجحة في الشرق الأوسط قادها لابورتا، إلا أن السقف المالي المسموح به لا يزال بعيداً عن منافسيه الرئيسيين.
وتشير تقارير إلى أن السقف المالي الجديد سيرتفع إلى 244 مليون يورو فقط، مقارنة بـ 700 مليون لريال مدريد و314 مليون لأتلتيكو مدريد، بينما يتصدر إشبيلية قائمة الأندية الأكثر تضررًا بانخفاض سقف إنفاقه إلى 684 ألف يورو فقط، في مؤشر خطير على اقترابه من الإفلاس.
يأمل برشلونة في تحسين أوضاعه المالية مع العودة إلى ملعب "كامب نو" في أغسطس المقبل، حيث يتوقع أن تدرّ مقاعد كبار الشخصيات والعقود التجارية الجديدة دخلاً إضافياً يساعد في تخفيف الأزمة. لكن حتى ذلك الحين، سيظل النادي أمام تحديات كبيرة لتسجيل اللاعبين الجدد، وضمان الحفاظ على القدرة التنافسية محلياً وأوروبياً، في ظل استمرار القيود المالية الصارمة.
******************************************
وقفة رياضية.. ماذا بعد ملحق كأس العالم؟
منعم جابر
تقدّمنا على كثير من البلدان الآسيوية في مختلف الألعاب الرياضية، ومنها كرة القدم، حيث تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم قبل أربعة عقود، ونجحنا في حصد ميدالية أولمبية قبل أكثر من ستين عاماً. وقد حققت رياضتنا، خلال عقود سابقة من القرن العشرين، نتائج ونجاحات متميزة.
لكننا اليوم نشهد تراجعاً كبيراً، خاصة خلال العقدين الأخيرين. فما الذي حل برياضتنا ومستوياتها؟
أعتقد أن أسباب التراجع والإخفاق تعود إلى تدخل غير المختصين في الشأن الرياضي، من طارئين وانتهازيين، ممن تولّوا زمام الأمور في هذا القطاع، فتسببوا في تدهوره. هؤلاء من أنصاف الرياضيين عبثوا بالواقع الرياضي، مما أدى إلى إقصاء أهل الرياضة الحقيقيين وابتعادهم، فانعكس ذلك سلباً على الأداء العام ونتائج المنتخبات.
وهنا أود الحديث عن الفشل والإخفاق في كرة القدم، بعدما كانت فرصتنا متاحة، ومستوانا يؤهلنا للتأهل إلى كأس العالم. فما السبب؟
في رأيي، يكمن السبب في التخبط داخل إدارة الرياضة العراقية، ولا سيما اتحاد كرة القدم، الذي شابت عمله الخلافات والصراعات الشخصية، وغياب الانسجام والتفاهم بين أعضائه.
ومن العوامل المؤثرة أيضاً، اختيار الطاقم التدريبي الإسباني. فهل كان هذا الاختيار موفقاً؟
بداية الارتباك ظهرت من خلال التبديلات والاختيارات المتسرعة لبعض اللاعبين، من دون استقرار واضح على تشكيلة ثابتة للمنتخب الوطني، ما أثار كثيراً من علامات الاستفهام. وجاءت نتائج المنتخب المتواضعة في بطولة خليجي 26 بالكويت لتؤكد حالة التخبط، وعدم وضوح الرؤية التدريبية.
اليوم، ونحن نبدأ مشوارنا في الملحق الآسيوي، في امتحان جديد خلال شهر تشرين الأول المقبل، فإن المطلوب هو منح المدرب الجديد وطاقمه الفني كامل الحرية في العمل، ودعم اختياراته، مع توفير مباريات تجريبية قوية تساعده في فهم قدرات لاعبيه بشكل أعمق.
كذلك، من الضروري العمل بجد على إنهاء الصراعات والخلافات داخل اتحاد الكرة، وتوحيد الجهود. وهنا أدعو الزملاء الإعلاميين إلى التهدئة، والابتعاد عن الحملات الهجومية، وممارسة دور الدعم والإسناد المعنوي لقيادة اللعبة.
بهذا النهج، فقط، يمكننا أن نعيد الأمل في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، وهو طموح مشروع نتمنى جميعاً تحقيقه.
*******************************************
الصفحة العاشرة
صورة الحرب في الفن.. من غويا إلى بيكاسو
ريم ياسر*
أرّخت معظم الحضارات حروبها من خلال الصور، وسجلت مشاهد من المعارك والفتوحات التي خاضتها. إذ سجل المصريون القدماء، على سبيل المثال، مشاهد من حروبهم على جدران المعابد والمقابر. في كثير من هذه الرسومات، يظهر الملك وأمامه مجموعة من الأسرى في وضع الاستعطاف والمذلة، وفي صور أُخرى نراه فوق عربته الحربية، موجّهاً سهامه نحو الأعداء. حرص الفنان المصري القديم على رسم الملك في وضع مميز، وغالباً ما كان يظهر بحجم أكبر من أعدائه، في رمزية ميزت الفن المصري القديم. ولم يكن المصريون القدماء وحدهم من فعل ذلك؛ فمعظم الحضارات القديمة أرّخت لحروبها وانتصاراتها برسومات ومنحوتات تحمل قدراً من العنف.
توثيق الحرب أم أنسنتها؟
احتوت الأعمال الكلاسيكية التي تعود إلى عصر النهضة الأوروبي، هي الأخرى على صور لا تحصى لمشاهد الحرب، كان أغلبها مستوحى من الأساطير الإغريقية والرومانية أو من الكتاب المقدّس. وحدها حرب طروادة، وهي إحدى أشهر الملاحم في الميثولوجيا الإغريقية، حظيت باهتمام عدد كبير من فناني عصر النهضة، المعروفين منهم والمغمورين على حد سواء.
وقد تناول كثير من الأعمال الكلاسيكية موضوع الحرب، رغم تركيزها على قسوة تلك الحروب وضراوتها، بنوع من التمجيد لها، بوصفها جزءاً من ملحمة قومية أو عقاباً سماوياً. ولعل الفنان الإسباني فرانسيسكو دي غويا (1746 - 1828) كان من أوائل الخارجين عن هذا السياق في العصر الحديث. فقد حاول تسجيل مشاهداته ومعايشته لأجواء الحرب من منظور إنساني، من دون الانغماس في جماليات المشهد أو اللجوء إلى تفسيرات أسطورية كما كان شائعاً في عصره.
وسجل غويا فظائع الحرب التي دارت على أرض إسبانيا مع دخول قوات الاحتلال الفرنسية إلى بلاده. وقد شكلت الأعمال التي رسمها في تلك الفترة الإرهاصات الأولى لبداية عصر الحداثة في الفن. لم تكن أعماله مستندة إلى الخيال أو الأسطورة، بل إلى ما رآه وما سمعه من شهود عيان. ترك غويا عدداً كبيراً من اللوحات تؤرخ لسنوات الحرب والمقاومة وما تخللها من مجازر دموية. في تلك الأعمال، اختفت الجمالية التقليدية التي ميزت لوحات الحرب الكلاسيكية المستندة إلى الأساطير؛ إذ تجلت فيها عين الرائي، التي لا مجال فيها لتجميل البشاعة. امتلأت لوحاته بمشاهد مؤلمة لرؤوس مقطوعة، وأشلاء ممزقة، وجثث متناثرة في الخلاء لا تجد من يواريها التراب، وأطفال يصرخون، وأمهات ونساء يُغتصبن بوحشية، وإعدامات يومية في الشوارع لكل من يقاوم.
لقد صور غويا الحرب كما لم يصورها أحد من قبل، وذلك من خلال مجموعة من أعمال الحفر، إضافة إلى لوحة زيتية كبيرة معنونة باسم "الثالث من مايو"، تصور عملية إعدام جماعية لمجموعة من رجال المقاومة.
تعد لوحة "الثالث من مايو" من أبرز أعمال غويا، لما تحمله من مضمون قوي، وطريقة معالجة مميزة للعناصر، إضافة إلى التلوين الدرامي الذي هيمن على أجواء العمل. وقد أثرت هذه اللوحة في عدد من الفنانين الذين جاؤوا بعده، من بينهم الفنان الفرنسي إدوار مانيه، الذي استلهم منها لوحته الشهيرة التي تصور عملية إعدام إمبراطور المكسيك ماكسيميليان.
حافظ مانيه على الطريقة نفسها لاصطفاف الجنود، والخطوط الأفقية التي تحدد مسار البنادق الموجهة إلى صدور الضحايا، محافظاً على وضع المشاهد في الجهة نفسها للقاتل، وكأننا نشارك في القتل بصمتنا، فلسنا أبرياء تماماً. في هذه اللوحة نرى وجوه الجنود بالكاد تظهر، بينما تسلط الإضاءة على ملامح الضحايا المرتعبة، بينما تقف مجموعة من المتفرّجبن يراقبون المشهد بوجل. وعلى غرار لوحة غويا، رسم بيكاسو لوحته المسماة "مجزرة في كوريا"، التي تشبه في ترتيب عناصرها لوحة "الثالث من مايو". غير أن الجنود في لوحة بيكاسو يحملون آلات غريبة، ويبدون أشبه بالروبوتات، بينما يظهر الرعب واضحاً على وجوه الضحايا.
لوحة "غورنيكا" لبيكاسو
وفي سياق المعالجة الفنية لبشاعات الحروب، رسم بيكاسو أيضاً لوحته الأشهر "غورنيكا"، التي تحمل اسم قرية صغيرة في جنوب إسبانيا تعرضت لقصف وحشي من قِبل القوات التابعة لنظام فرانكو، وبمساعدة من الطائرات النازية الألمانية. جالت اللوحة متاحف العالم قبل أن تستقر أخيراً في مدريد. لكنها، قبل كل شيء، احتلت مكانة خالدة في الذاكرة الإنسانية باعتبارها أحد أبرز الأعمال الفنية التي عبّرت عن الحرب وبشاعتها.
جحيم الفوتوغرافيا
ظهرت الصورة الفوتوغرافية إلى الوجود بعد سنوات قليلة من وفاة فرانسيسكو دي غويا، ليبدأ عصر جديد لصورة الحرب، أكثر ضراوة ووحشية. وكأن غويا كان، من دون أن يدري، يدشن لعصر الصورة المرعبة. أتاحت الفوتوغرافيا، وما تلاها من ابتكارات في تحريك الصور، فرصة للاطلاع على أكبر قدر من البشاعة التي ترتكب باسم الحرب في كل مكان. لم تتوقف المشاهد المرعبة عن التداعي عبر الشاشات ووسائل الإعلام، منذ أن ظهرت الفوتوغرافيا، بقدرتها الفائقة على تجميد المشهد قبل أن يفرّ من الذاكرة. هذا الوسيط البصري الذي جعل منا مشاركين افتراضيين في كل ما يحدث على هذا الكوكب من حروب ونزاعات. لعل غويا نفسه لم يكن يتخيل أن صور الحرب التي رسمها في بداية القرن التاسع عشر ستكون أولى الصور الدامية في هذا الأرشيف المرعب. صور المعارك والجثث في الحربين العالميتين، وصور الأطفال القتلى في مجاعات وحروب أفريقيا، ومشاهد التعذيب في سجن أبو غريب، وصور لأشخاص يأكلون أكباد القتلى ويذبحون الأسرى. ثم تأتي الصور التي تتوارد اليوم من غزة، في اللحظة ذاتها التي ترتكب فيها الإبادة، لتكشف حجم الجريمة بالصوت والصورة. الجثث، والأشلاء، والصرخات المكتومة، وعيون الأطفال المفتوحة على الرعب تملأ الشاشات وتتداخل مع ذاكرتنا على نحوٍ لم يحدث من قبل. في عام 1972، التقط المصوّر الفيتنامي نيك يوت، مراسل وكالة أسوشييتد برس، صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود لمجموعة من الأطفال وهم يفرّون من جحيم غارة جوية بالنابالم على إحدى القرى الفيتنامية. تظهر الصورة خمسة أطفال: على يسارها، طفل وطفلة يمسكان بيد بعضهما، ويبدو أنهما أخوان أو من الأقارب. في مقدمة الصورة، يظهر صبي يبكي، بينما يقف طفل آخر لا يتجاوز السابعة من عمره وهو ينظر إلى مجموعة من الجنود في الخلفية. أما مركز الصورة، فتتصدّره طفلة صغيرة عارية، تفرد ذراعيها وعلى ملامحها آثار الفاجعة، بينما يتصاعد الدخان من خلفية المشهد. أثارت هذه الصورة، وغيرها من الصور المشابهة، صدمة عالمية وسلطت الضوء على مدى البشاعة التي ارتكبت في فيتنام حينها. وبعيداً عن الجدل المثار حول الحدود الأخلاقية لنشر مثل هذه الصور، فإنها تلفت انتباهنا إلى الأثر العميق الذي أحدثته الفوتوغرافيا في وعينا البشري، كذلك تدفعنا إلى التأمل في تاريخ الصورة بشكل عام، ولا سيما تلك التي توثق البشاعات الإنسانية. فصورة الطفلة الفيتنامية ما هي إلا واحدة من أرشيف طويل يضم صوراً مرعبة تؤرخ للحروب. فقبل ظهور الفوتوغرافيا ووسائل نشرها كما نعرفها اليوم، كانت صور الحرب تنتقل ذهنياً من طريق الرواية الشفوية أو المكتوبة؛ حيث كان الناس يتحدثون ويروون ما حدث، ويطلقون لخيالهم العنان. وقد أسهمت تلك الروايات المرعبة، على مر العصور، في إسقاط دول وعروش دون مقاومة، إذ استخدمت سلاحاً فعالاً في تدمير معنويات الخصوم. على سبيل المثال، اعتمد المغول في توسعهم على تلك الحرب النفسية التي بثت الرعب في القلوب من خلال تناقل مثل تلك الروايات. أما اليوم، فالصورة الفوتوغرافية تضطلع بالدور ذاته. فكل البشاعات التي تحدث في حروبنا المعاصرة قد حدثت من قبل، وربما بأشكال أشد وطأة، لكن الفارق أن الناس في الماضي كانوا يسمعون فقط، أما اليوم فنحن نسمع ونرى، بل ونشارك أحياناً في ما يحدث. يتواصل الرعب بلا توقف، تتحول الصورة أحياناً إلى سلاح أشد فتكاً من الأسلحة التقليدية. أصبحت الصورة جزءاً من اللعبة؛ يستخدمها طرفا الصراع، وتحدد مسار القرارات الدولية، وتشكل جانباً من الثقافة البصرية للبشر جميعاً. صار الناس مشاركين رغماً عنهم في ما يحدث، وسيظلون هدفاً لهذا الجحيم الضاغط على ضمائرهم، طالما تكررت هذه البشاعات، واستمر هذا الألم الموجع في التسلل إلى عقولنا عبر الصور. ظلت المراوحة بين الصورة الفوتوغرافية والصورة الفنية قائمة منذ ذلك الحين، لكن تبقى الصورة الفنية مجرد ترجمة إبداعية لمشاهد مباشرة وصريحة تلتقطها الكاميرا. مساحة المشاهد المرعبة صارت أكثر هولاً وبشاعة مما تتحمله عقولنا. بضغطة زر واحدة، تنفتح أمامك طاقة من الجحيم: بشر بلا رحمة، وقلوب متحجرة، وأشلاء ضحايا، وجروح، وإصابات، وبكاء، وألم.
المشاهد نفسها تتكرر عبر التاريخ، لكنها اليوم تصدم العين ببشاعتها، لأنها لا تطرق أبوابنا، بل تتسلل إلى بيوتنا ومخادعنا ليلاً ونهاراً. لقد تحولت الصورة إلى شاهد لا يرحم، ولا يغلق عينيه، ولا ينسى. وما دمنا نرى، فنحن مسؤولون، وما دامت الصورة تنقل، فإن العالم كله حاضر في ساحة المعركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتبة من مصر
"العربي الجديد" – 28 أيار 2025
***************************************
ساعد في دحر النازيين بطائرات خشبية تعرّف على فريق الطيران النسائي
في ظلام الحرب العالمية الثانية، حلّقت مجموعة من الطيارات الروسيات في السماء، لا يحملن سوى القنابل والعزيمة، ليصبحن كابوساً للألمان، عُرفن باسم "ساحرات الليل". وتزخر الحرب العالمية الثانية بقصص بطولية استثنائية لم تنل جميعها حقها. والآن، وفي حلقة جديدة من بودكاست "أبطال التاريخ السري" على راديو بي بي سي 4، بصوت هيلينا بونهام كارتر، تسلط الضوء على هؤلاء البطلات المنسيات.
ولا شك أن أياً منهن أكثر تميزاً من سرب من الطيارات الروسيات اللواتي حلقن تحت جنح الليل ونفذن مهام قصف سرية.وأطلق الألمان على هؤلاء النساء اسم "ساحرات الليل". لاوكنّ نخبة من الطيارين والملاحين وطاقم الأرض والميكانيكيين، وقد قادهن شغفهن بالطيران وإحساسهن القوي بالواجب إلى كسر الحواجز بين الجنسين. أشلي، امرأة شابة ذات شعر بني طويل ترتدي قميصاً بلا أكمام، تلتقط صورة سيلفي مع جو، شاب ذو شعر أشقر يرتدي سترة رمادية وقميصاً أبيض وربطة عنق رمادية. وكان من بين أعضاء السرب الطيارتان الطموحتان والصديقتان المقربتان بولينا غيلمان وغالية دوكوتوفيتش، تعلمتا الطيران في صغرهما، وعندما صدر الأمر في تشرين الأول 1941 للطيارة السوفيتية الشهيرة مارينا راسكوفا بتجنيد النساء في وحدات الطيران النسائية، بما في ذلك "ساحرات الليل"، انتهزتا الفرصة على الفور.
وتقول المؤرخة ليوبا فينوغرادوفا، مؤلفة كتاب "ملائكة منتقمون: قناصات سوفياتيات على الجبهة الشرقية" (1941-1945)، عن المرأتين: "كانتا مغرمتين بالإثارة. كانتا ترغبان في الطيران، وكانتا شغوفتين به. وثانيا، كانتا وطنيتين للغاية. لذا، تطوعتا".
وكانت قائدتهم راسكوفا مصدر إلهام. تقول فينوغرادوفا: "كانت من مشاهير عصرها. كان اسمها وصورتها ووجهها معروفين في جميع أنحاء البلاد. كانت قدوة حسنة. امرأة أثبتت أن النساء قادرات تماماً على هذا النوع من الطيران".
تحويل القيود إلى ميزة
وبالقرب من نهر الفولغا في روسيا، أنهت "ساحرات الليل" تدريباً يستغرق عادة ثلاث سنوات في ثلاثة أشهر فقط. ووجدت السيدتان نفسيهما مُختارتين كملاحات، لا طيارات، وهو أمر خيّب أمل دوكوتوفيتش في البداية، إلا أنها بعد أن حلّقت في الجو، أصبحت أكثر تفاؤلاً حيال هذه النتيجة، فكتبت: "الآن أرى كم هو مثير أن تكون ملاحاً! عندما تحلق قليلاً، تتجول في حلم، وتتمنى فقط العودة إلى السماء". وبسبب نقص الطائرات في القوات السوفيتية، مُنحت النساء طائرات خشبية من طراز Po-2، غير صالحة للقتال، إذ كانت تستخدم عادة لرش المبيدات الحشرية. علاوة على ذلك، لم يُزوَّدن بأسلحة أو أجهزة راديو أو مظلات. ونتيجة لذلك، أُعطيت الأولوية لحمل القنابل. وفيما يتعلق بطائراتهن، استغللن محدوديتهن لصالحهن، فكان ضجيج طائرات Po-2 ضئيلاً، ولا يمكن تتبع موقعها لاسلكياً، وكانت صغيرة جداً بحيث لا تظهر على أجهزة تحديد المواقع بالأشعة تحت الحمراء. وهكذا، تمكنت النساء من التحليق فوق الأراضي الألمانية، وإطفاء محركاتهن والانزلاق، وإلقاء قنابلهن بسهولة أكبر دون أن يُكتشف أمرهن. ووفقاً لفينوغرادوفا، كانت وتيرة عملياتهن لا هوادة فيها: "كل أربع دقائق، كانت طائرة تقلع، وتقصف الهدف ثم تعود أدراجها، لتحل محلها الطائرات الأخرى". ونشر الألمان قصصاً عن تلك الهجمات في المناطق التي كانوا يحتلونها، وصوروا السيدات كقوة خارقة للطبيعة، وأطلقوا عليهن اسم "ساحرات الليل"، لأن طائراتهن الخشبية شُبّهت بالمكانس، بينما جعلتهن يشعرن وكأنهن يظهرن ويختفين دون أثر. وقد اكتسبت "ساحرات الليل" التميز بفضل انتصاراتهن، وفي عام 1943 أصبحن رسمياً فوج حرس الطيران الليلي السادس والأربعين لقاذفات القنابل. ومع ذلك، في شهر تموز من ذات العام، فاجأ الألمان الطيارات الروسيات بتكتيك جديد، إذ أبقوا مدافعهم المضادة للطائرات صامتة، وشنوا بدلاً من ذلك هجوماً جوياً ليلياً ضد القاذفات. وقُتلت دوكوتوفيتش في 31 تموز، مع سبع من زميلاتها "الساحرات" فيما وصفته فينوغرادوفا بأنه "أسوأ ليلة على الأرجح في تاريخ الفوج بأكمله". ومع ذلك، واصلت النساء القتال حتى أعلن الحلفاء النصر في مايو 1945. وتقول فينوغرادوفا عن التزام جيلمان والساحرات الأخريات بالقضية: "لقد كانوا في المطار مستعدين للقيام بمهمة عندما تم الإعلان عن النصر". في تشرين الأول 1945، تم حل الفوج رسمياً، وتميز بكونه الوحدة الوحيدة في الجيش الأحمر التي لا تزال تتألف بالكامل من النساء حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وانضمت جيلمان لاحقاً إلى المعهد العسكري للغات الأجنبية، وأطلقت على ابنتها اسم غالية تيمناً بصديقتها الراحلة. وتوفيت جيلمان عام 2005، وفي أواخر حياتها، تأملت في سر نجاح "الساحرات"، معزيةً ذلك إلى أدائهن لواجباتهن طواعية.
وفي حديثها مع المؤرخة رينا بينينجتون، قالت جيلمان: "لقد كانت إرادتهن الحرة، وما يُفعل بدافع القلب يكون دائماً أفضل مما يُفعل بدافع الالتزام".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"بي بي سي" – 7 حزيران 2025
*********************************************
كتب على «ورق التواليت» رحل نغوجي واثيونغو وبقي أثر الحبر
علاء زريفة
كان يمكن لنغوجي واثيونغو أن يصبح مجرد كاتب بارز ضمن جيل من الكتّاب الأفارقة الذين برزوا في ستينيات القرن العشرين، لولا أنه قرر أن يسلك طريقاً مختلفاً وعراً، لكنه أكثر رسوخاً في الأرض التي جاء منها. لم يكتب ليرضي الجوائز، ولا ليكسب اعترافاً عالمياً بلغة الغالب، بل كتب ليفضح، ويحتج، ويؤسس لمشروع تحرير لم يكن سياسياً بقدر ما كان لغوياً وثقافياً.
ولد نغوجي في كانون الثاني 1938 في كينيا التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني، ونشأ في بيئة تتعدد فيها الزوجات ومتشظية بفعل الاحتلال، ليشهد في طفولته المبكرة كيف أن لغة أمه تُهان داخل أسوار المدارس، ويعاقب من يتحدث بها. يومها لم يفهم تماماً ما يجري، لكنه أدرك مبكراً أن اللغة ليست مجرد أداة للتفاهم، بل مسألة كرامة ووجود. باسم "جيمس نغوجي"، دخل عالم الأدب بالإنكليزية، وصدرت روايته الأولى "لا تبكِ أيها الطفل" عام 1964، ليكون أول كاتب من شرق إفريقيا تُنشر روايته ضمن سلسلة "هاينمان" الشهيرة، بإشراف صديقه وشريكه في الهم القاري تشينوا أتشيبي. لكن هذه البداية الناجحة لم تمنعه من التوقف والتأمل، ثم الانعطاف كلياً عن الإنكليزية، نحو لغة الجيكويو التي تربى عليها، وقرر أن يجعل منها أداة لمقاومة الثقافة الاستعمارية.
شكل عام 1977 لحظة فارقة في مسيرته: اعتُقل إثر مشاركته في تأليف مسرحية "سأتزوج عندما أريد"، وهي عمل كُتب بلغة الجيكويو، وأدى أدواره فلاحون، وانتقد بوضوح فساد الطبقة الحاكمة. قضى نغوجي عاماً في السجن، وهناك كتب روايته "شيطان على الصليب" على ورق التواليت، لتتحول التجربة من محنة شخصية إلى بيان أدبي في وجه القمع. بعد الإفراج عنه، دخل في منفى طويل، تنقل خلاله بين بريطانيا والولايات المتحدة، محاضراً في جامعات كبرى، ومؤسساً مراكز تعنى بترجمة الأدب والكتابة بلغات الشعوب. لكنه ظل، رغم المنفى، مشدوداً إلى بلاده، يتابع ما يجري، ويكتب عنها بروح الساخر أحياناً، والغاضب كثيراً. في رواية "ساحر الغراب" (2006)، مثلاً، شيّد عالماً تخيلياً من الرموز السياسية التي تعري الواقع الإفريقي الحديث. لم يكن مشروع نغوجي جمالياً بحتاً، بل مشروع تحرر، أدبي ولغوي في آن. اعتبر أن الإمبريالية ليست مجرد قوة عسكرية، بل مشروع ثقافي يبدأ من فرض اللغة، وتهميش الذاكرة، وإعادة تشكيل الفرد ليحتقر تاريخه الخاص. كتب في أحد أشهر مؤلفاته النظرية "تفكيك عقل المستعمَر" أن أخطر أدوات السيطرة هي تلك التي تجعلك تحب سلاسلك، وتتباهى بإتقان لغة من ضربك بالأمس.
ورغم نبرته الحادة تجاه الإنكليزية، لم يكن متطرفاً في رفض الآخر، بل ناقد للعلاقة المختلة بين اللغات في إفريقيا، حيث تُقدَّم لغة المستعمِر على لغات الشعوب. وقد رأى أن التعليم الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالثقافة الأصلية، وأن الكاتب، أياً كانت وسيلته، لا بد من أن يكون شاهداً وشريكاً في معركة الوعي.
بعد عقود من الغياب، عاد نغوجي إلى كينيا عام 2004، في لحظة بدت أشبه بخاتمة رمزية، لكنه تعرض لهجوم عنيف في مقر إقامته، فغادر من جديد، من دون أن يتراجع عن قناعته بأن المستقبل يُبنى بلغات الأرض، لا بلسان الغزاة.
في صورة نادرة، ظهر نغوجي وقد وضع يديه على كتفي ولديه، موكوما وانجيكو، وكلاهما كاتب، وكلاهما اختار الكتابة بالإنكليزية. لم يغضب، بل ابتسم. لعله أدرك أن المعركة لا تدور حول اللغة فحسب، بل حول ماذا نقول بها، ومن نخاطب.
توفي نغوجي واثيونغو عن 87 عاماً، تاركاً خلفه تراثاً روائياً ونظرياً بالغ الأثر، من أبرز أعماله "بتلات الدم"، و"شيطان على الصليب"، و"ساحر الغراب"، و"ماتيغاري". بقي اسمه منارة لكل من آمن بأن الأدب لا يُكتب فقط للترف، بل ليقاوم، وليبني أمةً على شفا اللغة والكرامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"النهار العربي" – 29 أيار 2025
***********************************
الصفحة الحادية عشر
اخبار ثقافية
- نسب/ رواية اوكتافيا بتلر/ ترجمة منى كريم. اصدار: تكوين. تتناول حياة العبيد ونضالهم من اجل الحرية.
- في نقد ما بعد الحداثة/ نيتشه والفلسفة/ تأليف الكاتب التونسي محمد المزوغي، اصدار كارم الشريف- تونس.
- مجلة سومر/ عدد جديد تناول السينما العراقية، وفوز احد الأفلام العراقية بجائزة مهرجان كان السينمائي. يرأس تحرير المجلة الناقد السينمائي نزار شهيد الفدعم.
- أعمدة النيران الخضراء/ انطولوجيا الشعراء العراقيين الذين قتلهم نظام البعث وصدام ( 1968- 2003) تحقيق حيدر الكعبي/ اصدار: دار الجمل- المانيا.
- دراسات في اسلوبية النص/ تأليف د. عز الدين الذهبي. اصدار: المطبعة والوراقة الوطنية/ مراكش.
- ودعت الأوساط الثقافية العراقية والعربية الفنانة المسرحية الرائدة سميحة أيوب والفنانة المسرحية غزوة الخالدي، لأرواحهم السلام والطمأنينة.
- ودع ادباء العراق الشاعر الشاب عقيل العلاق الذي كان قد أثرى الوسط الادبي بنصوص ثرية بجمالها.
************************************
شاعر وقصيدة
بهدف تشكيل رؤية متكاملة عن شاعر ومنجزه، نقدم هنا قراءة نقدية لقصيدة للشاعر ليث الصندوق، كنا قد نشرناها من قبل، كما ننشر نصاً جديداً له، استكمالاً للصورة" م. ث.
قصيدة «نحن نصنع الطغاة» لـ ليث الصندوق البنية والدلالة
علاء حمد
إنّ الوحدة المتميّزة للبنية النصّية، تنصهر مع الثقل الشعري، ولا يأتي الثقل الشعري إلا من خلال اللغة الخالصة التي توفر لنا العذوبة الجماليّة؛ ولكن في الوقت نفسه هناك المتعلّقات الذاتية التي توفّر المعنى القصدي، ويتداخل موضوع المعنى مع موضوعات مصغرة، ولا تعد هذه الخصوصية مقاطعات الذات، بقدر ما تكون الجزء الأوفر لعملية البناء النصّي.
إنّ البنية الدالة الرئيسيّة في النصّ تكمن في ظواهر وأشكال لغويّة، قد يرمز إليها الشاعر، أو يوظف بعض الإشارات التي تقودنا عن قرب إلى ذلك النسق الممتدّ والذي يؤدّي إلى الدالة الرئيسية. وبحكم العنونة التوضيحية وما قدّمه الشاعر ليث الصندوق (نحن نصنع الطغاة)، فقد ارتبط العنوان مع الجسد النصّي، عبر ظواهر ومفاهيم تكيّفت مع الموضوع القصدي الرئيسي. "أيها الطاغية/ عندما انزاح الستار/ ورأيناك لأول مرّة / تسكب من الزجاجة ابتسامتك المائعة/ لم تكن يومئذ أصابعك قد ضُفرتْ حبالاً / ولم تتحوّل مساماتُكَ مزاغل للقنّاصة / كنتَ وديعاً كطفل وِلِدَ من قلب نبتة الخس / عندما كنا ننظر لأصابعِك التي تموع من التوهج / نظنّ أن الشموعَ صالحة للأكل".
يشتغل دال المعنى على المتعلقات الذاتية المطروحة، والذي نلاحظه أنّ الشاعر وظف الخاصية الإشاريّة لظهور تلك المعاني، فبعض الكلمات تحتفظ بالمعنى داخل بنيتها؛ مثلا: الطاغية، الابتسامة والشموع، وفي الوقت نفسه تكون الحالات التركيبيّة قد أوّلت الكثير من الجمل النصّية، ومن خلال الاختلاف اللغوي والتقليل الزمني بين الجمل، أعطت أموراً إدراكيّة ملحّة. لقد جعل الباث الحقيقة ملتصقة بالفرد بذاته، وهو الطاغية الذي دمجه من خلال الخطاب (أيّها الطاغية)، وتمّ جمع الفرد مع الأشياء المحيطة به، وكذلك بعض الوسائل التي يستخدمها الطاغية. إذن، تكون الإرادة مندمجة مع الأشياء، وهما إرادة (الطاغية) والأشياء تكون وسائل توظيفيّة في المنظور النصّي. (يقول التجريبيّون الإنكليز: إنّ مادة الإدراك الحسّي هي أفكارنا عن الأشياء، أمّا الأشياء بذاتها فنحن لا نعرفها لأنّ الذات تقف بيننا وبين حقيقة هذه الأشياء. وإنّ كلّ مايصلنا من هذه الأشياء، هو صفاتها الحسّية، فنحن ندرك الأشياء عن طريق المعطيات الحسّية. – د. رشيد الحاج صالح – المنطق واللغة والمعنى في فلسفة فتجنشتين - ص 183). "كانت نوايانا طيّبة / لكنّنا بغبائنا الموروث / أعطينا مفاتيح قلوبنا لغير المؤتَمنين / فصاروا يؤجرونها شققاً للقتلة واللصوص / وها نحن اليوم ندفع ثمن أخطائنا".
إنّ الشاعر يقف مع القول والقول المتقدّم، فالمعنى يكمن ويظهر من خلال القول، وعندما نفتّش عن بنية المعنى القصدي، نلاحظ أنّ القول الآني هو المعنى، لذلك يقف الفكر (التفكّر أيضاً) مع اللغة المنظورة التي تتواصل بصيغة أفعال كلاميّة غير مباشرة. مثلاً:
كانت نوايانا طيبة / لكننا بغبائنا الموروث / أعطينا مفاتيح قلوبنا لغير المؤتَمنين".
فاللغة هنا هي المؤسّسة للفعل الكلامي. نلاحظ أنّ البنية النصّية تارة تكون محالة إلى الذات، وفي هذه الحالة تُظهر حقيقة الذات ومتعلقاتها، وهي تخلق بشكل آلي صورها الشعريّة بمساهمة الوعي؛ وتارة أخرى من خلال فعل الإشارة، وذلك لكي تظهر في المنظور الكتابي دلالتان، الدلالة السياقيّة والتي تتبنّى الفعل السياقي من خلال العلاقة الاجتماعيّة والفكريّة والوظيفيّة.
"لقد دللناك كثيراً أيّها الطاغية / اِستبدلنا مفاصلك بالبراغي / وشرايينك بأسلاك الضغط العالي / كان أملنا أن نحوّلك إلى مولدة طاقة / لنضيء المستقبل بإيقاعات خطواتك المتوهّجة / لكنّنا أخطأنا / بإعطائك جرعات مضاعفة من الأناشيد والهتافات / فتصلّبتْ في أعماقك / متحوّلة لأكوام من الشتائم تتقبّل دلالة الإشارة توضيح المعاني، وتتقبّل أيضاً المعنى المدغوم في النصّ، وللتواصل مع المعنيين هناك الاستدلال المتعلق بالإشارة، فيكون التأمل النصّي خاصية خارجيّة، أي أنّ الرسالة بمفهومها، تكون في ذهنية المتلقي، وتسعفنا علاقة دلالة الإشارة باللفظ كونها تظهر مدلوله؛ ومن هنا يكون لحركة الأفعال وظهورها، خصوصيات دلاليّة بمفاهيم قصديّة؛ مثلا الفعل (دلّل) في الجملة الأولى، يعتبر من الأفعال التموضعية، وحركته تكمن في المعنى، ونقيس معظم الأفعال وحركتها من خلال؛ الحركة والانتقال والتموضع، وبعض الأفعال خصوصيتها تكمن في المعنى السياقي للجملة. من الممكن أن تكون الإشارة خاضعة لبعض الرموز، كما أشار اليها الشاعر ليث الصندوق في بعض المفردات، ومنها؛ (البراغي، الأسلاك، مولدة الطاقة، الأناشيد، الهتافات.. إلخ). ومن الطبيعي لكلّ رمز تركيبه اللغوي، وفي هذه الحالة تتعدّد المعاني والقراءات. "نحن صنعناك أيّها الطاغية / وسمحنا لخرافك المسلّحة / أن ترعى بمفارق شعرنا / ثمّ رحنا نجأر بالشكوى / من لزوجتك التي حرمتنا من الحركة / تُرى كيف غفلنا عن الدُمّلة / حتى تضخّمت وابتلعتنا / نعم، نحن صنعناك / ونفخناكَ / حتى صارت رئتاك / تمتصّان كلّ ما في مستقبلنا من الإبتسامات".
يقودنا الشاعر ليث الصندوق إلى الاستعارة التي توالت في الاختلاف اللغوي، ومنها اشتق مبدأ التشبيه أيضاً، فالبنية الاستعارية لا تشكّل السياق قاطبة، بل إنّ الإطار اللغوي يعتبر سياجاً فعّالا للنصّ، لذلك فقد قال أرسطو: (إنّ التشبيهات عبارة عن استعارات تتطلب شيئاً من التفسير والتوضيح – د. يوسف أبو العدوس، - كتاب: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث – ص 51).
تُرى كيف غفلنا عن الدُمّلة + حتى تضخّمت وابتلعتنا = لقد شبّه الطاغية بالدمّلة، وهذا يعني أنّه أنزل الطاغية إلى هاوية القبح. ومن خلال هذه العبارات؛ أستطاع الشاعر أن يبيّن لنا الدلالة الثانية، وهي الدلالة المركزيّة في الجزء النصّي المكتمل، ذات علاقة مع البنية القوليّة، حيث أنّ القول يتحوّل إلى كتابة، لذلك فالمنقول هو: النصّ المقروء، الذي تحوّل إلى نصّ مكتوب؛ والمقروء هو ما تحتويه الذات الحقيقيّة من متعلّقات ومفاهيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة: نُشر النصّ في جريدة طريق الشعب العدد: 92، الصادر يوم 16 آذار لسنة 2025
***********************************************
القصيدة الكلبيّة.ز لماذا لا تطلقون البلابل من أقفاصها؟
ليث الصندوق
للكلاب حقّهُم في النُباح
إذا أكرهتموهُم على الصمتِ لم يعودوا كلاباً
بل سلاحفَ مسخّرةً للحراسة الليلية
ما داموا قد وِلِدوا بسبطانات في حناجرهم
فمن حقّهم أن ينقلوا حروبهم إلى مهاجِعكُم
لماذا تُهدّدونهم
بجعل أفواههم مخازن للكراسي المحطّمة
والأحذية العتيقة
هل تُريدونهم أن يُهدهدوا أطفالَكُم ليناموا؟
إذا كنتم تكرهون الكلاب
لماذا تتحوّلون إلى أشباههم
عندما تختصمون بينكم ؟
ما دمتم تنامون في خزّانات الملابس
فلا تتذمروا من رائحة النفثالين
للكلاب حقهم في النباح
فلا تجعلوا الميكرفونات حِكراً على البلابل
لو كانت البلابلُ أهلاً للميكرفونات دون الكلاب
لماذا إذن لا تُطلقون البلابلَ من أقفاصها ؟
وتُزودونها ببنادقَ لحراسة بيوتكم ؟
أرجوكم
ألزمنُ ليس في صالحكم
لن يمرّ وقتٌ طويلٌ
حتى تجدوا أحفادَكم خدَماً في أوجار الكلاب
فتحوّطوا لأيام الذل
لا تجرحوا كرامتَهم بالنظر إليهم من الأعلى
متذرعين بعدم تزييتِ مفاصلكم
أرفعوهم إلى مستوى عيونكم
ودعوا مياهَ نظراتِكم تمتزجْ بوحولِ نظراتِهم
أنقلوا أهاليكم للنوم في الخرائب
واسمحوا للكلاب النوم في أسِرّتهم
أطعموا أطفالكم من القمامة
وأرضعوا الجِراء من حليب رضّاعاتهم
فالكلابُ مثلكم
يتبوّلون
ويتغوّطون
ويُطفئونَ شموعَ القمر بدِلاءٍ ملآى بالدموع
إذا لم تمنحوهم اليومَ حقّ النباح
فغداً سيحرمونكم من حق الإنجاب
وإذا ما اتخذتم الصداع ذريعة
لحرمانهم من الميكرفونات
فغداً ، حين يجتاح قرادُهُم الحدائقَ العامة
وتَستبدلُ الأنهارُ مياهَها العذبة بلعابِهم الدبق
سيحوّلون ثقوبَ أجسادكم إلى ميكرفونات
************************************************
الحداثة والتقاليد الأدبية
بهاء محمود علوان
باستثناء العصر الكلاسيكي والعصر الرومانسي، فإن الفترة المحيطة بعام 1900 هي بالتأكيد أغنى وأصعب فترة في الأدب الألماني، ذلك إن ثراء الاتجاهات المتناقضة والتجريب المتواصل يجعل من الصعب على الباحثين التوصل إلى تقسيم واضح إلى فترات زمنية والاتفاق على مفهوم مرتبط بعصر معين. لقد لاحظ المعاصرون بالفعل مزيجاً من الأساليب الأدبية وفي الوقت نفسه أحسوا بسمات محددة نسبية لتلك الفترة، والتي أطلق عليها هوفمانستال (الكلمات المفتاحية للعصر)، والتي تم بعدها استخدام مصطلح (الحداثة). وقد أُشيرَ لتك الحقبة بالحداثة منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهو كلِّ ما يعد مختلفٌ، أو جديدٌ، أو غير تقليدي، أو ما يصدرُ حديثا.
ومن السلبيات التي رافقت هذا المصطلح (الحداثة)، الذي بات متاحاً للجميع، ومستخدماً من قِبل الجميع، وأن الجميع يفهمونه تقريباً، ولكن ليس بما ينبغ من سمات، وبالتالي فإن الجميع يعرف ما يعنيه، وبالتالي فإنه بالكاد يستطيع أي شخص أن يحدد، أو يستطيع أن يحدد، ما تعنيه الحداثة. ولا يزال عدم اليقين أو التثبت مستمراً إلى يومينا هذا. لا يتفق الباحثون على ما ينبغي النظر إلى الفترة ما بين 1880/1890 و1910/1914 باعتبارها حقبة أدبية واحدة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يكون من المناسب تسمية تلك الحقبة بـ (الحداثة) أو تسميتها عصر آخر. هناك اتفاق على أنه في السنوات بين الطبيعية والتعبيرية كانت هناك العديد من الحركات والاتجاهات الأدبية، ولم يتمكن أي منها من تحقيق هيمنة واضحة. تتميز هذه الفترة بمزيج وتعدد الأساليب.
وعلى النقيض من الافتراض السابق بشأن التسلسل الزمني للحركات الفردية، فإن الأبحاث والأحدث تؤكد على التعايش والتعارض مع التداخلات الكبيرة في الاتجاهات الأدبية بتلك الحقبة الزمنية، بحيث يصعب في كثير من الحالات تعيين مؤلف لاتجاه معين بشكل نهائي. يقدم هورست تومي نظرة عامة نقدية على المحاولات الرامية إلى تحديد العصر بشكلٍ دقيق.
التقليد الأدبي
يمكن فهم الحداثة بوصفها فعل تحرر من تقاليد الواقعية، التي حولها أرنو هولز ويوهانس شلاف إلى مذهب طبيعي بين عامي 1880 و1900. كانت الواقعية مبنية على مفهوم جوهري للواقع، والذي يفهم العالم باعتباره كلاً فعلياً يمكن إدراكه حسياً، وفي نفس الوقت ذا معنى، حيث يقف الموضوع المدرك في موقف إدراكي معاكس له. إن الاعتراف بالواقع المادي المتماسك وبالتالي العلاقات العالمية التجريبية كان الأساس للشعر الواقعي. لقد أعاد الإنتاج الأدبي إنتاج جزء محدد من الواقع تم اختباره ومراقبته، والذي احتوى في الوقت نفسه على بنية من المعنى. ولكي تبدو القصة صادقة للقارئ، فقد تم تقديم معلومات دقيقة نسبيا عن المكان والزمان وقدر كبير من التفاصيل، والتي لم يكن من الضروري أن تكون مرتبطة بمسار الحبكة، ولكنها خلقت (تأثيرا حقيقيا). لقد تم توسيع الموضوع المادي في الشعر في تلك الفترة بشكل كبير إلى ما يتجاوز الحدود التي فرضتها الجماليات التقليدية. لقد كان عالم الرواية الواقعية عالماً مغلقاً يحمل شروطه ونتائجه داخل نفسه؛ واتسمت الحبكة بالوظيفة المتبادلة لجميع أجزائها والترابط السببي والمنطقي. لقد وقفت الذات والعالم متشابكين، في مواجهة بعضهما البعض؛ وقد وصف ث. فيشر علاقتهما الشعرية بأنها (صراع بين الحيوية الداخلية وقسوة العالم الخارجي). وفي الوقت نفسه، كان التحول حقيقة أساسية في الشعر الروائي الألماني الواقعي، ونتيجة لهذا فإن الأدب السردي الواقعي (هو حل وسط بين حقيقة الأشياء ورغبة الإنسان في كيف ينبغي أن تكون). وقد اعترض علماء الطبيعة على هذا التحديد للواقع في بناء واقعي مثالي للواقع. يقول أرنو هولز: (إن الحقيقة التي تعتمد على التقليد المثالي هي الجمال الأساسي للفن).
التقليد المثالي يشمل أيضاً القبيح والغريب والمرضي. لقد تم تقليص الواقع إلى ما يمكن إدراكه بالحواس، والذي كان من المفترض أن يتم التقاطه لغوياً بطريقة ثانية بثانية في مساره المحدد بأكبر قدر ممكن من الأصالة. في العلاقة بين الذات والعالم، حل خضوع الذات للعالم محل الصراع بين الاثنين. لقد فقدت الأنا استقلاليتها. إن ما إذا كان هذا يمثل اختراقاً للحداثة هو مسألة جدل بين الباحثين، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو نقطة البداية لفحص نقدي للتقاليد الأدبية، والتي تستخدم الدراسات الأدبية مصطلحات مختلفة لها: الانحطاط والرمزية والانطباعية والجمالية والفن الجديد والفن من أجل الفن والحداثة الفيينية/فيينا الشابة، والرومانسية الجديدة. بالنسبة لأولريكه واينهولد، هذه ليست سوى (مظاهر لظاهرة شاملة يمكن تقسيمها إلى هذه الجوانب المحددة. ولم يصبح هذا الرأي مقبولا على نطاق واسع ليومنا هذا).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
1-Die Struktur des modernen deutschen Romans, von Ulf Eisele, Tübingen : Niemeyer, 1984.
**************************************
مرثية عامل
مشتاق عيدان
المشيّعونَ يَحدّقونَ في ساعاتِهم،
لا وقتَ لديهم...
دكاكينُهم مشرعةٌ بانتظارِ الزبائن،
وهو،
لم يَعُدْ زبونًا.
بعضُهم يُفكّرُ:
كيفَ يُفاتِحُ أهلَ الفقيدِ بما تبقّى عليهِ من دين؟
ثمنًا للسجائرِ التي كانَ يحبّها!
أمّا بقاياها،
فتُوزَّعُ الآنَ على أصدقائِهِ الشَرِهين،
في يومِ عزائِهِ الأوّل.
بعضُهم يَشعُرُ بالسأمِ،
لطولِ انتظارِ وجبةِ الغداء.
كذَبَ من قال: "حزن اليموت أسبوع"...
باتَ يومين،
رأفةً بأصحابِ "الدايت"،
وخوفًا على الفقراءِ من إدمانِ اللحم،
ونكايةً بـ"العَظّامة"!
الأقاربُ جميعُهم،
في انتظارِ "فرحةِ الزهرة"،
إيقاعٌ مُفتعلٌ للفَرحِ الكاذب،
وللزواج...
وللأعيادِ التي تُبَدِّلُ السوادَ بألوانٍ زائفة.
لم يبقَ سوى خيطٍ من أسًى مُتَّقِد
وحدها...
بـ"عِصابةٍ" سوداء،
لافتةٌ أبديةٌ للحزن،
هي الأمُّ،
التي حزنُها لا يُوارى.
******************************************
الصفحة الثانية عشر
الشوارع الثقافية في العراق منصات مجانية لنشر المعرفة ودعم المواهب
متابعة – طريق الشعب
قبل أكثر من عشر سنوات، بدأت مدن العراق تشهد تأسيس شوارع ثقافية في فضاءات عامة. حيث اضطلعت تلك المبادرات، التي غالبا ما يرعاها شباب متطوعون، بأدوار ثقافية عدة، منها بيع الكتب وتنظيم المعارض التشكيلية والأمسيات الشعرية، وإقامة حفلات موسيقية وندوات ثقافية ومحاضرات بيئية في الهواء الطلق. ومع مرور الوقت، تحوّلت هذه الشوارع إلى منصات واسعة لعرض المواهب، لاسيّما لمن لم تتح لهم من قبل، فرصة الظهور في المشهد الثقافي.
ورغم أن فكرة الشوارع الثقافية ليست جديدة على العراق. إذ تعود جذورها إلى شارع الحويش في النجف وسوق النجيفي في الموصل، وصولاً إلى شارع المتنبي الشهير في بغداد، إلّا أنّ تلك النماذج كانت أقرب إلى أسواق كتب ذات طابع اقتصادي، ولم ترقَ إلى مستوى الفعل الثقافي المتنوع والشامل الذي شهدته الشوارع الجديدة.
البداية مع "أنا عراقي.. أنا أقرأ"
بدأت البذرة الأولى للشوارع الثقافية مع مبادرة "أنا عراقي.. أنا أقرأ"، التي أطلقها مثقفون وناشطون في بغداد قبل نحو ثلاثة عشر عاماً، كتجمّع شبابي يروّج للقراءة. وقد عملت المبادرة على توزيع آلاف الكتب مجاناً في مهرجان سنوي بات يُستنسخ في مدن عديدة. وسرعان ما تطوّر هذا النشاط إلى مفهوم أوسع، فدفع إلى تأسيس شوارع ثقافية دائمة.
وتحوّلت تلك الشوارع إلى منصات أسبوعية توفر فضاءً مفتوحاً للتعبير الفني والحوار الثقافي والمناقشات الفكرية وإظهار المواهب، وتشجيع الأعمال التطوعية.
أول الشوارع الثقافية التي رأت النور كان في البصرة عام 2015، وأُطلق عليه اسم "شارع الفراهيدي"، ليغدو ملتقى أسبوعياً يجمع المثقفين والفنانين والصحافيين، ويشكّل سوقاً نشطة للكتب ومنصة للمصورين والرسامين.
وسرعان ما لحقت به شوارع أخرى، مثل: شارع الرميثة الثقافي في المثنى، وشارع الرصيف المعرفي في ميسان، وشارع دجلة في واسط، وشارع كركوك في كركوك، وشارع الناصرية الثقافي في الناصرية، وغيرها.
ورغم أن العديد من هذه الشوارع خفَت نشاطه أو توقف، إلا انه استطاع خلال فترة وجيزة أن يفتح آفاقاً جديدة للشباب ويمنحهم فرصة للانخراط في العمل الثقافي والفني، من خلال فعاليات متنوعة بعيداً عن الأطر الرسمية.
نموذج جديد
أظهرت التجربة أن الشوارع الثقافية قدمت نموذجاً جديدا للمشهد الثقافي، بعيداً عن الطابع التقليدي لشارع المتنبي، الذي وإن كان محجاً للمثقفين والكتاب، إلا أنه بقي أقرب إلى سوق كتب وسلع مختلفة منه إلى حاضنة للإبداع. على النقيض من ذلك، خلقت الشوارع الثقافية في المحافظات بيئة أكثر مرونة، ما سمح بظهور مواهب شابة لم تكن تجد لنفسها موطئ قدم في المركز – حسب ما يراه عديد من المتابعين.
وأطلقت الشوارع الثقافية موجة جديدة من التفكير الإبداعي لدى الشباب، ودعتهم لكسر النمط السائد والانخراط في الفضاء العام صناعاً للثقافة لا مستهلكين لها فقط. كما ساهمت في دفع المجتمع للتفاعل مع الثقافة بوصفها جزءًا من الحياة اليومية.
ولعل أبرز ما قدمته هذه التجربة هو تجاوزها الثنائية التقليدية بين الثقافتين "الشعبية" و"النخبوية". إذ قدمت نموذجًا وسطيًا يجمع بين الاثنتين، لكنه يتحرك ببطء بفعل التحديات والموارد المحدودة – وفقا لمتابعين.
رسالة مفتوحة
تُوجّه الشوارع الثقافية رسالة مفادها أنَّ الفعل الثقافي يمكن أن يكون حراً ومنفتحاً، في ما وراء القاعات المُغلقة. فهي فضاءات جامعة للآداب والمسرح والموسيقى والتاريخ، تفتح الأبواب أمام المواهب الفطرية التي لم تنل فرصة التعليم أو العضوية في النقابات.
ويرى مُنظمو فعاليات الشوارع الثقافية، وهم غالباً متطوعون، أنَّ هذه الفضاءات تشكل استثماراً ثقافياً حقيقياً، يدمج بين الكتاب والفن والأدب، ويساهم في توفير دخل للشباب، فضلًا عن تحفيز الناس على اقتناء الكتب وحضور الندوات والفعاليات الثقافية.
*****************************************
في كربلاء فرقة مسرحية من المكفوفين تُثبت كفاءتها
متابعة – طريق الشعب
خلال عيد الأضحى الفائت، قدمت "فرقة السراج" المسرحية للمكفوفين في كربلاء، عرضا مسرحيا بعنوان "طائر الحمام"، وذلك على مسرح النشاط المدرسي في مركز المحافظة.
وتدور أحداث العمل الذي شاهده جمهور كبير، في حمّام شعبي خلال فترة الاحتلال العثماني للعراق، في محاولة لمقاربة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين ما تعيشه البلاد اليوم وما عاشته خلال تلك الحقبة التاريخية، لكن بطريقة كوميدية ساخرة
في حديث صحفي، يقول مخرج العمل كرار صادق، أن مسرحيتهم هذه شكلت تحديا جديدا لهم، سعوا من خلاله إلى إثبات كفاءة المكفوفين وقدراتهم في مختلف جوانب المسرح، مبينا أن فرقتهم سبق أن قدمت أعمال مسرحية عديدة. أما هذه المرة فقد خاضت تجربة جديدة وفريدة من نوعها "ففي السابق كان جميع الممثلين من المكفوفين باستثناء المؤلف والمخرج، أما في عملنا الأخير فكان جميع الكادر من المكفوفين، حتى المؤلف والمخرج".
ويشير صادق إلى انه "من خلال هذه التجربة، أردنا أن نثبت إمكانية المكفوفين في المجالات الإخراجية والتأليف والتمثيل".
مؤلف العمل علي البصير، يقول من جانبه أن "فكرة المسرحية تدور حول الظالم والمظلوم، وتبيّن أن ما كان يُشاع من ظلم خلال الفترة العثمانية، لا يزال مُشاعا حتى اليوم"، لافتا إلى انه "حاولنا في المسرحية طرح أسئلة من دون إجابات. إذ تركنا هذه المهمة للجمهور. فهو من يحدد الطريقة المناسبة لتغيير الواقع".
إلى ذلك، يقول الممثل أحمد هادي، أنه واجه في البداية صعوبات في التمثيل، خاصة في حركته على المسرح وإظهار تعبيرات الوجه، لكن مع التمرين المتكرر أصبح الأمر سهلا.
****************************************
معاً لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب
دعماً للحملة الوطنية لبناء مقر الحزب الشيوعي العراقي، تبرع الرفاق والأصدقاء:
يواصل عديد من الرفيقات والرفاق التبرع بشكل دوري، وفي كثير من الأحيان بشكل شهري، لضمان استكمال بناء بيت الشيوعيين.. بيت العراقيين.
وقد تبرعت الرفيقة بشرى الحكيم مرة أخرى وبمبلغ (500) يورو، فيما واصل الرفيق عبد الجبار الفتلي مساهماته الشهرية المنتظمة، وكان آخرها بمبلغ (100) ألف دينار.
سلمت أياديهم البيضاء التي لا تتوانى عن دعم هذا المشروع الوطني النبيل.
تحية اعتزاز وتقدير لكل من يرسي لبنة في طريق الحلم، ويمنحنا أملاً يليق بتضحياتنا.
والشكر والتقدير للرفاق والأصدقاء على دعمهم واسنادهم حملة الحزب لبناء مقره المركزي في بغداد.
معاً حتى يكتمل بناء بيت الشيوعيين.. بيت العراقيين.
************************************
يوميات
- تدعو الجمعية العراقية لدعم الثقافة والاتحاد العام للأدباء والكتاب إلى محاضرة عصر اليوم الخميس، بعنوان "مواويل الحاج زاير وتخطي الزمان"، يُلقيها الباحث مزاحم الجزائري، ويُقدمه د. معتز عناد غزوان.
تبدأ المحاضرة في الساعة السادسة مساء على قاعة الجواهري في مقر اتحاد الأدباء بساحة الأندلس.
- يُضيّف منتدى "بيتنا الثقافي" في بغداد بعد غد السبت، الكاتب فرحان قاسم، ليتحدث عن "الماركسية بين الأمس واليوم".
تكون البداية في الساعة الحادية عشرة ضحى على قاعة المنتدى في ساحة الأندلس.
************************************
إما بعد... مسوّدة أخطائنا
منى سعيد
استعير من زميلي الصحفي والشاعر والفنان يحيى البطاط فكرة مقالة له، فازت بجائزة دبي للصحافة عام 2010، يوم كنا نتشارك العمل الصحفي هناك، وكانت بعنوان " المسودة .. صيغة أخرى للحياة".
وقد استهلها بالقول: "تبدو المسودة ببساطة نموذجا صارخا لفشلنا في إدراك الكمال. إنها سجل حافل بالنقصان، والإحباط الذي يلوح في كل كلمة نكتبها، وكل خطوة نحياها. لذا تفرض المسودة نفسها، وتستحوذ على اهتمام الكاتب والقارئ معا، بدرجة لا تقل عن اهتمامهما بالصيغة النهائية للكتابة، التي تسمى "المبيضّة" نكاية بشقيقتها السوداء.
ويضيف: سلطة المسودّة في نقصانها
وسلطة المبيضّة في وَهْم اكتمالها..
ويسرد المقال أمثلة محلية وعربية وعالمية على ما تمثله كتابة المسودة لكبار الكتاب والشعراء، والتي تُعد في عالمنا العربي أمرا عاديا وثانويا لا احد يأبه له، مثلما تلقى مسودات كتاب الغرب وشعراؤهم من تقييم مادي ومعنوي كبير. فقد بيعت مسودة رواية "يوليسيس" للكاتب الايرلندي جمس جويس، مثلا، مقابل 1,7 مليون دولار، وبيعت مسودات رواية "مائة عام من العزلة" للكاتب الكولومبي ماركيز بنصف مليون دولار.
تمثل لي المسوّدة، وقد سوَّدتُ بها عشرات الدفاتر التي جالت معي بلدان غربتي من دولة لأخرى، بداية للفكرة، أو لنقل الشروع بتمرين الكتابة والتهيؤ لها، كمن يبدأ السباحة عند شاطئ البحر قبل الغوص فيه. ففيها رؤوس أقلام و"شخابيط" قد لا تصلح للاستفاضة، وتلمع فيها في الوقت نفسه أفكار أعجَب لها، وأفاجَأ بها عند إحالتها للمبيضّة.
ما زلت أكتب أفكاري بمسودة ورقية في الغالب، ثم انقلها إلى سطح الحاسوب، الذي تلهمني حروفه الضوئية أحيانا إضافات تستدرج أفكارا لآفاق جديدة لم تخطر على البال.
وعدا الكتابة الصحفية أو الأدبية، يلجأ الكثير منا الى الورقة والقلم لتدوين ذاكرته بأحداث أو أرقام ( قبل أن يبددها النسيان). وهذه الجملة هي عنوان الكتاب الذي صدر للبطاط عن دار الشؤون الثقافية في بغداد أخيرا، وضم المقال المذكور .
وللأرقام سطوة الواقع الجامد أكثر من غيرها، وقد لا تتحمل الخطأ أو التأويل مثل غيرها، لذا نستعين بها خشية الوقوع في الخطأ.
لكننا مع ذلك نخطأ على الدوام، بل لا معنى للحياة دونها، ومن الذي سيحدد بالضبط والدقة الخطأ والصح؟
متعتنا الأثيرة ربما تصحيح ما وقعنا فيه من أخطاء كارثية، ومواجهتها قدر الإمكان بشجاعة كافية، وصراحة واضحة، وبوح صادق. حينها فقط ربما نتخلص من آثامها التي تؤرقنا.
مرةً سألت صحفية الشاعر الأرجنتيني بورخيس: لماذا تنشر أعمالك؟
أجاب : "أنشرها حتى لا أبقى طوال حياتي أصحح المسودات".
****************************************
قف.. عالم لا طعم له
عبد المنعم الأعسم
سلام العالم مهدد.. هذا ليس استنتاجاً حدثياً طرحته نشرات أخبار الصباح، وليس فقط شعورا بالهلع لمشاهد الدم والاجساد المتناثرة على عرض الشاشة في غزة وفي الجبهة الإسرائيلية الإيرانية والحرب الأوكرانية، وفي طوابير الجوع والتهميش وجنازات الموت من اقصى العالم إلى أدناه، إذ يطلق الرصاص في الثكنات المحصنة، وتعم الفوضى والمجاعة والانقلابات، وتلبس النعرات الدينية والقومية والمذهبية والقبلية خمارات الحرب السوداء لتطلق الرصاص وتجزّ الرؤوس وتفتك بكل من يعترض سبيلها. والحق، أن العالم غير آمن بسبب كل تلك الإحداث يضاف لها سباق محموم للتسلح، وهذه المرة لإنتاج معدات خاصة بالحروب الأهلية والانقلابات من المسيّرات ومساحيق التسميم الجماعي، وما يمكن حمله تحت الملابس وطي مقاعد السيارات وفي حقائب النساء المجندات في أعمال القتل، وكما يرى "مارتين جون" الخبير شؤون التسلح في منظمة العفو الدولية فان مصانع السلاح الكبرى تحولت من انتاج الأجيال الجديدة من الغواصات والقنابل الأكثر فتكا، إلى طرادات صغيرة وأسلحة تستخدم في تنظيم مذابح أهلية تحقق ما تستهدفه الأسلحة النووية في خلق عالم مضطرب وغير آمن.. ولا طعم له.
*قالوا:
"ردّي السلام، وحيي من حياكِ".
عنترة بن شداد
**************************************
في لندن فعاليات ثقافية بين العراق والأهواز
لندن – طريق الشعب
يقيم "نادي حبر أبيض" البريطاني ومركز لندن للإبداع العربي، الأحد المقبل، فعالية ثقافية بعنوان "بين ثقافتين - العراق والأهواز أنموذجًا".
الفعالية ستتضمن ندوة عن الفن التشكيلي بين الأهواز والعراق، عنوانها "اللوحة والتاريخ"، سيُقدمها عبد القهار عامريان، وندوة أخرى بعنوان "ازدواجية الهوية – فنانون بين الانتماء والاغتراب"، تُقدمها بان الحلي.
كذلك ستتخلل الفعالية ندوة حول التثاقف والتراث بين العراق والاهواز، يُقدمها عارف عبد الله، وأخرى عن الحكاية الشعبية تُقدمها دلال جويد.
وستتضمن الفعالية قراءات شعرية للشاعرين أنمار شدود ومحمد رسن، وندوة بعنوان "مقارنة بين الشعر الشعبي العراقي والاهواري"، يتحدث فيها ناجي الزهيري. إلى جانب ندوة حول التقنية في الشعر الشعبي يقدمها جمال نصاري.
تنطلق الفعالية في الساعة 5 مساء في لندن.
******************************************
السليمانية مدينة مبدعة بامتياز
متابعة – طريق الشعب
منحت أمانة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو، مدينة السليمانية درجة الامتياز بين المدن المبدعة، وذلك نظرا لطروحاتها الثقافية "المتميزة" وتعاونها "اللافت" مع دول العالم في مجال الثقافة والعلوم.
وقالت الأمانة في بيان صحفي، أن مكتب السليمانية التابع لها، قدم بناء على طلبها تقريرا عن فعاليات المدينة خلال أربع سنوات مضت، مبينة أن "التقرير يحوي بيانات الفعاليات والدعم المستمر الذي تقدمه محافظة السليمانية لقطاعات الثقافة، إضافة إلى تنوع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الثقافة وحماية الأدب والأدباء والكتاب والترجمة والإبداع".
وأضاف البيان أن “السليمانية قدمت خلال السنوات الأربع الماضية مبادرات دولية رائعة وشاركت المدن المبدعة الأخرى مشاريعها الثقافية والدولية، وأسست لشبكة واسعة وقوية من العلاقات المتينة والمثمرة داخل شبكة المدن الأدبية، ونجحت في إيصال ثقافتها وأدبها الكردي لتلك الدول".
وفي عام 2019 أدرجت منظمة اليونسكو مدينة السليمانية على "قائمة المدن المبدعة" في مجال الأدب، والتي تضم 66 مدينة مبدعة من دول مختلفة.
وتعد أمانة المدن المبدعة جزءا من شبكة اليونسكو للمدن المبدعة. وهي شبكة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المدن التي تولي أهمية للإبداع والصناعات الثقافية في خطط التنمية الحضرية المستدامة. وتسعى الشبكة إلى تبادل أفضل الممارسات الثقافية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الإبداع والثقافة.