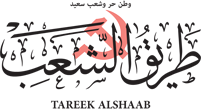من شرارة ذلك السخط المتعاظم، وقد تراكم حتى أدى إلى تحول نوعي في الحراك الاجتماعي، اندلع لهيب انتفاضة تشرين .. ومن قلب دار السلام صدحت الأناشيد، وراح شبح "الثورة" يجول في شوارع مدن بلاد الرافدين .. تعانقت ساحة التحرير في بغداد مع ساحة الحبوبي في الناصرية، لتنضم إليهما ساحة البحرية في البصرة، وساحة الصدرين في النجف، وسائر سوح الاحتجاج في وطن منتفض، لنشهد ما لا نظير له من أيام ثورية في تاريخ العراق الحديث، أضاءت، من بين صفحات أخرى، أسطع ما في الشخصية العراقية من سجايا.
كأن تلك الشرارة انطلقت من متاريس مونمارتر بباريس أيام كومونتها، إلى نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد أيام انتفاضتها .. وأمام ذلك الشبح راحت ترتعد فرائص اللائذين بالنظام القديم، وتتعالى أرواح الشهداء نحو سماء اصطبغت بدمائهم الزكية، وتنطلق هتافات الملايين من شابّات وشبّان الوعد الجديد .. لم يعد رماد الفجائع يقوى على حجب جمرة الكفاح .. وهذه البلاد التي يريدون لها أن تركع في مستنقع الخنوع راحت تقتحم متاريس الجائرين ..
أسئلة حارقة .. صيرورة مفتوحة الآفاق
واليوم إذ نحتفي بهذا الحدث الجليل، المتواصل بأشكال أخرى، فإننا لا نتوقف عند حدود الاستذكار، وإنما نسعى إلى تمثل العبر الموحيات والدروس الملهمة، وطرح الأسئلة الحارقة والبحث عن إجابات شافية، وتدقيق التحليلات والأفكار، ونحن نمضي، غير هيّابين، في طريق طويل، مليء بالأشواك والانعطافات والآلام والتحديات.
انتفاضة تشرين هي صيرورة مفتوحة الآفاق، إذ مازالت عوامل اندلاعها، رغم الخفوت الظاهري، قائمة ومتعاظمة، جعلت من المتعذر العودة الى الأوضاع التي كانت سائدة قبل اندلاعها، فقدمت الدلالة العميقة على أن "دار السيد ليست مأمونة"، وأن اجتراح الجموع المآثر قادر على الإطاحة بعروش الاستبداد.
ولعل من بين سمات هذه الانتفاضة أنها قدمت مؤشرات واضحة على تحول نوعي في الوعي السياسي للمجتمع، وخصوصا في أوساط الشباب الذين كان شرر التحدي يتطاير من عيونهم، والنساء اللواتي تحوّلن إلى أيقونة ملهمة، والمثقفين الذين سطع دورهم الريادي.
ومن نافل القول إن الانتفاضة، التي جاءت حصيلة لتعمق الأزمة الاجتماعية البنيوية، ليست وليدة الصدفة المتلازمة مع العفوية، ذلك أن العوامل الموضوعية هي التي خلقت وعمّقت الأزمة الناجمة عن إخفاق نظام المحاصصة العاجز عن إنقاذ البلاد من الانحدار المأساوي المروّع. وغدا جليّاً أن لا إمكانية لإصلاح الأوضاع، ناهيكم عن تغييرها، من دون حركة جماهيرية واسعة، وأساليب كفاح متنوعة. ولعل من بين ما قدمته الانتفاضة من عِبَر يتجلى في حقيقة أن لا مخرج من النفق المظلم إلا عبر تغيير ميزان القوى السياسي والاجتماعي.
وبينما تجلت في انتفاضة تشرين الهوية الوطنية، مثّلت سلمية الاحتجاجات، وسلوك المتظاهرين المنضبط والمتحرر الطابع المدني للاحتجاج. وقد اتسم الحراك، الذي كسر حواجز اجتماعية وفكرية وسلوكية، بالقدرة على استقطاب قوى اجتماعية واسعة، وتحطيم جدار الخوف، وتحويل التيار الشعبي إلى تيار جارف.
لقد أسهمت الانتفاضة في تأسيس وعي مدني ديمقراطي جديد يتبنى فكرة العدالة الاجتماعية على نطاق أوسع، وتعميق وعي ألوف مؤلفة جديدة، من الشباب والنساء على وجه التحديد، ممن راحوا يتعلمون دروس التمرين الكفاحي الجديد، ويغنون خبرتهم الفكرية والسياسية الميدانية.
وشكلت الانتفاضة حدثاً نوعياً ذا أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية، هزّ أركان النظام السياسي القائم على المحاصصة والطائفية والفساد، وأدى إلى بروز حقائق وظواهر جديدة في اللوحة السياسية والاجتماعية. فقد بات مفهوم الدولة المدنية أكثر تداولا، وتبددت أوهام قوى سياسية متنفذة ومراهناتها على "تراجع" المتظاهرين، ونفاد صبرهم، وسكوت الشارع، وبالتالي "تبخر" هذه "الفورة" العاطفية العابرة.
ويمكن القول إن هناك حراكاً على صعيد المفاهيم والسلوكيات السياسية والمجتمعية. فانكفاء الحديث عن المكونات لصالح تقدم المحتوى الاجتماعي يجسد واقعا جديدا يقلق الأحزاب القائمة على أسس الطائفية السياسية. وبوسعنا أن نرى نوعا من اصطفاف جديد يشير طابعه العام إلى أن قيماً مدنية راحت تشق طريقها وسط تعقيدات الصراع السياسي والاجتماعي المعروفة.
لقد فند الحراك الكثير من التقديرات والتوقعات التي كانت تستبعد إمكانية استمرار الغضب الشعبي. فقد ظل الحراك محافظا على طبيعته السلمية، ولم يوفر للقوى التي ظلت تسعى إلى تحجيمه وإجهاضه أي مبرر لتحقيق مآربها.
وبات موضوع السلمية، التي يريد البعض تجريد الحركة الاحتجاجية منه، منهجا وهدفا، بحيث صار أساسا للانتقال إلى أشكال أخرى من الاحتجاج. وأزالت الانتفاضة تلك المخاوف التي تثار حول التصعيد في الحراك، والتي تزعم أن الأشكال الجديدة، وبينها الاعتصام، وحتى العصيان المدني، قد تهدد السلم الأهلي وتؤدي إلى حالة من الفوضى.
وأثبتت الانتفاضة أن شكل الاحتجاج كان حالة متحركة نشأت في سياقها قوة جاذبة لأوساط اجتماعية أوسع كانت مترددة في مسألة المشاركة في الاحتجاجات ، حتى رأينا الملايين، وهو ينزلون إلى الشوارع في أفواج هادرة.
ولعل من بين دروس الانتفاضة الهامة الأخرى أنها عكست ورسخت المطالب ذات الطابع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وجعلتها في قلب المشهد السياسي، مزيحة الانتماءات الطائفية والعرقية، حتى أضحى الحراك يمارس، اليوم، دوراً أعظم في صياغة المشهد السياسي.
ومن ناحية أخرى فإن لدى حزبنا تجربة غنية، ومريرة أيضا، في التحالفات لابد من العودة إلى دروسها البليغة، آخذين بالحسبان أن التحالف ينطوي، بالضرورة، على تناقض، وأنه إذا كان الحراك صيرورة، فإن الصراع، هو الآخر، صيرورة.
ليش شاقا ولا غريبا علينا أن ندقق مواقعنا ونعيد تقييم مواقفنا وأفكارنا، فقد وقعنا ضحية أوهام غير مرة. وينبغي أن لا ننسى عبر الماضي، فنبقى أسرى ما يمكن أن يدفعنا نحو منعطفات مجهولة، ورغبات تستبد بنا، فتغشي أبصارنا، وتضبّب رؤيتنا، وتسلبنا استقلالنا السياسي والفكري، وهو الضمانة لتأملنا في حقائق الواقع، ورسمنا لسبل تغييره.
مسائل ملحة .. إشكاليات فكرية .. ونزعات عدمية
على الرغم من مآل الانتفاضة و"صمتها" المؤقت، فقد ألحقت أسئلة الواقع هزيمة بتلك القوى التي عبرت عن ميول لتكريس النزعة العدمية وازدراء وتهميش دور الأحزاب والقوى المنظمة، وحرمان الحراك من قيادة واعية. ومما له دلالة عميقة أن كثيرا من تلك القوى تراجع عن مواقفه، وهو تطور جدير بالتأمل. ومهما يكن من أمر المواقف الملتبسة والمتنافرة والمترددة، وتلك التي تقدس العفوية، وتكشف عن النزعات الطفولية والانعزالية، فإن أحد أهم دروس الانتفاضة يتجلى في إمكانية تحقيق نتائج عظمى عندما تتوحد حركة المنتفضين.
وعندما يندلع لهيب الكفاح ما من أحد يحق له أن يجلس على أرائك التنظير، منتقدا عفوية من يشقون طريق التحدي، ويبادرون إلى إشعال فتيل مقاومة النظام القديم. وما من أحد يحق له أن "يتبطّر" في إطلاق "خطأ" العفوية و"صحة" التنظيم. غير أنه عندما تنضج المشاعر على نيران وعي هادئة لابد للرؤية أن تتضح، وللعقلانية أن تسود، وللواقعية أن تتجلى. وعندئذ تخلي العفوية المكان للتنظيم إذا ما أُريدَ لحيرة الثوريين وهزيمتهم أن تتوقف، ولعل ذلك أحد الدروس الكثيرة الغنية لانتفاضة تشرين.
ومن الطبيعي أنه من الخطأ الجسيم وضع العفوية في معارضة التنظيم. فهناك علاقة ديالكتيكية بين هذين العاملين في الحراك، وأن إدراك هذه العلاقة، وبالتالي تحديد مهمات اللحظة الراهنة، يعد من أعظم التحديات التي تواجه الثوريين. ومن الطبيعي أن تحديد الحركة مهماتها لا يعني الخضوع لعفوية الحراك، وإنما أن تضع الحركة نصب أعينها مهمات سياسية وفكرية وتنظيمية أكثر تعقيداً.
لقد دار في الماركسية نقاش مديد حول المشاركة في الثورات العفوية، وكانت وجهة نظر ماركس تؤكد أن المشاركة ضرورية، حتى وإن كان جلياً أن الثورة فاشلة، لأن الهدف هو "تدريب الشعب على الثورة"، والارتقاء إلى مرحلة خوض معركة ظافرة. وهذا هو، بالضبط، ما فعله ماركس حيال كومونة باريس، حيث كان قد نبّه العمال إلى أن أوان الثورة لم يحن بعد، وأن كل تحرك سيقود الى مجزرة بحق العمال. غير أنه حين اندلعت الثورة انخرط فيها دون تردد، بالضبط لكي يكتسب العمال الخبرة التي تؤهلهم للانتصار في ثورة قادمة. ولا يعني هذا أن الشعب لا يخطىء، وأن الثورة ستكون نقية بلا شوائب، وأن كل ممارسات الجماهير صحيحة. فنقص الوعي الفكري والسياسي يفضي الى تجريبية خطرة وأخطاء فادحة وممارسات منفلتة.
وفي كل حال لا ينبغي تقديس حراك الشعب وممارساته كلها، وإنما يتعين تحليلها انتقاديا وكشف أخطارها. كما أنه لا يجب استخدامها لتبرير عدم الانخراط في الثورة. فالجماهير تثور بشكل عفوي، وهذا ليس مبرراً للتشكيك بالثورة، وتحديد "قالبها النظري"، وفي هذا السياق علينا أن نتذكر ما قاله إنجلز: "إنها لسذاجة صبيانية أن يجعل المرء من جزعه الشخصي برهاناً نظرياً".
ومن الطبيعي أن يطرح مآل الحراك الشعبي والانتفاضات الثورية أسئلة تزداد تعقيدا بالارتباط مع "يأس" البعض من رؤية النتائج والثمار الملموسة للاحتجاجات، وقد توهموا أن حركة الجماهير الثائرة يمكن أن تغير الواقع بين عشية وضحاها. ولنا في مثال الثورة الفرنسية، التي حدثت عام 1789، وما أحاطها من عفوية في حركة الثوار، والتباس في المفاهيم، وغموض في البرنامج، ما يمكن أن يضيء المصائر التاريخية للتحول الاجتماعي العاصف. فقد انتهى الأمر، كما نعلم، بهيمنة نابليون بونابرت على السلطة وتحوله الى إمبراطور ظل حاكما مطلقا حتى هزيمة عام 1815، وهي الهزيمة التي فتحت الأبواب للأفكار التنويرية للثورة الفرنسية.
ومن جانب آخر فإن النزعة الفوضوية هي إحدى أخطر النزعات التي تؤدي، من بين عواقب أخرى، إلى حرمان الانتفاضة من القيادة. ومن المعلوم أن معظم الثورات الكبرى، بما فيها الثورة الفرنسية، وكومونة باريس، والثورة الروسية، بدأت تلقائية ثم دخل فيها عنصر التنظيم. غير أن التأمل في هذه الأحداث الثورية وتحليلها بصورة عميقة يظهر، على نحو جلي، أن هناك الكثير من العمل السياسي الذي يقف خلف ما يبدو تلقائياً. ومن بين تجليات عدمية الفوضويين رفضهم لفكرة "القيادة"، إذ يحاولون خلط الأمور، ولا يميزون بين هذا القائد السياسي أو ذاك، واضعين الجميع في سلّة واحدة.
ويقدم الفوضويون أدلة على إخفاق "القيادات الثورية"، التي يرون، عن حق في بعض الحالات، أنها تخلت عن روح القيم الثورية، ووقعت تحت إغراء الامتيازات، بحيث باتت أسيرة للنظام القائم الذي أرادت، أصلاً، الإطاحة به.
ويلفت الانتباه أن الفوضويين يعودون إلى أحداث أيار 1968 في فرنسا، كمثال كلاسيكي على الدور الذي قد يمارسه هذا النمط من القيادات. ففي حين تفجرت حركة عفوية طلابية وعمالية ضد نظام ديغول، لتتحول إلى معارك ثورية في شوارع باريس، التي كانت، قبل ما يقرب من قرن من ذلك الزمان، مسرحا للكومونة، واندلع إضراب عام على مستوى البلاد شارك فيه عشرة ملايين عامل، انهمك القادة "اليساريون" في اتخاذ مواقف انتهازية متخاذلة، أدت، كما يرى الفوضويون، إلى إجهاض الحركة التي كان يمكن أن تطيح بنظام الاستغلال الرأسمالي، وحولوا الحراك الثوري العاصف إلى مجرد طائفة من المطالب المتواضعة، فكان أن أُجهضت الانتفاضة، ومُنيت بهزيمة نكراء، وعاد "الثوار" الى مواقع عملهم "خانعين".
ومن ناحية أخرى يتسم أصحاب الميول الثورية الضيقة والعدمية بروح الاستعجال في قطف الثمار، حتى قبل أن تنضج، وهو سلوك غالبا ما يؤدي بهم إلى اليأس والهزيمة والتخلي عن النضال الثوري، وربما انتقال بعضهم إلى معسكر "الثورة المضادة"، مدافعين عن سلطة الاستبداد التي باتوا خائفين عليها بعد أن كانوا خائفين منها
دروس من كومونة باريس
تعلمنا الماركسية أنه حين تبدأ أعداد غفيرة من الناس بالنشاط فإن أول من يُؤخذوا على حين غرّة هم ليسوا أولئك الذين كافحوا زمنا مديداً، بل الحكام الغافلون، ذلك أن الطبقة الحاكمة أقنعت نفسها بأن المقاومة مستحيلة، على عكس الثوريين القادرين على التنبؤ بالأحداث والمستعدين لها. وهذا غالبا ما يميز ما يسميه ماركس "الثورة الجميلة"، أي اللحظات الأولى للثورة التي يبدو أنها توحد غالبية المجتمع في النضال ضد النظام القديم، وهو ما تجلى عندما اندلعت انتفاضة تشرين بكل عنفوانها، بحيث بدا أن المجتمع كان، بأسره، موحدا وراء شعار واقعي بسيط: "نريد وطن"!
لقد تحدث ماركس في أكثر من موضع حول المشاركة في الثورات العفوية باعتبارها ضرورية، حتى إذا لم تكن الثورة ظافرة، لأن الهدف هو تدريب الشعب على الثورة، والارتقاء به إلى خوض معركة ظافرة.
هذا ما فعله ماركس حيال كومونة باريس (18 آذار 1871) التي يجب أن تظل دروسها ماثلة أمامنا ونحن نقيّم انتفاضة تشرين، وعلينا أن نستعيد، على الدوام، هذه الخبرة التاريخية التي لا غنى عنها.
وعلى الرغم من أن كومونة باريس لم تستمر أكثر من 72 يوماً، حيث سقط آخر مقاتليها يوم 28 أيار، إلّا أنها استطاعت، في هذه الأيام القليلة، أن تقدم أغنى الدروس حول مهمات الإطاحة بالنظام القديم وتحرير المجتمع. وأظهرت الكومونة كيف أن البرجوازية لا تلقي السلاح بل تتشبث بمواقعها وهيمنتها، وتحارب، بكل ضراوة، أية محاولة لبناء المجتمع الجديد.
لم تقف البرجوازية مكتوفة الأيدي وهي ترى الكومونة تهدد سلطة رأس المال، ورأت أن عليها أن تتحد لمواجهة هذا الخطر، فاتحد أعداء الأمس، بسمارك وتيير، لمواجهة عمال باريس.
أما السبب الرئيسي لهزيمة الكومونة فيكمن في عدم وجود تنظيم مستقل للعمال، بينما كانت أفكار بلانكي وبرودون حول وهم خلود الملكية الصغيرة مهيمنة.
فما هي خلاصة خبرة كومونة باريس ؟ وكيف تجلت بطولة ثوار الكومونة؟
كان ماركس، كما أشرنا، قد حذر عمال باريس في خريف عام 1870، أي قبل الكومونة بأشهر عدة، من أن أية محاولة لإسقاط الحكومة ستكون حماقة دفع إليها اليأس. ولكن عندما فرضت المعركة الفاصلة وغدت الانتفاضة واقعاً، حيّا ماركس الثورة البروليتارية بمنتهى الحماس رغم نذر الشر. ولم يصر ماركس على اتخاذ موقف متحذلق لإدانة الحركة "باعتبارها جاءت في غير أوانها"، كما فعل الماركسي الروسي بليخانوف عندما كتب في تشرين الثاني 1905 مشجعاً نضال العمال والفلاحين، ولكنه أخذ يصرخ بعد كانون الأول 1905 على طريقة الليبراليين "ما كان ينبغي حمل السلاح".
ولم يكتف ماركس بالتعبير عن الإعجاب الحماسي ببطولة ثوار الكومونة الذين "هبّوا لاقتحام السماء" حسب تعبيره، بل رأى في هذه الحركة الثورية، على الرغم من إخفاقها في تحقيق غاياتها، خبرة تاريخية ذات أهمية عظمى، وخطوة عملية أهم من مئات البرامج والمناقشات.
ووضع ماركس نصب عينيه مهمة تحليل هذه التجربة واستخلاص الدروس منها، وإعادة النظر في أفكاره على ضوئها. وكان "التصحيح" الوحيد الذي رأى ماركس ضرورة إدخاله على (البيان الشيوعي) مستوحى من الخبرة الثورية لكومونة باريس.
وفي آخر مقدمة للطبعة الألمانية الجديدة من (البيان الشيوعي)، والتي تحمل توقيع المؤلفين: ماركس وإنجلز، بتاريخ 24 كانون الثاني 1872 يقول المؤلفان إن برنامج (البيان الشيوعي) "قد عفا الزمن على بعض تفاصيله". ويضيفان: "لقد أثبتت الكومونة شيئاً واحداً، على وجه الخصوص، وهو أن الطبقة العاملة لا تستطيع، ببساطة، أن تستولي على آلة الدولة الجاهزة وتسخرها لخدمة أهدافها الخاصة".
وهذه الفقرة الأخيرة اقتبسها المؤلفان من كتاب ماركس (الحرب الأهلية في فرنسا). وهكذا اعتبر ماركس وإنجلز أحد الدروس الرئيسية لكومونة باريس يتمتع بأهمية عظمى حملتهما على إدخاله كتصحيح لـ (البيان الشيوعي).
وفي أهدأ المراحل، وكما يبدو، في أكثرها "عذوبة وسذاجة" حسب تعبير ماركس .. في مراحل "الركود الكئيب"، كان ماركس يعرف كيف يشعر باقتراب الثورة، وكيف يرشد البروليتاريا لمعرفة مهماتها.***
مازال الغضب يغلي في الصدور، وقد بلغ السيل الزبى .. وستأتي،لا ريب، رياح تعصف بالرماد، لتتقد، من جديد، جمرة الانتفاضة، وهذه المرة سيكون الاتقاد عاصفا..
أمثولة الشهداء هي التي تضيء نصب الحرية، وتمنح أصواتنا هتاف المستقبل، وأيادينا تحدي أن ترفع الرايات، وتروّي ظمأ أرواحنا العطشى إلى قيامة العراق ..
منتفضو تشرين مازالوا يحملون المشاعل، ويضيئون الدروب، ويمضون في طليعة الكتائب، عائدين إلى الينابيع، وناظرين إلى النجوم، ومتطلعين إلى الضفاف، وحالمين بغد يخسرون فيه أغلالهم .. ينحتون في حجر، ويركبون المخاطر، ويجسّدون القيم السامية، والمثل الملهمة، وجرأة الاقتحام ..