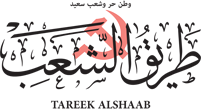ست سنوات مرّت على انتفاضة تشرين، وما زالت شعلة أبنائها وبناتها تنير الوعي الجمعي وتذكّر العراقيين بأن التغيير ممكن، وأن الوطن ليس غنيمة بيد الطغمة الحاكمة بل حق لكل مواطن. لقد كانت تشرين لحظة حقيقية كسرت جدار الخوف وأسقطت شرعية منظومة المحاصصة والفاسد، لتعلن بصوت الشباب والنساء والعاطلين عن العمل أن العراق يستحق حياة تليق بتضحيات شعبه. رفعت شعاراً لم ولن يُمحى "نريد وطن"، الذي لم يكن مجرد هتاف بل مشروع بديل لدولة مدنية عادلة، تستند إلى المواطنة لا إلى الطائفية. اليوم، ورغم القمع والاغتيالات والتضليل الإعلامي، تبقى تشرين صفحة ناصعة في تاريخ العراق الحديث، وصفحة إدانة للمنظومة الحاكمة التي حاولت وأدها. من هنا تأتي مقابلة "طريق الشعب" مع الرفيق جاسم الحلفي لتعيد قراءة تلك اللحظة الثورية، ولتؤكد أن تشرين ليست ذكرى عابرة، بل بداية مسار تغييري لم يكتمل بعد، لكنه حتماً قادم بإصرار الجيل الجديد
في أدناه النص الكامل للقاء:
برأيكم، ما الذي ميّز احتجاجات تشرين 2019 عن الموجات الاحتجاجية السابقة في العراق من حيث الخطاب والمطالب السياسية؟ وهل كانت منفصلة عن سابقاتها؟
لم تكن تشرين منفصلة تماماً، بل جاءت امتداداً نوعياً لما سبقها من احتجاجات (2011، 2015، 2018). لكنها تمايزت عنها بعمق خطابها وشمولها الوطني وجرأتها في رفع شعار تغيير بُنية النظام وإصلاح وظائفه. بهذا المعنى يمكن القول إن تشرين جمعت خيوط التجارب السابقة، وصاغتها في لحظة انفجار كبرى أعادت تعريف الاحتجاج في العراق، كما يمكن تلخيص ما يمزيها عن سابقاتها بعدة عناصر أساسية:
1. ركزت الموجات التي سبقت الانتفاضة في الاغلب على مطالب خدمية أو مطلبية مباشرة: الكهرباء، فرص العمل، مكافحة الفساد. في حين أن تشرين رفعت خطاباً أشمل وأعمق، تجاوز حدود الإصلاح الجزئي إلى المطالبة بتغيير النظام السياسي القائم على المحاصصة، الى نظام يعتمد المواطنة في أساس بنائه.
2. وحدت تشرين فئات متعددة: شباب، طلبة، عمالا، نساء، عاطلين عن العمل، في مشهد عابر للطائفية والمناطقية. هذا ما جعلها تبدو حركة وطنية شاملة لا محلية أو فئوية.
3. خلقت فضاءً ثقافيا ًجديداً، جداريات، شعارات، أغاني، خيما تحولت إلى فضاءات نقاش ووعي سياسي. لم يكن هذا موجوداً بنفس القوة في الموجات السابقة، حيث بقي الاحتجاج محدوداً بأدوات تقليدية.
4. استمراريتها، حيث بلغت أشهراً طويلة، وأنتجت ذاكرة جمعية ورصيداً سياسياً وثقافياً ظل حاضراً بعد انحسارها.
كيف يمكن قراءة شعار "نريد وطن" ضمن أزمة الشرعية السياسية التي تعاني منها منظومة الحكم بعد عام 2003؟
لو حاولنا تفكيك الشعار نكتشف أبعادا مترابطة عدة:
1. أزمة الدولة ككيان جامع، فالشعار لا يطالب بخدمة أو إصلاح قطاعي، بل يضع الوطن نفسه في موقع "المفقود". هذا يعني أن العراقيين لم يعودوا ينظرون إلى الدولة القائمة باعتبارها تجسد "الوطن"، بل باعتبارها سلطة محاصصة فاسدة تُقسِّم المجتمع ولا توحّده. هنا يتضح أن الشرعية لم تتآكل فحسب، بل انقطعت الصلة بين الشعب والدولة بوصفها ممثلة للوطن.
2. رفض شرعية المحاصصة: استمدت طغمة الحكم شرعيتها من صيغة "التوافق الطائفي–الإثني"، اذ يعد رفعهم لشعار "نريد وطن" بمثابة إعلان قطيعة مع شرعية "المكوّنات" ومطالبة بشرعية جديدة تقوم على المواطنة المتساوية.
3. كشفت تشرين أن الشرعية الحقيقية تنبع من الانتخابات الحقيقية والنزيهة بشرطها وشروطها، لا من الصناديق المحكومة بالمال السياسي والسلاح. "نريد وطن" صرخة ضد التلاعب بآليات الشرعية الشكلية، ومطالبة ببديل يستند إلى العقد الاجتماعي لا إلى الصفقات الانتخابية.
4. البعد الطبقي للشعار، حيث هو احتجاج ضد البطالة، الفقر، التهميش. بهذا المعنى هو مطالبة بأن يكون الوطن للجميع لا غنيمة تتقاسمها الطغمة. الشرعية السياسية المهترئة لم تعد قادرة على تلبية أبسط شروط العدالة الاجتماعية، فجاء الشعار ليعيد تعريف الوطن بوصفه مجالاً للحقوق والكرامة، لا مجرد جغرافيا أو سلطة قائمة.
5. "نريد وطن" لم يكن فقط نفياً للشرعية القائمة، بل كان إعلاناً عن شرعية بديلة: شرعية تستند إلى المشاركة الشعبية، السلمية، والمواطنة. هو شعار يؤسس لعقد اجتماعي جديد، ويعلن بوضوح أن نظام المحاصصة استنفد مبررات وجوده.
باختصار، شعار "نريد وطن" هو ترجمة احتجاجية – سياسية لأزمة شرعية شاملة: فقدت المنظومة قدرتها على تمثيل المجتمع.
هل مثّلت الحركة الاحتجاجية امتداداً لمفهوم "المجتمع المدني" في العراق أم شكلت قطيعة معه؟
يمكن قراءة الحركة الاحتجاجية في تشرين 2019 في علاقتها بمفهوم "المجتمع المدني" على مستويين متناقضين: الامتداد والقطيعة.
1. الامتداد: من زاوية، مثلت تشرين امتداداً لأفق المجتمع المدني، خصوصًا كما تبلور بعد 2003 عبر المنظمات غير الحكومية وشبكات النشاط الحقوقي والثقافي. فقد اعتمدت على أشكال التنظيم الأفقي، وعلى المبادرات التطوعية (خيم، إغاثة طبية، أنشطة ثقافية)، وهي كلها سمات تُعد جزءا ًمن بنية المجتمع المدني. كذلك، حملت الشعارات قيماً مرتبطة بالمجتمع المدني: المواطنة، السلمية، حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية. بهذا المعنى، كانت تشرين استعادة للطاقة المدنية في أوسع معانيها.
2. القطيعة: كانت تشرين أيضاً قطيعة مع المجتمع المدني الرسمي الذي نشأ بعد 2003، والذي ارتبط غالباً بالتمويل الخارجي وبالعمل في إطار محدود لا يمس جوهر السلطة. كثير من منظمات المجتمع المدني بدت بعيدة عن الساحات، أو مترددة في الانخراط، بل أحياناً متماهية مع خطاب "الإصلاح الجزئي". في هذا السياق، عبّرت تشرين عن مجتمع مدني موازٍ، أكثر جذرية وأقرب إلى الناس، متحرر من البيروقراطية والتمويل المشروط، قائم على التضامن المباشر بين المحتجين أنفسهم.
3. المعنى الجدلي: يمكن القول إن تشرين لم تكن مجرد امتداد ولا مجرد قطيعة، بل جدل جديد: فهي من جهة أعادت الروح لمفاهيم المجتمع المدني (التنظيم، السلمية، المطالب الحقوقية)، ومن جهة أخرى تجاوزت صورته التقليدية/ المؤسسية لتتحول إلى مجتمع مدني احتجاجي، هي تقع ضمن نطاق الحركات الاجتماعية الجديدة، حيث مثّلت ولادة "مجتمع مدني من نوع آخر"، ليس المجتمع المدني المُدجَّن الذي تكيف مع نظام ما بعد 2003، بل مجتمع مدني، شبابي، أفقي، ووطني النزعة. بهذا المعنى، هي امتداد للروح المدنية وقَطيعة مع أشكالها التقليدية في آن واحد.
خلاصة القول الانتفاضة هي حركة اجتماعية بالمعنى الذي يطرحه علم الاجتماع السياسي، وتقع بالتحديد ضمن نطاق الحركات الاجتماعية الجديدة، كما انها ثورة سلمية غير مكتملة الشروط، كسرت جدار الخوف، وطرحت مطلباً جذرياً بتغيير النظام، اتخذت السلمية هويةً وأداةً للمواجهة، لكنها بقيت عاجزة عن التحول إلى مشروع منظم بسبب غياب القيادة والبرنامج، ضعف الامتداد الطبقي، والقمع الدموي. فيما اكتفى العالم بالتوثيق والإدانة. وهكذا، غيّرت تشرين الوعي السياسي والاجتماعي وأعادت تعريف الوطنية، لكنها لم تمتلك بعد أدوات إنجاز التغيير الجذري.
ما دلالات المشاركة الواسعة للشباب والنساء في إعادة رسم صورة الحركات الاحتجاجية في العراق؟
حلمت المشاركة الواسعة للشباب والنساء في انتفاضة تشرين 2019 دلالات عميقة، ليس فقط في حجمها العددي بل في نوعيتها، وما أفرزته من تحولات في صورة الحركات الاحتجاجية بالعراق:
1. كسر الهيمنة الذكورية والسياسية التقليدية: لأول مرة، برزت النساء كعنصر أساسي في ساحات الاحتجاج، ليس فقط كداعمين، بل كمشاركات وقياديات ومنظّمات. هذا الحضور أعاد رسم صورة الساحة السياسية والاجتماعية، وكسر الصورة النمطية عن السياسة كحقل ذكوري محتكر.
2. ولادة جيل سياسي جديد: كان الشباب كالعمود الفقري للحركة. أكثر من 60% من سكان العراق هم من فئة الشباب، وتشرين مثّلت أول ظهور واسع لهم كفاعل مستقل خارج أطر الأحزاب. هذا أعطى الاحتجاجات طابعاً شبابياً واضحاً، شعارات مبتكرة، أشكال تعبير جديدة (جداريات، أغاني، مسرح الشارع)، وأدوات تنظيم أفقية لا هرمية.
3. تجذير الطابع السلمي: حضور النساء والشباب عزّز الطابع السلمي للاحتجاجات. وجود النساء في الساحات فرض، بشكل غير مباشر، ضبطاً ذاتياً على أي ميل نحو العنف، وحوّل الاحتجاج إلى حدث مدني ـ سلمي جامع، يصعب على السلطة شيطنته بالكامل.
4. المشاركة الواسعة لهاتين الفئتين حولت الوطن إلى قضية اجتماعية ملموسة، لا مجرد فكرة سياسية عامة.
5. دلالة هذه المشاركة أنها أعادت تشكيل صورة الحركة الاحتجاجية في العراق: من فعل احتجاجي تقليدي يقوده ناشطون محدودون، إلى حركة جماهيرية شابة ـ مدنية ـ سلمية، تحمل في طياتها بذور مجتمع جديد يتخطى الطائفية والذكورية، ويضع العدالة والمواطنة في المقدمة.
هل عكست تشرين تحولات في القيم الاجتماعية والسياسية لدى الجيل الجديد مقارنة بالجيل الذي عاصر أحداث 2003؟
نعم، 2019 عكست بوضوح تحولات في القيم الاجتماعية والسياسية لدى الجيل الجديد مقارنة بالجيل الذي عاصر أحداث 2003. يمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي:
1. من الطائفية إلى المواطنة: اذا كانت الأجيال التي والت وتحزبت للقوى المتنفذة، تشرّبت بخطاب "المكوّنات" بوصفه إطاراً منظّماً للحياة السياسية. فجيل تشرين كسر هذه البنية، ورفع شعارات عابرة للطوائف والمناطق، متمحورة حول مفهوم الوطن والمواطنة المتساوية.
2. أعلن جيل تشرين قطيعته مع القوى المتنفذة، واعتبرها هي المشكلة لا يمكن ان تقدم حلولاً للازمة.
3. من العنف إلى السلمية: تمسّك جيل تشرين بخيار السلمية كهوية سياسية وأداة للتغيير، ليبرهن أن قوة المجتمع ليست في السلاح الذي تستقوي به المليشيات بوجه الشعب.
4. أعاد جيل تشرين تعريف السياسة بوصفها حياة يومية، حولوا السياسة إلى ممارسة ثقافية ـ مدنية تعكس رؤية مختلفة للوطن.
كيف تقيّمون طبيعة البنية التنظيمية لاحتجاجات تشرين؟
يمكن تقييم البنية التنظيمية لاحتجاجات تشرين 2019 من خلال ثلاث سمات رئيسية:
1. الأفقية بدل الهرمية: لم تكن تشرين حركة تقليدية تقودها قيادة مركزية أو زعامة محددة، بل اعتمدت على التنظيم الأفقي، أي أن القرارات والأنشطة وُلدت من داخل الساحات نفسها عبر لجان تطوعية وخيم تنسيقية. هذا أعطاها مرونة عالية وجعل من الصعب اختراقها أو استهدافها عبر رأس واحد. لكنه في المقابل جعلها تفتقد آلية تفاوض موحدة أو برنامجا سياسيا واضحا.
2. عفوية منضبطة: رغم انطلاقها بشكل عفوي، فإن الاحتجاجات سرعان ما نظمت نفسها داخلياً. ظهرت خيم متخصصة (طبية، إعلامية، ثقافية، لوجستية)، وبرزت مبادرات شبابية تدير الخدمات داخل الساحات: من إطعام المحتجين إلى تنظيف الشوارع وتقديم الدعم النفسي. هذا التنظيم الذاتي عكس قدرة المجتمع على إنتاج بدائل عن الدولة، ولو مؤقتاً.
3. التشبيك: بنية تشرين كانت شبكية الطابع، تستند إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات وتنظيم الفعاليات، أكثر من اعتمادها على مؤسسات رسمية أو تنظيمات حزبية. هذا الطابع منحها قدرة سريعة على الانتشار من بغداد إلى المحافظات الجنوبية، وخلق "عدوى احتجاجية" يصعب السيطرة عليها.
4. بنية تشرين التنظيمية كانت مزيجاً من العفوية الشعبية والإبداع الذاتي والشبكية الأفقية. هذه العناصر جعلتها لحظة انفجارية فارقة، لكنها كشفت في الوقت ذاته الحاجة إلى تحويل التنظيم الأفقي العفوي إلى قوة سياسية واجتماعية مستدامة قادرة على الاستمرار بعد الساحات.
ما أوجه القوة والضعف في غياب قيادة مركزية واضحة للحركة؟
غياب القيادة المركزية الواضحة في احتجاجات تشرين كان له وجهان: قوة وضعف في آن معاً.
أولا- أوجه القوة:
1. الحماية من الاستهداف: لم يكن هناك رأس يمكن للسلطة أن تقطعُه بسهولة، ما صعّب مهمة تفكيك الحركة عبر الاعتقالات أو الاغتيالات.
2. المرونة والتكيّف: الأفقية سمحت للساحات أن تبتكر أشكالاً متعددة من الاحتجاج والتنظيم، دون انتظار توجيهات عليا.
3. توزيع المبادرة: كل ساحة وكل خيمة كانت قادرة على أن تكون مركزاً للإبداع والقرار، ما أعطى زخماً واسعاً للحركة.
4. كسب الشرعية الشعبية: غياب الزعامات التقليدية عزّز صورة تشرين كحركة "من الناس وللناس"، وليست مجرد امتداد لنخبة حزبية.
ثانيا- أوجه الضعف:
1.غياب البرنامج الموحد: تعدد المبادرات والشعارات جعل من الصعب صياغة رؤية سياسية متفق عليها، ما سمح للسلطة بالمناورة.
2. محدودية القدرة التفاوضية: لم يكن هناك طرف معتمد يمثل المحتجين أمام الحكومة أو المجتمع الدولي.
3. صعوبة الاستمرارية: الأفقية أعطت الزخم لحظة الانفجار، لكنها لم تتحول إلى بنية تنظيمية قادرة على الاستمرار بعد انحسار الساحات.
4. اختلاف الأولويات: تنوع الساحات والفاعلين أدى أحياناً إلى تباينات في الخطاب، ما شتّت وحدة المطلب السياسي.
اخيراً: غياب القيادة المركزية كان درع حماية للحركة في وجه القمع، لكنه في الوقت ذاته كان ثغرة سياسية جعلت من الصعب تحويل القوة الاحتجاجية إلى مشروع تغييري مستدام. تشرين أثبتت أن الأفقية سلاح فعال في لحظة الانفجار، لكنها تحتاج إلى تكامل مع بنية تنظيمية واضحة حتى تُترجم التضحيات إلى إنجاز سياسي.
كيف أثّر التوتر الإقليمي، ولا سيما الصراع الأميركي ـ الإيراني، على مسار احتجاجات تشرين؟
تأثير التوتر الإقليمي، ولا سيما الصراع الأميركي ـ الإيراني، على مسار احتجاجات تشرين 2019 كان عميقاً ومتعدد المستويات:
1. محاولة تشويه الحراك، حاولت السلطة وأذرعها الإعلامية منذ البداية تشويه الانتفاضة، حيث اتُّهمت بأنها "مدعومة أميركياً" بهدف إفراغها من بعدها الوطني والاجتماعي.
2. انشغال السلطة العراقية بالتوازن بين واشنطن وطهران جعلها أقل قدرة (وربما أقل رغبة) في الاستماع إلى المطالب الاجتماعية والسياسية للمنتفضين. الأولوية تحولت إلى إدارة الصراع الإقليمي على الأرض العراقية، فيما تُركت ساحات تشرين تحت القمع والاغتيالات.
3. تعزيز البعد الوطني للحراك: المفارقة أن هذه التدخلات الخارجية زادت من وطنية الخطاب التشريني.
شعار "نريد وطن" كان، في أحد أبعاده، رفضاً لتحويل العراق إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران. الشباب رفعوا هويتهم الوطنية بديلاً عن ارتهان القرار العراقي للمحاور.
4. نتائج مزدوجة: من جهة، الصراع الأميركي ـ الإيراني ضيّق مساحة الحركة الاحتجاجية وأعطى للسلطة ذريعة إضافية لقمعها، من جهة أخرى، عزّز إصرار المحتجين على أن التغيير يجب أن يكون عراقياً خالصاً، لا نتاج صفقة إقليمية أو دولية.
ما طبيعة تعامل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مع الانتهاكات التي رافقت الحركة الاحتجاجية؟
تعامل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مع الانتهاكات التي رافقت احتجاجات تشرين 2019 كان ذا طبيعة مزدوجة، يجمع بين الإدانة المبدئية والقصور العملي: المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أدّوا دوراً في التوثيق والإدانة، لكنهم فشلوا في توفير آليات حماية ومساءلة. النتيجة أن المحتجين شعروا أن صوتهم أوضح من أي وقت مضى، لكن حمايتهم أضعف من أن تصمد أمام آلة القمع. تعاطي المجتمع الدولي أظهر أن المصالح الجيوسياسية (التوازن الأميركي ـ الإيراني، واستقرار سوق النفط) كانت تتقدم على حقوق الإنسان .أما المنظمات الحقوقية، فرغم دورها التوثيقي المهم، فقد بقي تأثيرها محدوداً في ظل غياب ضغط سياسي دولي متماسك.
هل يمكن النظر إلى تشرين بوصفها جزءاً من موجة احتجاجات إقليمية أوسع مثل لبنان وإيران والسودان؟
نعم، يمكن النظر إلى انتفاضة تشرين 2019 بوصفها جزءاً من موجة احتجاجات إقليمية أوسع، لكن مع خصوصيتها العراقية.
1. تشابه المسارات:
• لبنان (2019): رفع المحتجون هناك شعارات ضد الطائفية والفساد، وطالبوا بدولة مدنية، في مشهد يشبه إلى حد كبير شعارات تشرين.
• إيران (2019): اندلعت احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى رفض شامل للفساد والقمع السياسي، وهو ما يوازي انتقال المطالب العراقية من الخدمات إلى النظام.
• السودان (2018–2019): الحراك بدأ بسبب أزمات المعيشة، لكنه انتهى بمطلب تغيير النظام السياسي، وهو ما يشبه مسار تشرين من مطلب الكهرباء والوظائف إلى شعار "نريد وطن".
2. المشتركات
•تشترك جميع هذه الحركات في طابعها الشبابي واستخدامها للساحات العامة بوصفها فضاءات سياسية ـ ثقافية.
• ركزت على العدالة الاجتماعية، ورفضت المحاصصة والهويات الطائفية أو الإثنية.
• رفعت شعار السلمية في مواجهة أنظمة تلجأ إلى العنف والقمع.
3. البعد المقارن:
يمكن القول إن تشرين جزء من "زمن احتجاجي عربي ـ إقليمي" ظهر بعد 2011، لكن بموجة ثانية أكثر وعياً بالسلمية وأكثر جذرية في مطالبها. هذا يجعلها حلقة في سلسلة ممتدة، لا حدثاً معزولاً.
هل أفرزت تشرين بنية سياسية أو اجتماعية قادرة على الاستمرار، أم أنها بقيت لحظة تاريخية عابرة؟
لم تبقَ تشرين مجرد لحظة عابرة، لكنها أيضاً لم تنجح في أن تصبح بنية سياسية راسخة بالمعنى الكلاسيكي. يمكن القول إنها أفرزت بذوراً: شبكات، قيما، لغة سياسية جديدة، وجيلا كاملا مؤمنا بالتغيير السلمي. هذه البذور لم تُزهر بالكامل بعد، لكنها تمثل رصيداً استراتيجياً لأي موجة احتجاجية قادمة. بمعنى آخر، تشرين لحظة مستمرة في الذاكرة والقيم، لكنها مؤجَّلة في البنية والتنظيم.
ما الدروس التي يمكن أن تستخلصها القوى الوطنية من تجارب تشرين بين الإخفاقات والإنجازات؟
يمكن تلخيص الدروس التي ينبغي أن استخلاصها بالآتي:
• كسر جدار الخوف: تشرين أثبتت أن الشارع قادر على تحدي سلطة غارقة في الفساد والقمع، وأن الإرادة الشعبية يمكن أن تفرض حضورها رغم آلة الرصاص.
• ولادة لغة سياسية جديدة: شعار "نريد وطن" وحّد الفئات الاجتماعية، ونقل النقاش من إصلاح جزئي إلى إعادة بناء النظام على أسس المواطنة والعدالة.
• السلمية كقوة: الالتزام بالأساليب السلمية منح الانتفاضة شرعية أخلاقية ومجتمعية، وفضح عنف السلطة أمام الداخل والخارج.
• تشكيل ذاكرة جمعية: الدماء التي سالت، الجداريات، والشعارات رسخت في الوعي العام، لتصبح تشرين مرجعاً لا يمكن تجاوزه في أي حديث عن التغيير.
• غياب التنظيم السياسي المستدام: الأفقية منحت قوة لحظة الانفجار، لكنها لم تتحول إلى إطار تنظيمي يضمن الاستمرارية بعد الساحات.
• العجز عن بلورة قيادة وبرنامج: لم تتمكن تشرين من إنتاج قيادة سياسية معترف بها ولا برنامج موحد، ما سهّل على السلطة الالتفاف والمناورة.
• العزلة عن القوى الاجتماعية التقليدية: رغم حضور الشباب والنساء بقوة، بقيت العلاقة ضعيفة مع النقابات، الاتحادات، وقطاعات واسعة من العمال والفلاحين.
• هشاشة الحماية الدولية: ورغم التضامن الحقوقي، لم تستطع الحركة استثمار الانتهاكات لفرض ضغط خارجي فعّال على السلطة.
• الانتقال من العفوية إلى التنظيم: ضرورة تحويل الطاقات الشبابية والاحتجاجية إلى أطر سياسية ـ اجتماعية مستقلة ذات برنامج واضح.
• الربط بين الطبقي والوطني: لا يكفي رفع شعار الوطن العام، بل يجب ربطه بمطالب العدالة الاجتماعية، فرص العمل، والمساواة، لتوسيع القاعدة الشعبية.
• بناء تحالفات اجتماعية أوسع: إشراك النقابات والطبقات العاملة والموظفين والطلاب في مشروع تغييري منظم، لتجنب عزل الانتفاضة.
• استثمار السلمية كقوة استراتيجية: الحفاظ على الهوية السلمية، مع تطوير أدوات حماية ذاتية للمتظاهرين تردع العنف وتكشفه للرأي العام.
• إنتاج قيادة جماعية بديلة: لا تقوم على الزعامة الفردية، بل على التنسيق بين لجان مستقلة، بحيث تبقى محصنة من الاختراق والقمع، وقادرة على التفاوض والتأثير.
برأيكم، هل من الممكن أن نشهد "تشرين ثانية" في المستقبل، وإذا كان ذلك وارداً فما ملامحها المتوقعة؟
نعم، من الوارد أن نشهد "تشرين ثانية" في المستقبل، لكن ملامحها ستعتمد على طبيعة التفاعلات بين الأزمات البنيوية والوعي الشعبي.
1. دوافع عودة الاحتجاج
الأزمات المستمرة: البطالة، الفقر، انهيار الخدمات، وتفشي الفساد لم تجد حلولاً جذرية بعد. هذه عوامل كامنة كفيلة بتفجير موجة جديدة في أي لحظة.
تراكم الوعي: تشرين الأولى زرعت ثقافة احتجاجية، وأنتجت ذاكرة جمعية تجعل أي جيل جديد يستلهمها كنموذج، لا كاستثناء.
انسداد الأفق السياسي: عجز النظام عن تقديم إصلاح حقيقي، واستمرار منطق المحاصصة، يعني أن الأسباب البنيوية للاحتجاج لم تُعالج.
• ملامح "تشرين ثانية" المتوقعة
• أكثر تنظيماً: الدرس الأبرز من تشرين الأولى هو الحاجة إلى تحويل العفوية إلى بنية منظمة. قد نشهد لجاناً أكثر تنسيقاً أو أشكالاً من القيادة الجماعية.
• خطاب أوضح: بدلاً من الشعارات العامة، قد تتبلور مطالب محددة (قانون انتخابي، دستور جديد، ضمان اجتماعي) تجعل الحراك أكثر قدرة على التفاوض.
• طابع وطني أوسع: تشرين الأولى نجحت في تجاوز الطائفية، و"تشرين ثانية" قد تذهب أبعد، لتؤسس جبهة وطنية عابرة لكل الانقسامات.
• استمرار السلمية: بعد أن ثبتت السلمية كهوية، من المرجح أن تبقى الخيار الأول، مع تطوير أدوات حماية ذاتية تكشف عنف السلطة وتقلّل الخسائر.
• الحضور الطبقي: يمكن أن تكون المشاركة المقبلة أكثر وضوحاً من جانب الطبقات العاملة والموظفين والطلاب، ما يضيف بعداً اقتصادياً صريحاً.
2. التحديات
• القمع الدموي: السلطة ستلجأ مجددًا إلى العنف، وربما أشد من السابق.
• محاولات الاحتواء: عبر الانتخابات أو التنازلات الجزئية.
• الضغط الإقليمي والدولي: الصراع الأميركي ـ الإيراني قد يحاول مرة أخرى اختطاف أي موجة احتجاجية.
• "تشرين ثانية" ليست احتمالاً بعيداً، بل هي استحقاق مؤجل تفرضه طبيعة الأزمة العراقية. لكن نجاحها لن يكون في مجرد النزول إلى الساحات، بل في تحويل الزخم الشعبي إلى بنية سياسية واجتماعية مستدامة قادرة على فرض التغيير.
برأيكم، هل انتهت الحركة الاحتجاجية أم أنها تحوّلت إلى طاقة كامنة قد تنفجر بصيغة جديدة؟
الحركة الاحتجاجية في العراق، لم تنتهِ بالمعنى التاريخي، بل تحوّلت إلى طاقة كامنة تترقب اللحظة المناسبة للانفجار من جديد. تشرين لم تُهزم تماماً ولم تنتصر كاملاً، بل تحوّلت إلى رصيد احتجاجي مؤجل. يمكن القول إنها لحظة لم تُغلق، بل استُودِعت في ذاكرة الأجيال كطاقة كامنة تنتظر لحظة الانبعاث، ربما في صيغة أوسع، وأكثر وعياً وعمقاً.
ما الذي يمكن أن تتعلمه الأجيال القادمة من تشرين في ضوء حملات التشويه والقمع الذي واجهته؟
تشرين ليست مجرد احتجاج عابر، بل مدرسة كبرى. علّمت أن السلمية قوة تمنح الشرعية، وأن العفوية بلا تنظيم تُجهض الزخم مهما كان عظيماً. أوضحت أن مواجهة الدعاية تحتاج إلى وعي نقدي وخطاب واضح، وأن البعد الوطني الجامع شرط لنجاح أي حركة تغيير.
دماء الشهداء لم تكن هزيمة، بل ذاكرة جمعية تحفظ استمرارية المعركة. وتجربة تشرين أظهرت أيضاً خطورة العزلة، مؤكدة أن التغيير يتطلب تحالفاً اجتماعياً واسعاً يضم الشباب، النقابات، والطبقات العاملة.
تشرين تختصر معادلة التغيير: سلمية + وعي نقدي + تنظيم + تحالفات وطنية. هكذا وحده يمكن أن تتحول التضحيات إلى قوة تدفع المستقبل نحو وطن حر وعادل.
هل يمكن الحديث عن إمكانية ولادة "تشرين ثانية"، وبأي ملامح مختلفة عن 2019؟
تشرين ثانية: استحقاق مؤجَّل..
إمكانية تجدد تشرين واردة بقوة، فالأزمات الكبرى – فساد، بطالة، تدهور الخدمات، انسداد الأفق – ما زالت بلا حلول، ووعي جيل 2019 لم يختفِ بل نضج. لكن أي موجة جديدة لن تكون نسخة مكررة، ستأتي أكثر تنظيماً، بخطاب أوضح، وبُعد طبقي واجتماعي أشد وضوحاً، مع أدوات حماية وإعلام بديل، وموقف وطني صلب يرفض وصاية الخارج. في المقابل، ستواجه تحديات أعنف: قمع دموي أسرع، التفاف سياسي أذكى، وخطر الانقسام الداخلي إن لم تُبْنَ تحالفات مجتمعية واسعة.
"تشرين ثانية" ليست احتمالًا عابراً بل استحقاقاً مؤجَّلاً. الفارق الحاسم سيكون في قدرة القوى الوطنية والشبابية على تحويل الغضب إلى مشروع تغييري مستدام لا مجرد انفجار عفوي آخر.