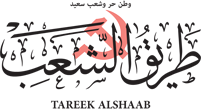ظهر المفهوم الحديث للخصخصة في عام 1923 كسياسة اقتصادية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، واكتسب مصطلح الخصخصة أهمية كبيرة بإعلان رئيس وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر سياسات الخصخصة في إنجلترا. ويؤكد عالم الاقتصاد ميلتون فريدمان أن الخصخصة هي النظام المثالي للرأسمالية، وفي رأيه أن الخصخصة تؤدي إلى زيادة الكفاءة والمنافسة، والتنافس بين الشركات يؤدي إلى جذب العملاء وتحقيق الأرباح.
وقد بدأت أول عملية خصخصة في العالم في عام 1676 بسماح بلدية نيويورك لشركة خاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.
والخصخصة في الاقتصاد عملية تحول شامل في النشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص في امتلاك وإدارة وسائل الإنتاج. أي انتقال الأنشطة الإنتاجية السلعية والخدمات العامة، المملوكة للدولة والخاضعة لنشاط القطاع العام إلى الأفراد والشركات الخاصة المحلية والأجنبية. والخصخصة بوصفها مجموعة من السياسات المتكاملة التي تعتمد على آليات السوق، والمنافسة والقطاع الخاص، فإنها تقوم على إقصاء دور الدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي والتخطيط والتوزيع، وتنهي دور الدولة في توفير السلع والخدمات العامة، وقيام الشركات الخاصة بدور الدولة في إدارة الأنشطة الاقتصادية وتوفير السلع والخدمات.
وقد اجتاحت موجة الخصخصة العالم في العقد التاسع من القرن العشرين وكانت أمريكا وإنجلترا من أوائل الدول التي طبقت الخصخصة ولحقت بها دول متقدمة، كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكندا، ومن ثم انتقلت إلى البلدان النامية وأصبحت ظاهرة عالمية.
فالبلدان الرأسمالية التي طبقت الخصخصة، قامت بتحويل ملكية قطاع الدولة إلى الشركات الخاصة وهذا التوجه ينسجم مع طبيعة النظام الرأسمالي، الذي تكون فيه وظيفة الدولة حارسة لمصالح الطبقات الرأسمالية، وتصبح الوظيفة الرئيسية للدولة القيام بالوظائف التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي والدبلوماسية وجباية الضرائب وفرض القانون وما شابه ذلك.
وتقتضي مفردات الخصخصة بانتقال الملكية العامة والخدمات، من المؤسسات الحكومية (القطاع العام) إلى القطاع الخاص، وإدخال آليات العرض والطلب والمنافسة إلى اقتصاد الدولة.
ففي البلدان الرأسمالية المتقدمة كان الدافع الأساسي للخصخصة منطلقًا، من مقولة أن الدولة ليست أفضل رب عمل، والقطاع الخاص بمرونته ونزعته الجامحة إلى الربح السريع يشكل الحافز الرئيسي لتطور الإنتاج، ويصبح مؤهلًا لتأمين القدرة التنافسية بين المنشآت الاقتصادية الكبيرة. ونستنتج من ذلك أن الخصخصة وفقًا لما يؤكده عالم الاقتصاد آدم سميث، توجه رأسمالي نحو اقتصاد السوق الذي يحقق التوازن الاقتصادي بتفاعل قوى الطلب والعرض. غير أن الحقائق والوقائع تدحض هذا التصور، وتؤكد أن اقتصاد السوق منذ نشوء الرأسمالية قبل 400 عام وحتى الوقت الحاضر لم يحقق التوازن المطلوب لا في الأسواق ولا في الأسعار، وأن الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي، دليل على اختلال التوازن الاقتصادي. وأن المشكلة الحقيقية تكمن في طبيعة النظام الرأسمالي المولد للأزمات.
وتقوم الخصخصة وفقاً لرؤية صندوق النقد والبنك الدوليين على تحليل مفاده أنه لكي تتجنب البلدان المدينة إشكالات خدمة ديونها الخارجية ومشاكل موازين مدفوعاتها، ينبغي عليها إعادة هيكلة اقتصاداتها ولإنجاز هذه العملية، يجب أن تلتزم البلدان المدينة بتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يحددها صندوق النقد الدولي والتي تكون الخصخصة أهم مكوناتها الرئيسية. وبذلك تكون الخصخصة أحد شروط صندوق النقد الدولي التي يفرضها على البلدان المدينة، والعراق أحد البلدان المثقلة بمديونية خارجية تتجاوز الـ 80 مليار دولار. ولهذا فإنه ملزم بتنفيذ ما يعرف بوصفة صندوق النقد الدولي للإصلاح والتكيف الهيكلي، والتي أثبتت في كثير من البلدان أنها ليست وصفة للإصلاح والتعمير وإنما وصفة لتدمير الاقتصادات المدينة وإغراقها في مستنقع الديون الخارجية وكماشة صندوق النقد الدولي التي يصعب الإفلات منها.
الخصخصة في الاقتصاد العراقي
إن توجّه الدولة العراقية ونهجها الاقتصادي هو الانتقال نحو اقتصاد السوق الرأسمالي الحر، ومنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في إدارة الاقتصاد، وإعادة هيكلته على أسس رأسمالية لتلبية أوامر صندوق النقد الدولي والتي تكون الخصخصة أهم مكوناتها الرئيسية.
والخصخصة في العراق هي المصطلح الذي تستخدمه السلطات لتضليل المواطنين عن عملية النهب والاستيلاء على المشاريع والمؤسسات والممتلكات العامة للدولة، وبيعها للقطاع الخاص الذي هو عبارة عن حفنة من الطفيليين والسماسرة المرتبطين بنظام المحاصصة الطائفية. فالمستثمرون المفترضون بقطاع الكهرباء والمؤسسات الصناعية الأخرى ينتظرون الحصول على منشآت ومؤسسات جاهزة بعقود ومبايعات شكلية، وفقاً لتقاسم الغنائم والمحاصصة والتوازنات الطائفية.
والخصخصة التي يجري الترويج لها في العراق هي أحد شروط صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وإلغاء الدور الاقتصادي للدولة، وتقليص فرص العمل في القطاع العام والتوجه نحو خصخصته. وبذلك تصبح الخصخصة إذعاناً للتدخل الخارجي ومصادرة للقرار الوطني العراقي.
ونستنتج من ذلك أن هدف الخصخصة هو تصفية القطاع العام أو ممتلكات الدولة، وإعادة الاعتبار إلى الليبرالية والعولمة، وتقديمها على الفكر الاشتراكي الماركسي. والخصخصة في المحصلة النهائية، عملية بيع ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في العملية الاقتصادية. ويعني ذلك الاعتماد الكلي على آلية السوق لتحديد سقوف الإنتاج، وكيفية التوزيع وتحفيز النشاط الاقتصادي.
والجانب السلبي في فلسفة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة العراقية في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي هو أن الإصلاحات تتم بتدخل مباشر من صندوق النقد الدولي، وهو الذي يقوم بوضع برامج الإصلاحات ويشرف على تنفيذها وتصبح الحكومة العراقية مسؤولة عن تنفيذ هذه الوصفة وتتحمل الفشل والإخفاق الذي يرافق هذه العملية.
إن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق والأزمة السياسية التي تهدد بكافة الاحتمالات تجبر الحكومة على العمل بهدوء لتهيئة المناخ السياسي الملائم لإعلان خصخصة كافة مؤسسات القطاع العام، وهي لهذا الغرض قد عمدت إلى إهمال مؤسسات القطاع العام الصناعية وعدم تأهيلها بوسائل الإنتاج الحديثة بقصد إفشالها لتكون ذريعة لتصفية القطاع العام وبيعه إلى الشركات الخاصة. وبذلك تعبد الطريق للسير الحثيث نحو اقتصاد السوق الرأسمالي لخدمة الفئات الطفيلية وتعزيز ارتباطها بالرأسمال الأجنبي.
إن الأهداف الحقيقية للخصخصة هي خدمة المصالح الطفيلية والتعجيل ببيع الاقتصاد العراقي إلى الشركات الاحتكارية، وجعل العراق بلدًا متخصصًا بإنتاج النفط الخام لتأمين متطلبات الصناعات الرأسمالية، وإبقائه سوقًا مفتوحة لاستهلاك السلع والبضائع المنتجة في البلدان الرأسمالية والإقليمية. وما يعزز هذا التوجه أن بعض القوى المهيمنة على السلطة هي أداة نموذجية لتنفيذ هذه السياسة وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.
وقد أدت الخصخصة التي طبقتها حكومة العراق إلى تدمير قطاع الصناعة الوطنية وتخريب قطاعات الزراعة والصحة، والتعليم والقطاعات الخدمية الأخرى، كالكهرباء والنقل وغير ذلك من المرافق الحيوية. وتحول العراق إلى سوق استهلاكي للسلع والبضائع الأجنبية. ويعتمد اعتمادًا شبه كلي في تمويل احتياجاته المعيشية على الاستيراد الخارجي، مما يؤدي إلى استنزاف أكثر من 50 مليار دولار سنويًا. وامتدت تداعيات الخصخصة إلى تدمير العملة الوطنية، حيث انخفضت قيمة العملة العراقية من 3.36 دولار للدينار العراقي الواحد في عام 1982 إلى 1145 دينارًا للدولار الواحد في عام 2025. وارتفعت مديونية العراق الخارجية إلى نحو 80 مليار دولار والمديونية الداخلية إلى أكثر من 92 تريليون دينار. وبالمقابل ارتفعت معدلات البطالة إلى 20% ونسبة الفقر إلى 25%. وكل يوم يستقبل سوق العمل الكثير من العاطلين، وبالأخص الكفاءات العلمية، إضافةً إلى جيوش المتسولين وشيوع الفساد المالي والإداري والرشاوى في دوائر الدولة، وانتشار الجريمة والسرقة والانحرافات الاجتماعية الأخرى.
فشل الخصخصة عالميًا
لقد فشلت الخصخصة فشلاً ذريعًا في البلدان التي قامت بتطبيقها. مثل روسيا وتركيا وماليزيا وباكستان واليونان ومصر والأردن والمغرب وتونس وكازاخستان وغيرها من البلدان الأخرى. وحتى الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لم تنقذها الخصخصة من الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف بنظامها الرأسمالي. لأن الخصخصة تقوم على إلغاء دور الدولة المهم في عملية التخطيط والإصلاح الاقتصادي والمالي. ورغم أن البلدان الرأسمالية الغربية تبنّت نهج الخصخصة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، غير أن الكثير منها، أعاد النظر في جدوى إبقاء المرافق الحيوية بيد القطاع الخاص، بعد أن أيقنت أن الخصخصة والقطاع الخاص ليس الأفضل في المزايا التي يقدمها القطاع العام. والتجأت إلى إعادة تأميم عدد من الخدمات العامة بعد فشل خصخصتها. ففي فرنسا ألغت بلدية باريس في عام 2010 عقد الامتياز مع الشركات الخاصة لإدارة المياه وأعادت خدمة المياه إلى الشركة العامة التابعة للبلدية.
وفي بريطانيا، اضطرت الحكومة إلى إعادة تأميم جزء من سكك الحديد، بعد فشل شركة خاصة في إدارتها، وأعادت تقييم عقود خصخصة قطاع المياه التي أدت إلى تراجع الاستثمار وارتفاع الفواتير. وقد استعادت مدن أوروبية عديدة الخدمات إلى القطاع العام عبر إنهاء عقود الخصخصة الطويلة الأمد.
وتشير تجارب الخصخصة التي طبقت في مناطق العالم إلى تنامي الرفض الشعبي للخصخصة. فقد أظهرت الدراسات التي أجريت حول جدوى برامج الخصخصة، أن مستوى التأييد للخصخصة في أمريكا اللاتينية انخفض من 75% في عام 1975 إلى 35% في عام 2002. وفي أفريقيا شبه الصحراء أكدت نتائج مسح 15 بلدًا طبق الخصخصة أن نسبة الذين رفضوا فكرة الخصخصة 65%، وفي بلدان الشرق الأوسط وأوروبا أظهر المسح الذي أجري في 8 بلدان أن 67% من السكان رفضوا الخصخصة، وفي جنوب آسيا أن نسبة 80% من السكان يعتقدون بأن مستوى معيشتهم قد تدهور بعد تطبيق الخصخصة.
الآثار السلبية للخصخصة
تتعدد وتتنوع الآثار السلبية للخصخصة، وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن جميع الدول التي اتبعت نهج الخصخصة لم تحقق أي تقدم يُذكر على صعيد الاقتصاد والخدمات، بل على العكس، شهدت تدهورًا في أوضاعها المعيشية، واتساع رقعة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة والأسعار، مما أثر بشكل خاص على الفقراء وذوي الدخل المحدود. وقد أدت الخصخصة إلى ظهور طبقات اجتماعية متباينة، بين ثرية طفيلية وطبقات فقيرة ومعدمة تكافح يوميًا لتأمين قوتها.
ومن أبرز مساوئ الخصخصة تركيز الشركات الخاصة على الربح بدلًا من المصلحة العامة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، وتدهور جودة الخدمات، وفقدان الوظائف، وزيادة نسب البطالة والفقر، وانتشار الفساد في عمليات البيع، وضعف الرقابة، وفقدان المسؤولية، وظهور مافيات السوق التي تفتعل الأزمات لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الفئات الفقيرة.
كما تؤدي الخصخصة إلى فصل أعداد كبيرة من القوى العاملة، مما يفاقم مشكلة البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية. ويستغل القطاع الخاص نفوذه المالي وعلاقاته الوثيقة بالدولة والتشريعات الضامنة لمصالحه، مستخدمًا كافة الأساليب الملتوية لاستغلال العاملين، سواء بفصلهم عن العمل، أو تخفيض الأجور، أو تمديد ساعات العمل، أو غيرها من طرق الاستغلال الأخرى.
وتؤدي الخصخصة أيضًا إلى تفاقم التضخم، وارتفاع نسب الاحتكار، وغياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وبسبب سعي الشركات وراء الأرباح الخيالية، فإنها تُركز اهتمامها على تلبية احتياجات العملاء من الفئات الثرية، متجاهلةً الفئات الفقيرة الأكثر حاجة للخدمات.