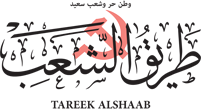على امتداد السنوات الأخيرة، شهد العراق تحولاً تدريجياً في ثقافة التسوق، تمثّل في الانتقال من الأسواق الشعبية المفتوحة إلى المولات والمجمعات التجارية الحديثة. هذا التحوّل لم يأتِ كنتيجة طبيعية للتطور العمراني فقط، بل أيضاً بفعل سياسات الاستثمار وتغيير أنماط الاستهلاك، ما جعل المولات تتكاثر في قلوب المدن، وتُغيّر خريطة التوزيع التجاري والسلوك التسوقي في آنٍ واحد.
ففي بغداد ومدن رئيسة أخرى كالنجف وكربلاء والبصرة، أصبحت مشاهد البنايات الزجاجية المرتفعة التي تحمل أسماء تجارية لامعة، جزءاً من المظهر اليومي. وكثير من هذه المولات شُيّد على قطع أراض كانت تشغلها حدائق عامة أو أسواق تراثية، أو حتى منازل ضمن أحياء سكنية مزدحمة، ما فاقم من مشكلات التخطيط الحضري، في الوقت الذي تضغط فيه تلك المباني الفارهة على خدمات البنى التحتية من ماء وكهرباء ومجار، فضلا عما تسببه من ازدحامات مرورية خانقة بفعل كثرة أعداد مرتاديها.
ولا تجذب تلك المولات الزبائن بفعل ما توفره من بضائع وحسب، إنما بتصاميمها العصرية وبما توفره من وسائل راحة وترفيه وغيرها، بالرغم من ارتفاع أسعار البضائع فيها مقارنة بالأسواق الشعبية. في حين يجري إهمال الأخيرة دون إدامة أو تطوير، حيث الأزبال تنتشر في الأرجاء، ومياه الصرف الصحي تطفح هنا وهناك، تحت سقوف متهالكة لا تحمي من شمس ولا مطر!
ويرى اختصاصيون أن إنشاء المولات غالباً ما يتم دون دراسات أو تخطيط من الناحية المرورية ومن ناحية البنية التحتية، ما يؤدي إلى ازدحامات خانقة خصوصاً في أوقات الذروة. ففي مناطق مثل المنصور والحارثية في بغداد، تحوّلت المولات من مرافق تسوق إلى مسبّب مباشر للاختناق المروري.
بيئة مكيّفة مقابل بيئة مرهقة
المواطن نبيل الكريماوي، يرى في حديث صحفي أن "المراكز التجارية الحديثة أصبحت المكان الأنسب للتسوّق. فكل شيء متوفّر فيها"، مضيفا القول أن "تلك المراكز تتمتع ببيئة مكيّفة مع ازدحام أقل، وغياب لعمليات النصب والاحتيال، إضافة إلى ذلك أن جودة البضائع غالباً ما تكون أفضل".
فيما يلفت إلى ان "السوق الشعبي بات مرهقاً. إذ تغلب عليه الأتربة والطين، وغالباً ما تكون الأسعار فيه غير ثابتة. كما يشعر الزبون في هذا السوق بأنه تائه وسط الصراخ والعشوائية، بينما في المول تكون الأمور أكثر وضوحاً، والسلعة مضمونة".
لكن الكريماوي يرى أيضا أن "المشكلة في المولات أنها تُبنى غالباً وسط أحياء سكنية أو أماكن مكتظة بالمباني، ما يسبب اختاقات مرورية. وبالتالي يواجه المواطن عند ذهابه لتلك المراكز التجارية صعوبات عديدة، منها صعوبة الحصول على مكان لركن سيارته. وأنا بالنسبة لي أفضل أحيانا الذهاب إلى السوق الشعبي الصغير، تجنبا للازدحامات".
ويعزو اختصاصيون تلك المشكلات، إلى غياب التنسيق بين الجهات التخطيطية والبلديات. حيث تُمنح تراخيص بناء المولات أحياناً دون مراعاة لنوعية الحي أو شبكة الطرق أو طاقة الاستيعاب. كما أن بعض المولات يقام على أراضٍ مُستثناة بقرارات خاصة، ما يزيد من التوتر بين السكان المحليين والمستثمرين.
ماذا عن الباعة الفقراء؟!
في مقابل ذلك، تتآكل الأسواق الشعبية ببطء، لكنها مستمرة. كثير من الباعة يشكون من تراجع الزبائن، خاصة في الأسواق غير المُغطاة التي تفتقر إلى وسائل الراحة، في ظل تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة.
يقول المواطن قتيبة الزهيري، وهو صاحب بسطة في سوق الباب المعظم، أن "المراكز التجارية الحديثة لا تناسبنا، لا كبائعين ولا كمستهلكين من ذوي الدخل المحدود. فهي مخصصة لشريحة معينة من الناس، ولا تراعي ظروف الأغلبية التي تعتمد على الدخل اليومي".
ويشير في حديث صحفي إلى ان "الناس يقصدون الأسواق الشعبية لأنها تمنحهم خيارات أوسع بأسعار مرنة. إذ يمكنهم التفاوض مع البائع، أو شراء بضائع مستعملة نظيفة، أو حتى سلع من الدرجة الثانية، وهذا ما لا توفره المولات التي تفرض أسعاراً ثابتة وغالباً مرتفعة".
ويلفت الزهيري إلى ان "المولات تُقصي البائعين الصغار، لأنها تشترط وجود علامات تجارية وتراخيص رسمية. في حين أن أغلب الباعة في الأسواق التقليدية يعملون بإمكانات بسيطة ولا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجارات بالدولار أو التأمينات المرتفعة".
المول لا يعوّض السوق الشعبي
يرى متابعون أنه رغم الانتقادات لا يمكن إنكار أن المولات وفرت تجربة جديدة للعراقيين، خصوصاً للطبقات المتوسطة والصاعدة، الباحثة عن بيئة نظيفة ومنظمة وآمنة. كما أنها ساهمت في تشغيل عدد كبير من الشباب في مجالات الأمن والخدمة والتسويق، فضلاً عن توفير خدمات ترفيهية مفقودة في الفضاءات العامة.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي قاسم السلطاني، ان "انتشار المولات يعكس تحولاً في نمط الاستهلاك. وهو جزء من التحول الاقتصادي الحضري الذي تشهده دول نامية عديدة".
ويضيف أنه "لا يمكن اعتبار المولات بديلاً كلياً للأسواق الشعبية، لأن هناك فوارق في المستهدفين وطبيعة السلع. فالسوق التقليدي سيبقى موجوداً ما دام هناك طلب من شرائح سكانية واسعة، لكنه سيحتاج إلى تنظيم أكبر حتى يصمد أمام المنافسة".
ويوضح السلطاني في حديث صحفي، أن "التحدي الأساسي ليس في وجود المولات، بل في عشوائية مواقعها، وعدم إشراك مكاتب التخطيط الحضري في تحديد أماكنها. فبعضها أقيم قرب مدارس أو مستشفيات أو داخل أحياء ضيقة، ما سبّب ضغطاً سكانياً وخدمياً".
البعد الاجتماعي - الثقافي
بعيدا عن الجوانب الاقتصادية والخدمية، إن للسوق الشعبي بعداً اجتماعياً وثقافياً لا يمكن إنكاره.
فهذه الأسواق لم تكن فقط أماكن بيع وشراء، بل مواقع تعج بالحياة اليومية، وتتفاعل فيها الذاكرة المحلية مع الأصوات والعلاقات الممتدة بين البائعين والزبائن.
ويرى اختصاصيون في علم الاجتماع أن اختفاء هذه الأسواق سيؤدي إلى تآكل في النسيج الاجتماعي، خصوصاً في الأحياء القديمة التي نشأت حول الأسواق، لا العكس.
فكل سوق تقليدي كان يحمل اسماً وهوية وتاريخاً، بينما المولات تتشابه وتعيد إنتاج النموذج نفسه في كل مكان.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المولات في العراق تضاعف خلال عقد واحد.
حيث باتت مدناً صغيرة داخل المدن، تستهلك الماء والكهرباء والطرقات دون مقابل واضح للتنمية المحلية، ما يُفاقم الفوارق الطبقية ويزيد الضغط على البنية التحتية المتآكلة أساساً. وفي هذا السياق، تُطرح تساؤلات في الأوساط الأكاديمية عن جدوى هذا التوسع، ما لم يرافقه تنظيم تشريعي يحفظ حقوق الباعة التقليديين، ويوزّع التراخيص بشكل عادل، ويشجّع الاستثمار في أسواق حديثة شعبية الطابع.