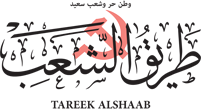أجيال صاخبة تبحث عن وجود، أو عن تاريخ، أو عن بيان يجمعها. هي ليست بعيدة عن الأيديولوجيا، ولا عن السلطة، لكنها مسكونة بهوس اكتشاف العالم عبر اللغة، وعبر حدوس المغامرين الذين صنعوا كثيرا من الحروب الدونكيشوتية، التي لا وجود لها سوى التوهم بتغيير العالم عن طريق الطواحين..
أجيال الثقافة العراقية تحمل معها أسئلة فارقة عن ذلك الوجود، مثلما تعتاش على سرديات ما تساقط من التاريخ العراقي، ومن ورز ما يُخفيه، وما يظهره من صراعات تساكنها مرائر وشهوات تقويض المراكز، بدءا من مركزية السلطة واللغة وانتهاء بمركزية المقدس بمعناه الانثربولوجي، لكن ما يميّز هذه الأجيال هو عنفها، وقسوتها، وشغفها بالتغيير عبر رمي الآخر "الثقافي" خارج النسق، والاندفاع نحو صياغة صاخبة للزمن الثقافي، حيث تتحول القصيدة الى ممارسة في الكتابة الماكرة، وحيث يتحول الشاعر الى بطل تحوطه أوهام الثورة والايديولوجيا والعنف الطبقي.. مثلما تتحول السرديات الى رهانٍ على نفي التاريخ، وعلى تجريده من سلطة الحكواتي، حيث يحمل السارد صناديق الاسرار والاوهام، وحيث يجد في الكتابة طرسا لمواجهة المحذوف، والنسيان، والاتكاء على الاستعارات التي تُخفي الخيانة والزيف.. منذ الستينات من القرن الماضي، والشعراء يتمردون على "السلطة" بحمولاتها الرمزية والكلامية، وبايديوجيتها التي انسحقت تحت اقدام الانقلابيين، حتى بات التغيير الشعري وهما إزاء واقع صلب، تقوه سلطة الجنرال والحزبي و"رجل الحرس القومي" وباتت القصيدة هي شعار اللاجدوى الذي يتكىء على بيان شعري ضال، يحمل معه تململ الشعراء من كل شيء، حيث التمرد على الأيديولوجيا وعلى الوهم الطبقي وعلى السلطة، وعلى التاريخ، بما فيه تاريخ "القصيدة ذاتها" وهذا ما جعل "القصيدة الستينية" اكثر تمثيلا لفكرة الغضب والخوف والتخفي، والتمرد الوجودي، والاحتجاج على الرومانسية والثورية، وعلى الذاكرة القومية، التي انكشف عريها ووهمها بعد الخامس من حزيران عام 1967
هذه الهزيمة لا تختلف عن هزيمة الخطاب السياسي، والجسد الوطني بعد انقلاب شباط 1963، فكلا "النكستين" اسهما في صناعة واقع مر وملوّث، لم تشفع القصيدة في تطهيره، ولا في خلاصه، فما بات مفضوحا هو التناظر القاسي بين قراءة "ملف الجنرال" والسجان وبين ملف الشاعر الحالم، وبين ما احتشد في يوميات "قصر النهاية" من فجائع، ومن جلجات مات فيها البطل الأيديولوجي، والبطل الشعري، ومن اسفار تحول فيها "قطار الموت" الى رحلة تعرّى فيها الجسد الثقافي العراقي من قميصه الشعري، حيث يبدأ الاشهار عن زمن الخطيئة، زمن القتل والغياب، والتورية والنفي والاختباء خلف لعبة البيانات والمجازات..
قراءة الزمن الشعري العراقي في الستينيات تعني قراءة ملفاته، وخفايا تحولاته الصاخبة، ويوميات صانعي مغامراته، حيث تحمل اسئلة فاضل العزاوي وفوزي كريم ويوسف الصائغ وسعدي يوسف وصادق الصائغ وغيرهم هواجس الحلم الشعري، وشهوات الانعتاق والتخلّص من ذاكرة الرماد، ومن تاريخ "الهزيمة" والذهاب الى مناورة "البيان" وربما "الغناء" ككناية عن التطهير، وعن الاستغواء بقصيدة الصوت كنوع من الافتراض بمواجهة "الفراغ" الذي تحول الى محنة للانتظار العبثي، وللنفي الداخلي... كتب " الموجة الصاخبة" لسامي مهدي و" الروح الحية" لفاضل العزاوي" و" ثياب الامبراطور" لفوزي كريم، وكتاب "انفرادات" للشاعر عبد القادر الجنابي، حملت معها ازمة تخص مراقبة تحولات "الجسد الشعري" لكنها انزاحت لتبدو وكأنها وجدت في تمثيل الصراع الثقافي ضالتها، في تعرية ما يجري بين الشعر والسلطة، أو بين الشعر والايديولوجيا، فالكل يتنابز، يرفض، يسبُّ، يكره، ناعتا تاريخ الآخر باللعنة، مكشوفا على مزيد من الأوهام والعنف، وعلى نحو جعل من الكتابة الشخصية، كتابة الفرد العاري، المهزوم، العاجز، المعطوب، وكأنها التمثيل النفسي لما جرى في العراق من فجائع، كانت الكتابة فيها هي الأقرب الى كتابة مراثي الجسد المطرود والمغتَصب.
بيان شعر 69 ليس بعيدا عن هواجس الصراع، فهذا البيان والمجلة التي حملت اسمه كانت محاولة في تغيير قواعد اللعبة، وفي انسنة التمرد الخفي، لكن السلطة ادركت مكر الشعراء، حتى وإن اختبأوا تحت معطف الأيديولوجيا، فكان الرد الشعري محمولا على قناع سياسي، وجد في "بيان القصيدة اليومية" تمثيله العائم، لكنه في الجوهر كان بيانا طاردا نشرته مجلة الكلمة عام 1973، جعل من "كُتّابه..." مأخوذين بكتابة بيان التمرد المضاد، حيث التورية بالعودة الى الأيديولوجيا والى البيت الحزبي عبر وهم شعرية اليومي، وعبر وضع الزمن الشعري الستيني امام المساءلة، حتى بدا البيان الأخير وكأنه ايحاء بأنه "البيان الأخير" الذي يحمل معه فشل التجربة الستينية، وانسحاق الشعراء تحت بلدوزر الزمن السياسي/ الأيديولوجي الجديد، وتحت يافطة الانقلاب، وإعطاء مفهوم "القصيدة اليومية" توصيفا يتجاوز الزمن الشعري الى الزمن الوجودي، والى إعادة النظر بهوية "الصراع" الذي يراه القوميون وكأنه ضد "الأمة" وأن الشعراء الشيوعيين جعلوا من تجريبهم، ومن أفكارهم ومن صخبهم الشعري وكأنه تمرد قصدي على تلك الأمة التي كان اختباؤها في القصيدة مضحكا ومثيرا للسخرية، وتحت يافطات مراوغة تتوهم إعادة انتاج البطل القومي من خلال القصيدة الجديدة التي تنزع عنها ذاكرة الهزيمة، لتصنع وهم الانتصار عبر قصيدة الخفة التي لا تمكث على الأرض، ولا حتى في التاريخ..