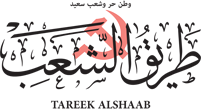منذ سقوط النظام السابق عام 2003، دخل العراق مرحلة سياسية جديدة وُعِد فيها الشعب بتحولات كبرى نحو الديمقراطية، العدالة، وإعادة بناء الدولة. غير أنّ ما تكشّف خلال عقدين من الزمن لم يكن سوى إعادة إنتاج للأزمات القديمة بشكل أكثر تعقيداً. تعاقبت الحكومات، وتغيّرت الوجوه والأحزاب، لكن الجوهر بقي واحداً: مصالح ذاتية ضيقة، محاصصة طائفية وإثنية، وغياب شبه كامل لمفهومي المواطنة والعدالة الاجتماعية.
لم يُبْنَ النظام الجديد على أساس دولة حديثة تستند إلى مؤسسات مستقلة وقوانين عادلة، بل على نظام محاصصة جعل الانتماء الطائفي أو القومي معياراً للموقع والسلطة. هذا النهج أفرغ مفهوم المواطنة من معناه، وحوّل العراقي إلى تابعٍ لهوية فرعية لا إلى مواطن في دولة تعترف بحقوقه وتصون كرامته. ومع ترسّخ هذا النمط، أصبح من الطبيعي أن تتقدّم الولاءات الشخصية والحزبية على المصلحة العامة، وأن تتحول السلطة إلى غنيمة يجري اقتسامها بدل أن تكون أداة لخدمة الناس.
لكن لماذا نتحدث عن المواطنة والعدالة الاجتماعية بوصفهما قضيتين محوريتين في مشروع التغيير؟ ببساطة لأنهما يمثّلان الأساس الذي بدونه يستحيل بناء عراق مختلف. المواطنة تعني أولًا أن جميع العراقيين متساوون أمام القانون، بغضّ النظر عن طائفتهم أو قوميتهم أو منطقتهم. إنها العقد الاجتماعي الذي يوحّد المجتمع، ويجعل من الدولة مرجعاً للجميع، لا طرفاً في نزاعات الهويات. وعندما تغيب المواطنة، يتحول الناس إلى جماعات مغلقة، كل واحدة تبحث عن حصتها من السلطة والثروة، فتضعف الدولة وينهار الشعور بالانتماء الوطني. أما العدالة الاجتماعية فهي الوجه الاقتصادي والإنساني لهذا العقد. لا يمكن الحديث عن مواطنة حقيقية فيما نصف الشعب يعيش تحت خط الفقر، والخدمات الأساسية منهارة، والبطالة تنخر في طموحات الشباب. العدالة الاجتماعية تعني توزيعاً عادلًا للثروة، فرص عمل متكافئة، حقاً مضموناً في الصحة والتعليم، وضماناً اجتماعياً يحمي الضعفاء. غيابها لا ينتج فقط حرماناً اقتصادياً، بل يولّد شعوراً بالقهر، ويعمّق الهوة بين طبقة سياسية متخمة بالامتيازات وغالبية شعبية مهمّشة.
لقد اختبرت التجربة العراقية على مدى عشرين عاماً كيف أن غياب هذين المبدأين أدى إلى نتائج كارثية. ففي الوقت الذي تدفقت فيه على البلاد مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، لم يجد المواطن نصيبه من هذه الثروة، بل تسرّبت إلى شبكات الفساد والمحسوبية. ومع كل حكومة جديدة كان الأمل يتجدد لدى الناس، لكن سرعان ما يتبدد أمام واقع يعيد إنتاج نفسه: صراعات على المناصب، تحاصص في الوزارات، وانشغال بالصفقات والولاءات بدلًا من بناء دولة مؤسسات. إنّ المراقب المنصف لا يستطيع أن يتجاهل أن الطبقة السياسية منذ 2003 وحتى اليوم لم تُبدِ أي اهتمام جاد بالمواطنة والعدالة. هذه النخب اعتبرت السلطة وسيلة للثروة والنفوذ، لا أداة لإدارة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب. بل إنها في كثير من الأحيان عززت خطاب الهويات الفرعية لتبرير بقائها في السلطة، مستفيدة من الانقسامات المجتمعية كأداة للسيطرة. وبهذا لم تكن معنية بإصلاح جذري، بل بترتيب مصالحها الذاتية على حساب حاضر العراقيين ومستقبلهم. لهذا، فإن أي مشروع تغيير حقيقي لا بد أن يبدأ من هذين المدخلين: المواطنة والعدالة الاجتماعية. فالمواطنة تضع الجميع على أرضية واحدة وتفتح الباب لبناء دولة قانون، والعدالة الاجتماعية تعطي للمواطن معنى ملموساً لهذا الانتماء عبر شعوره بأن ثروة بلاده تُدار لصالحه لا لصالح فئة قليلة. من دونهما ستبقى الدولة هشة، وستظل الديمقراطية شكلية، والفساد متجذراً.
اليوم، وبعد عقدين من التجارب المريرة، تبيّن بوضوح أن التغيير لا يمكن أن يأتي من داخل الطبقة السياسية نفسها، لأنها ببساطة المستفيد الأكبر من بقاء الوضع على حاله. التغيير الحقيقي لن يُصنع إلا من مشروع وطني بديل يرفض منطق المحاصصة، ويعيد الاعتبار لمبدأ المواطنة، ويضع العدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات. هذا المشروع لا بد أن ينبع من وعي شعبي ضاغط، من حركات اجتماعية ومدنية، من قوى ترى في العراق وطناً جامعاً لا ساحة لتقاسم الغنائم. إنّ استعادة العراق ممكنة، لكنها مشروطة بإعادة صياغة الدولة على أساس المواطنة والعدالة. وما لم يحدث هذا التحول، ستبقى الحكومات المتعاقبة تستهلك الوقت والموارد في دوامة المصالح الذاتية، بينما يبقى الشعب ينتظر عدالة غائبة ووطناً موعوداً لم يتحقق بعد.