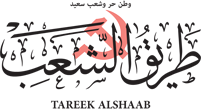الصفحة الأولى
في الذكرى السابعة والستين لثورة 14 تموز 1958 المجيد.. المحتفلون يستنكرون محاولات طمس معالمها وعبرها ويؤكدون: لا بديل عن التغيير الشامل واستعادة الوطن
بغداد – طريق الشعب
في مشهد مهيب يليق بعظمة المناسبة، احتشدت جماهير واسعة، أمس الاثنين، في ساحة التحرير وسط بغداد، إحياءً للذكرى السابعة والستين لثورة الرابع عشر من تموز 1958. في فعالية وطنية جسدت الوفاء لثورة غيّرت وجه العراق، ووقفة احتجاجية صاخبة ضد واقع اختطفته منظومة المحاصصة والفساد، وسط حضور لافت لقوى وطنية ونقابية وشخصيات سياسية واجتماعية، أكدت جميعها المضي بثبات نحو مشروع التغيير الجذري.
وقبل يوم من إحياء المناسبة في ساحة التحرير، دعا الحزب الشيوعي العراقي الى اعتبار يوم ١٤ تموز عيدًا وطنيًا ويومًا لتأسيس الجمهورية، لما له من قيمة وطنية وشعبية، وقبول من أطياف الشعب العراقي كافة، وكونه رمزًا من رموز الكفاح الوطني للخلاص من التبعية ولنيل الحرية والاستقلال والسيادة الكاملتين.
الثورة أسست للعدالة والسيادة
وانطلقت الفعالية من ساحة النصر، حيث توجّه المشاركون سيرًا على الأقدام نحو ساحة التحرير تحت نصب الحرية، رمز الشعب المنتفض والحالم بالكرامة والسيادة والعدالة الاجتماعية. وعند الوصول، افتتح الرفيق أيوب عبد الحسين الحفل بكلمة ترحيبية أعادت التأكيد على أن "14 تموز لم تكن يومًا عاديًا في التاريخ العراقي، بل لحظة فارقة في وجدان الناس، عندما نهض الشعب بجيشه ليعلن الكلمة الفصل ضد الاستبداد والتبعية".
الكلمة الافتتاحية للاحتفال شددت على أن "ساحة التحرير اليوم لا تحتفي بذكرى غابرة، بل تحتضن جوهر الثورة وقيمها المتجددة. فثورة 14 تموز أرست أسس السيادة الوطنية، وأسقطت الحكم الملكي التابع، وأطلقت برامج الإصلاح الزراعي، ومجانية التعليم، وبناء الصناعة الوطنية، ومكّنت المرأة من خوض غمار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
لم تخلُ الكلمات من انتقادات حادة للواقع الراهن، حيث اتهمت القوى الحاكمة بتقويض ما تحقق من منجزات وطنية، وقالت: "غُيّبت العدالة، وأُهملت الخدمات، وضُرب التعليم، وانعدمت فرص العمل، وتكرّس التمييز الطائفي على حساب المواطنة، حتى باتت الدولة مرتعًا للفئوية والغنائم".
المشاركون في الفعالية لم ينسوا اجراء المتنتفذين بإلغاء العطلة الرسمية ليوم 14 تموز، معتبرين ذلك "تنكّرًا صريحًا للثورة ومحاولة مكشوفة لطمس ذاكرتها من الوعي الجمعي"، مؤكدين أن "المنظومة الحاكمة تخشى روح تموز، وتخشى أن تعود إرادة الشعب لتصنع الفجر الجديد".
نعيش نقيض حلم الثورة
وخلال الفعالية، ألقت السيدة سهير القيسي، كلمة اللجنة المركزية لتخليد ثورة 14 تموز، التي حملت بُعدًا تحليليًا عميقًا لوضع البلاد، وربطًا بين إنجازات الثورة وتراجع الوضع الراهن.
قالت القيسي: "في فجر 14 تموز 1958، لم يكن العراقيون على موعد عادي مع التاريخ، بل مع ولادة صفحة جديدة في سجل الكرامة الوطنية. لقد أشرقت شمس الحرية، وسقط نظام التبعية، وبدأت ملامح عراق جديد يرسمه أبناؤه لا أوصياء عليه".
وأضافت ان "ثورة تموز كانت انحيازًا كاملاً للشعب، وصرخة في وجه الظلم، ورهانًا على دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. خلال سنوات قليلة، أنجزت الثورة ما لم تحققه أنظمة حكم عقودًا طويلة: أنهت الإقطاع، وأطلقت التعليم المجاني، وشيدت آلاف المدارس والمستشفيات، وأرست قاعدة وطنية للصناعة، وحررت القرار السياسي من الهيمنة الأجنبية".
القيسي أكدت أن "تموز لم تكن مجرد انقلاب في السلطة، بل محطة تأسيسية بين القرار الوطني والإرادة الشعبية، ولهذا لم تُنسَ رغم محاولات التغييب والتشويه من السلطات المتعاقبة، التي تنكرت لأبسط مبادئ الثورة وطمستها من المناهج والاحتفاء الرسمي".
وتابعت "نعيش اليوم نقيض حلم تموز. فالسلطة الحاكمة غارقة في المحاصصة، حولت الدولة إلى مزرعة حزبية، وتخاف حتى من أصوات الناس. لم تعد الدولة مشروعًا وطنيًا بل تحولت إلى غنيمة، فيما تمتهن الكرامة وتُنهب الثروات، وتُصادر الحقوق، وتُستبدل دولة المواطنة بدولة الولاء الحزبي والطائفي".
واختتمت القيسي كلمتها بالقول: "لسنا بحاجة لاستنساخ تموز، بل لاستحضار روحها. بحاجة إلى شجاعتها، ووطنيتها، ونزاهتها. إلى مشروع وطني يعيد الثقة للمواطن، ويستأصل الفساد من جذوره. تموز ليست ذكرى بل امتحان متجدد لضميرنا السياسي. العراق لا يزال يستحق الأفضل، والتغيير ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية".
صوت العمال
من جهته، ألقى النقابي عدنان الصفار كلمة النقابات والاتحادات العمالية، التي اعتبرت ثورة تموز محطة لا تمحى في الذاكرة الطبقية والوطنية، إذ أعادت الاعتبار لدور الطبقة العاملة، وساهمت في تحقيق تحولات جذرية في أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الصفار ان "ثورة تموز لم تكن مجرد تغيير سياسي، بل إعلان حقيقي لتحول اجتماعي وإنساني، أنهى الحكم الملكي التابع، وأطلق جمهورية العدالة والمساواة والسيادة". وأضاف أن "الثورة شرعت قانون الإصلاح الزراعي، وأرست أسس الصناعة الوطنية، وأطلقت مشاريع التعليم والصحة والسكن الشعبي، وفتحت الأبواب أمام المرأة للمشاركة".
وأشار إلى أن "الطبقة العاملة العراقية احتفلت لأول مرة بعيدها الوطني في الأول من أيار 1959، بتظاهرة وطنية جامعة، شارك فيها كل أبناء الشعب، وأعادت للعامل كرامته ودوره القيادي في المجتمع".
وأوضح الصفار أن "الثورة رفعت أجور العمال بنسبة 52%، وأقرت قوانين للضمان الاجتماعي، وبنت أحياء للفقراء، وقللت الفوارق الطبقية، وحددت ساعات العمل بثمانٍ، وشرعت الحد الأدنى للأجور، وفرضت على أصحاب المعامل بناء مساكن لعمالهم، وأطلقت حرية التنظيم النقابي".
واختتم كلمته بالتشديد على أن "ثورة تموز ستبقى يومًا وطنيًا خالدًا، وواحدة من أعظم محطات النضال الشعبي في تاريخ العراق، وذاكرة لا يمكن طمسها، لأنها نبض الكرامة والعدالة في وجدان هذا الشعب".
بإجماع الحاضرين، عبّرت الفعالية عن أن روح 14 تموز لا تزال حيّة، وأن شعب العراق، الذي نهض في 1958، لن يقبل بالذل، وسينهض من جديد لإعادة بناء الوطن، واستعادة دولته المختطفة من الفاسدين والفاشلين.
********************************************
راصد الطريق.. غيض من فيض!
- أقام مواطنون في منطقة الحسينية دعوى قضائية ضد مدير ماء الزهور بسبب انقطاع مياه الإسالة عن محلتهم السكنية منذ الثالث من أيار الماضي، وعند إعادة ضخ المياه مجددًا يوم أمس، وصلت إلى المنازل ملوثة وتحمل روائح كريهة.
- منذ أكثر من عشرة أيام، يشكو سكان حي الزيتون والمنطقة الزراعية في الدورة (شارع 60) في العاصمة بغداد من تذبذب تجهيز الكهرباء، حيث لا يتجاوز معدل التجهيز "اللمظة" قبل أن تعود للانقطاع، في إشارة إلى أن الكهرباء تصلهم لأقل من دقيقة، رغم جمع الأهالي مبلغ 15 ألف دينار من كل منزل لغرض إصلاح المحولة أو استبدالها.
- شهدت أطراف مدينة العمارة، يوم أمس الإثنين، انتشار سحب دخانية كثيفة مصحوبة بروائح كريهة، تركزت في مناطق قضاء الكحلاء والبتيرة.
- ناشد عمال الأجور اليومية في مديريات بلدية محافظة الأنبار الجهات الحكومية المعنية التدخل العاجل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من شهرين، مؤكدين أن تأخير الرواتب فاقم أوضاعهم المعيشية وأدى إلى تراجع الخدمات البلدية، خصوصًا في ملف النظافة.
***********************************************
الصفحة الثانية
نائب: التصويت على جداول الموازنة مفتاح إطلاق الترفيعات والعلاوات للموظفين
متابعة ـ طريق الشعب
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن المصادقة على جداول الموازنة التي يفترض على الحكومة ارسالها ستضفي الشرعية القانونية على التمويل الحكومي، وتنهي الجدل القانوني بشأن الصرف خلال الأشهر الماضية.
وقال الكاظمي، إن "الحكومة مطالبة بإرسال جداول موازنة واقعية تتناسب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية، والتي لا تتجاوز 140 تريليون دينار"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت الحكومة سترسل موازنة بمقدار 150 تريليون دينار، فهذا أمر طبيعي وسيتم التصويت عليها بقرار واحد داخل مجلس النواب دون الحاجة إلى القراءة الأولى والثانية".
وأوضح الكاظمي أن "إقرار الجداول سيجعل التمويلات الحكومية قانونية وشرعية، لا سيما في ظل وجود طعن قانوني بعمليات الصرف التي جرت خلال الأشهر السبعة الماضية".
وأضاف أن "المصادقة على الجداول ستتيح للحكومة الشروع بالإجراءات الإدارية المتوقفة منذ عام، ومنها إطلاق العلاوات، والترفيعات، والألقاب العلمية"، مؤكداً أن هذه "استحقاقات طبيعية للموظفين ويجب صرفها فوراً بعد إقرار الموازنة".
****************************************
استشهاد متظاهر في اربيل.. غضب شعبي متصاعد احتجاجاً على تردي الكهرباء والخدمات وشح المياه
بغداد ـ طريق الشعب
شهد عدد من مدن ومحافظات البلاد، تصعيداً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية، وغياب الحلول الحكومية؛ فمن أقصى الجنوب، مروراً بوسط البلاد، وصولاً إلى الشمال، خرج المواطنون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع، مطالبين بتحسين الكهرباء ومعالجة شح المياه، وتوفير فرص العمل والخدمات، والكف عن التهميش المزمن.
عقدان من التهميش وسوء الخدمات
ومن اقصى جنوب العراق، نظم اهالي هور المسحب في قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة، وقفه احتجاجية ضد التهميش وضعف الخدمات وغياب فرص العمل، فيما طالبوا باقالة قائم مقام القضاء ومسؤولين آخرين.
وقال المتحدث باسم المحتجين حسين ابو طبيخ، انه وبعد مرور أكثر من 20 سنة من التهميش والمماطلة فان المحتجين يطالبون بإقالة قائم مقام القضاء ومدير المشروع الياباني ومدير البلدية ومدير توزيع الماء.
وأضاف، ان مطالب اهالي القضاء تتضمن الخدمات والبنى التحتية اضافة للكهرباء والماء واكساء الشوارع وتوفير الأبنية المدرسية والمراكز الصحية خصوصاً مستشفى القضاء الجاهز والمتأخر لدواعي انتخابية حسب قوله.
فيما قال ممثل التظاهرة، عباس التركي، إن "معاناة القضاء مستمرة منذ سنوات دون حلول جذرية، رغم المناشدات والوعود المتكررة من المسؤولين المحليين".
وأشار التركي، إلى أن "المطلب الأساسي للتظاهرة هو إقالة القائممقام الحالي، الذي لم يُظهر أي تحرك جدي لمعالجة أزمات القضاء أو السعي لتحسين الخدمات"، مبيناً أن "الأهالي لن يتراجعوا عن مطالبهم وسيواصلون احتجاجهم حتى تُتخذ خطوات فعلية لمعالجة الإهمال المزمن".
مهندسو النفط يصعّدون..
وتظاهر عدد من خريجي محافظة البصرة من حملة الشهادات الهندسية والاختصاصات النفطية والجيولوجيا، أمام شركة نفط البصرة، احتجاجًا على استمرار تجاهل مطالبهم بالتعيين. وقال ممثل التظاهرة حسن الشاوي، إن "الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى، ولا للسكوت عن الظلم، لذا قررنا التصعيد بتظاهرات سلمية متواصلة، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على اعتصامنا دون أي استجابة فعلية من الجهات الحكومية".
وأضاف "أغلبنا من خريجي الاختصاصات النفطية والهندسية، ولا نطلب سوى التعيين بأجر يومي ضمن الشركات النفطية العاملة في البصرة، أو ضمن العقود الوزارية في مشروع FCC التابع لوزارة النفط، وهي مطالب مشروعة تستند إلى كتاب رسمي صادر من رئاسة الوزراء يتيح التعيين دون الحاجة للرجوع إلى قوانين الموازنة"، موضحا ان "وزير النفط من أبناء البصرة، ويعرف حجم المعاناة التي يعيشها الخريجون، ومع ذلك لم يتدخل حتى الآن".
حقول النفط تغلي بالمحتجين
وغالباً ما تشهد الحقول النفطية في البصرة تظاهرات تطالب بالتعيينات وتحسين الخدمات وتشغيل اهالي المحافظة من الخريجين والشباب في الوظائف الحكومية والشركات النفطية؛ حيث قطع العشرات من الخريجين، طريق مدخل منطقة البرجسية النفطية في البصرة، مطالبين بتثبيتهم على قرار 315 واستثنائهم من تعليمات الموازنات الثلاث.
وأكد المتظاهرون ضرورة تنفيذ قرار 315 وتثبيتهم في الشركات النفطية على الملاك الدائم، مطالبين رئاسة الوزراء ووزارة النفط بقبول مطالبهم بإكمال ملف تثبيتهم في وزارتي النفط والمالية. ومنذ أكثر من 5 أشهر يواصل خريجو كليات الهندسة والاختصاصات النفطية اعتصامهم المفتوح في شارع المكينة وسط البصرة، مطالبين بفرص عمل في الشركات النفطية الربحية العاملة بالمحافظة، دون الحاجة إلى انتظار التعيين على الملاك الدائم أو تخصيصات الموازنة. ورفع المعتصمون، شعارات تطالب بإنصاف أبناء البصرة في التوظيف ضمن القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مؤكدين أن التصعيد سيستمر حتى تحقيق مطالبهم. وقال حسن عبد الأمير، ممثل الخريجين: "منذ 5 أشهر ونحن نتظاهر، وقد بدأنا الآن اعتصاماً مفتوحاً، واليوم أغلقنا البوابة، وغداً سندخل إلى شارع المكينة، وبعدها سيبدأ التصعيد الأكبر"، مطالبا الحكومة المركزية ووزير النفط بـ"إنصاف أبناء البصرة، فهم أحق بالتعيين في اختصاصاتهم".
فيما وصف سجاد هاني ممثل الجيولوجيين في التظاهرة، بأن عقد الـ300 ألف صار حلماً للمهندس النفطي وخريجي الاختصاصات النفطية، وثمار جهد سنوات الدراسة تُطالب اليوم بعقد بسيط.
قطع طريق البتيرة
وفي تصعيد احتجاجي لافت، أقدم عدد من المحتجين في منطقة دوانم حي السلام في محافظة ميسان، على اغلاق طريق البتيرة المحاذي لمنطقتهم، احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة للتيار المتزامنة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
ولجأ الأهالي إلى قطع الطريق كوسيلة للتعبير عن غضبهم ولفت انتباه الحكومة المحلية التي يتهمونها بتجاهل معاناتهم، فيما قامت القوات الأمنية بطويق موقع الاحتجاج، وعملت على فتح طريق البتيرة لمرور المركبات.
هذا وشهد فض الاحتجاج بعض الاحتكاكات بين المحتجين وعناصر الشرطة، حيث ألقى بعض المحتجين الحجارة على رجال الشرطة في محاولة لمنعهم من فض التجمع.
كما تظاهر العشرات من المواطنين، امام صندوق الاسكان في المحافظة إثر تأخر معاملاتهم من الشهر الثاني. يشار الى ان المعاملات التي تم تقديمها من المواطنين كانت عبارة عن طلبات لسلف البناء التي يقدمها صندوق الاعمار التابع لوزارة الأعمار والإسكان".
والى جانب ذلك، أقدم محتجون على قطع طريق العمارة – المجر الكبير، أحد الطرق الحيوية جنوب المحافظة، احتجاجاً على تفاقم أزمة المياه التي باتت تهدد حياتهم اليومية ومحاصيلهم الزراعية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة والجهات المعنية بتحرك فوري وجاد لإنهاء الأزمة، لا سيما وأن المنطقة تُعد من أكبر المناطق الزراعية في المحافظة وتعتمد كلياً على المياه.
المثنى: مطالبات بالخدمات والوظائف
وكان لمحافظة المثنى حصة كبرى من الاحتجاجات، حيث تظاهر عدد من المواطنين في ناحية الدراجي جنوب المثنى، وسط الناحية، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية.
وأكد المحتجون، أن مناطقهم تعاني من نقص في المياه والبنية التحتية داعين الجهات المعنية إلى التدخل لتنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجاتهم. كما نظم عدد من عمال النظافة في بلدية قضاء الخضر بالمحافظة، وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بتخصيص قطع أراض سكنية أسوة بباقي الشرائح. واكد عدد من المحتجين، أنهم يعملون في ظروف عمل صعبة وتحت درجات حرارة مرتفعة دون أن يحصلوا على أبسط حقوقهم المتمثلة بامتلاك قطعة أرض توفر لهم الاستقرار، مطالبين الحكومة المحلية والجهات المعنية بإنصافهم والإسراع في شمولهم بتوزيع الأراضي، مؤكدين أن تجاهل مطالبهم سيضطرهم إلى تصعيد احتجاجاتهم في الأيام المقبلة. ودشن عدد من سكان مجمع "البيادر" الاستثماري في مدينة السماوة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال الخدمات الأساسية في المجمع وتحقيق الوعود بشأن ذلك.
وقال عدد من المشاركين في الوقفة، أن المجمع يحتاج الى اكمال خدمات الصرف الصحي والكهرباء والطرق والمداخل. فيما حملوا الجهات الرسمية مسؤولية التأخر في إنجاز ما تم الاتفاق عليه مطالبين الحكومة المحلية بالتدخل ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي قطعت لهم سابقا.
تظاهرة في بغداد
وفي العاصمة بغداد، تظاهر سكان منطقة الأمين شرقي بغداد، احتجاجاً على تردي الكهرباء الوطنية.وقال مراسل "طريق الشعب"، ان المحتجين أضرموا النيران وسط الشارع الرئيسي للمنطقة، احتجاجا على تردي الكهرباء، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لمنظومة الطاقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى اكثر من نصف مئوية.
ضحايا في أربيل
وفي محافظة أربيل، أفاد مصدر محلي، فجر الإثنين، باستشهاد شخص خلال احتجاجات اندلعت في ناحية ورتي، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
وقال المصدر، إن العشرات من سكان الناحية خرجوا في تظاهرة ليلية للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المستمرة للكهرباء في منطقتهم، التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن التظاهرة تحولت إلى مواجهة مع القوات الأمنية، التي حاولت تفريق المحتجين بالقرب من جسر حافز ضمن حدود الناحية، ما أدى إلى مقتل شخص يُدعى حسن سرنوسي جراء إطلاق نار. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات بشأن الحادثة أو الملابسات التي أدت الى سقوط ضحايا من المواطنين.
*****************************************
الموارد المائية تفكر في بناء السدود.. ذي قار.. نزوح أكثر من 10 آلاف عائلة وخسارة 11 ألف رأس جاموس
ذي قار – طريق الشعب
كشف مرصد "العراق الأخضر"، أمس الاثنين، عن تسجيل موجة نزوح داخلي واسعة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، طالت أكثر من 10 آلاف عائلة، نتيجة تفاقم أزمة الجفاف، في حين أعلنت المحافظة عن خسارة نحو 11 ألف رأس جاموس منذ عام 2023.
وقالت عضو المرصد في ذي قار، بشرى الطائي، في بيان، إن "10,450 عائلة نزحت من قرى وأرياف أقضية البطحاء، وسيد دخيل، والرفاعي، والشطرة، والدواية، والغراف، وناحية الفجر، وقلعة سكر، والنصر، فضلاً عن أهوار الطار والجبايش، إلى مراكز أقضية الناصرية، وأور، والبطحاء، والإصلاح، وسوق الشيوخ، وكرمة بني سعيد، والشطرة، والدواية، والغراف، وأقضية أخرى".
وأوضحت الطائي أن "دائرة الهجرة في المحافظة قدمت مساعدات إغاثية للعائلات المتضررة شملت سلات غذائية وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى تنظيم دورات للتوعية والتنمية البشرية لمساعدتهم على التكيّف مع ظروفهم الجديدة".
وفيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية، أشارت الطائي إلى أن "المحافظة فقدت منذ عام 2023 وحتى الآن نحو 11 ألف رأس جاموس بسبب الجفاف، حيث تراجع عدد رؤوس الجاموس من 21 ألفاً إلى 10 آلاف فقط".
وأضافت أن "مربي الجاموس يواجهون تحديات إضافية تتمثل في الإجراءات الأمنية التي تفرضها السيطرات داخل المحافظة، والتي تمنعهم من الانتقال مع حيواناتهم إلى مناطق تتوافر فيها المياه، وتُجبرهم على البقاء في مناطقهم لحين وصول المياه".
وتعكس هذه الأزمة المتفاقمة التداعيات الخطيرة للجفاف وشح المياه في مناطق الأهوار والريف، وسط مطالبات محلية ودولية بتكثيف الدعم وتوفير حلول مستدامة لأزمة المياه والبيئة في جنوب العراق.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الموارد المائية عن المباشرة بإعداد دراسات متقدمة لإنشاء عشرة سدود جديدة مخصصة لحصاد المياه في المناطق الصحراوية، ضمن خطة وطنية لمواجهة أزمة الشح المائي التي تُعد الأخطر في تاريخ العراق.
وتهدف السدود إلى خزن مياه السيول والأمطار لتعزيز الخزين الاستراتيجي، خصوصاً في المحافظات التي تفتقر للموارد السطحية.
الوزير عون ذياب عبد الله أكد أن الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية عاجلة لضمان الأمن المائي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، مشيراً إلى أن 12 محافظة باتت تعتمد على المياه الجوفية فقط، والتي تواجه تحديات خطيرة بسبب الآبار غير المرخصة وسوء التوزيع.
الوزارة أكملت تصاميم سدّي أبو طاكية والأبيض، وتدرس إنشاء سدود جديدة في ديالى، نينوى، كربلاء، المثنى، والنجف، مؤكدة استمرار تنفيذ خطط الحصاد المائي لمواجهة تأثيرات التغير المناخي وظاهرة النينو المتفاقمة.
**********************************************
تعزية
الرفاق الأعزاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري
تلقينا بأسى عميق نبأ وفاة الأمين العام لحزبكم الشقيق، الرفيق عمار خالد بكداش، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.
نقدر عاليا دور الرفيق الراحل وانغماره مبكرا في النضال الوطني والطبقي، واعلاء دور الشيوعيين السوريين في الذود عن استقلال الوطن وسيادته والدفاع عن مصالح الشعب السوري وعماله وفلاحيه وعموم كادحيه.
في هذه المناسبة الحزينة نتقدم إليكم والى عائلة الفقيد الكريمة ورفاقه بأحر التعازي ومشاعر المواساة.
الذكر الطيب للرفيق الراحل..
تقبلوا خالص تقديرنا
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
١٣-٧-٢٠٢٥
***********************************************
الصفحة الثالثة
التخلف التقني يهدد أمنه وسيادته في بيئة إقليمية متوترة متخصصون: العراق خارج سباق التطور التكنولوجي العسكري
بغداد - طريق الشعب
رغم التحديات الأمنية المعقدة التي تحيط بالعراق، لا تزال المؤسسة العسكرية في البلاد تواجه فجوة واسعة في مجال التكنولوجيا الدفاعية الحديثة؛ ففي الوقت الذي باتت فيه الحروب تُدار باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية والتشويش الإلكتروني، يقف العراق متأخراً عن ركب التطور، معتمداً على منظومات تقليدية وتسليح لا يواكب طبيعة التهديدات المتصاعدة.
يقول مختصون ان هذا التراجع سببه القصور في الرؤية الاستراتيجية وغياب الاستثمار الجاد في البنية التحتية العسكرية والصناعات الدفاعية.
الصين وروسيا نموذجاً
تُعد الصين وروسيا مثالين بارزين على الدول التي أدركت مبكراً أهمية التكنولوجيا في إعادة صياغة مفاهيم القوة العسكرية الحديثة. فقد استثمرت بكين بشكل هائل في التكنلوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي، وتطوير الطائرات المسيّرة، والحرب السيبرانية، وصولاً إلى بناء منظومات دفاع جوي متقدمة مثل HQ-9 ومشاريع الطائرات الشبحية J-20، في إطار رؤية استراتيجية لتحويل جيشها إلى قوة عالمية بحلول منتصف القرن.
أما روسيا، فاعتمدت نهجاً مختلفاً قائماً على تحديث الصناعات العسكرية التقليدية بالتوازي مع إدماج قدرات إلكترونية ومعلوماتية متطورة، وركّزت على تطوير أنظمة صواريخ فرط صوتية مثل “أفانغارد” ومنظومات الحرب الإلكترونية التي أثبتت فعاليتها في النزاعات المعاصرة. ويأتي ذلك ضمن عقيدة عسكرية تسعى للحفاظ على التوازن الاستراتيجي مع الغرب، ومجابهة التفوق التكنولوجي الأميركي عبر حلول غير تقليدية.
وبينما تراكمت لدى هاتين القوتين خبرة نوعية في المزج بين التصنيع العسكري والتطور التقني، لا يزال العراق في بداية الطريق ويعتمد على التسليح الغربي الذي بات واضحاً انه لا يرغب بوجود عراق مُسلح بشكل متكامل، ويواجه تحديات تشريعية ومالية وبنيوية تعرقل تحوّله إلى جيش عصري قادر على الدفاع عن سيادته في زمن لا يرحم من يتأخر تقنياً.
العراق يفتقر للتكنولوجيا العسكرية
من جانبه، أكد الخبير الأمني عدنان الكناني أن الجيش العراقي ما زال يفتقر إلى التكنولوجيا العسكرية الحديثة، في وقت باتت فيه الحروب تُدار بالأقمار الصناعية وأجهزة الحرب السيبرانية والطائرات المسيّرة والتشويش الإلكتروني، كما هو واضح في المواجهة الجارية بين إيران وإسرائيل.
وقال الكناني في حديث لـ"طريق الشعب"، إن “الصراع العسكري اليوم أصبح معتمداً على تقنيات متقدمة جداً، تشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنظومات الحرب الإلكترونية والتشويش والرادارات المتطورة”، مبيناً أن إيران – رغم الحصار المفروض عليها – تمكنت من مواكبة هذا النوع من الحروب، بل وأصبحت نداً عسكرياً يحسب له حساب أمام إسرائيل وأمريكا، بفضل استثمارها في قدراتها الذاتية".
وأضاف أنه “في المقابل، لا يزال الجيش العراقي بمثابة وليد حديث الولادة، لم يدخل بعد في مضمار التكنولوجيا القتالية، ما يستوجب البدء من الصفر في إعداد برامج استراتيجية لتأهيل المؤسسة العسكرية، بالاعتماد على الكفاءات الشابة من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والعلمية”.
وشدد الكناني على أن “المعركة اليوم لا تُكسب فقط بالسلاح، بل بالعلم والتخطيط والمعرفة التقنية، وأن الاقتصار على معسكر تسليحي واحد – سواء شرقي أو غربي – خطأ استراتيجي، لأن أي توتر في العلاقات السياسية قد يؤدي إلى شلل عسكري”، داعياً إلى “تنويع الشراكات العسكرية والتدريبية مع دول تمتلك خبرات في التكنولوجيا العسكرية، كالصين وروسيا ودول أخرى”.
ولفت إلى أن “غياب التكنولوجيا العسكرية المتقدمة يجعل العراق هدفاً سهلاً لأي جهة تمتلك نوايا عدوانية، وقد شاهدنا خروقات متكررة لأجوائنا، ومنها اختراق 60 طائرة إسرائيلية الأجواء العراقية مؤخراً، دون أن يُسجل أي رد يُذكر، ما يكرس هشاشة السيادة ويغري الطامعين”.
وفي ما يتعلق بواقع الأمن السيبراني والاستخباري، أشار الكناني إلى وجود “خلل بنيوي خطير”، قائلاً: “لدينا أكثر من 28 جهاز مخابرات أجنبيا ينشط داخل العراق، بعضهم يستخدم واجهات سياسية أو حزبية وحتى برلمانية، وبعض الشخصيات السياسية والأحزاب باتوا أدوات لأجهزة مخابرات أجنبية تعمل ضد مصلحة العراق”، مؤكداً أن “هذا الأمر يتطلب تفعيلًا عاجلًا لقانون مكافحة التجسس، ومراجعة جذرية لمنظومة الأمن الوطني”.
وحمّل الكناني الأجهزة الأمنية جزءاً من المسؤولية، قائلاً: “بعض الأحيان نجامل أداء الأجهزة الأمنية بحجة وجود تهديدات خارجية، لكن الواقع يثبت أنها غير قادرة على كشف أو تفكيك شبكات التجسس داخل العراق، والدليل أنه منذ عام 2003 وحتى اليوم، لم يُعلن عن ضبط شبكة تجسس كبرى أو القبض على عميل فاعل، رغم أن دولًا مثل إيران –رغم إجراءاتها الأمنية المشددة– تعلن بين فترة وأخرى عن تفكيك خلايا تجسس فكيف الحال بالعراق”.
وفرغ الى القول: “إذا أردنا أن نحمي سيادة العراق ونصون دماء العراقيين، فعلينا أن نبدأ بإصلاح جذري في بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية، يقوم على المعرفة، والتكنولوجيا، والتخطيط بعيد المدى، وليس على ردود الفعل اللحظية أو الاستعراضات الإعلامية”.
سباق تكنولوجي عسكري
من جهته، قال الخبير الأمني صفاء الأعسم إن التكنولوجيا أصبحت عنصراً محورياً في بناء الجيوش الحديثة، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية العراقية لا تزال متأخرة تقنياً مقارنة بدول متقدمة، رغم الكفاءة العالية التي يمتلكها العنصر البشري في الجيش العراقي من حيث العقيدة والانضباط والغيرة الوطنية.
وأضاف الأعسم، في تصريح صحفي، أن “العراق اليوم يواجه تحديات أمنية معقدة، في ظل عالم اصبحت تتحكم فيه تقنيات متطورة في ميدان المعركة، خصوصاً مع تصاعد أهمية الحرب السيبرانية والهجمات الدقيقة والطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى”.
وأوضح أن “قوات التحالف الدولي التي دخلت العراق منذ منتصف عام 2014 تولت بشكل كبير ملف حماية الأجواء العراقية، لكنها لم تقدّم، دعماً حقيقياً لتطوير منظومات الدفاع الجوي، ولم تردع الخروقات التي تعرض لها العراق، سواء من إسرائيل أو غيرها، رغم تكرار الضربات التي طالت قيادات ومواقع داخل الأراضي العراقية”.
وأشار إلى أن “الجيش العراقي يمتلك إمكانيات بشرية قوية، لكن التطوير التكنولوجي لا يزال دون المستوى المطلوب”، مضيفًا أن “العقود الأخيرة التي أبرمها العراق مع دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية لتجهيز طائرات الرافال والكركال ومنظومات دفاع جوي حديثة من نوع (MSAM) تُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن مدى المنظومات ما زال متوسطًا ولا يكشف الطائرات الشبحية مثل F-35، ما يضع العراق في موقع مكشوف أمام اي تهديدات محتملة”.
وانتقد الأعسم ما وصفه بـ”عدم الجدية الأميركية في تسليح العراق بسلاح كفوء”، معتبرًا أن “العراق تحول بعد 2003 من عقيدة تسليح شرقية إلى عقيدة غربية، دون أن يحصل على مستوى التسليح الذي يلائم التحديات الراهنة”.
وأضاف: “بينما تطور إيران، المحاصرة اقتصاديًا، قدراتها العسكرية بالاعتماد على الذات منذ أكثر من 35 عامًا، فإن العراق لم ينجح حتى الآن في تأسيس قاعدة صناعية عسكرية حقيقية”، مؤكداً أن “جهود التصنيع الحربي ما زالت محدودة، رغم بعض المحاولات مثل إدخال إنتاج المسدسات إلى الخدمة”.
ودعا الأعسم إلى “تحقيق شراكة استراتيجية حقيقية مع دول تمتلك صناعات عسكرية متقدمة، مع ضرورة استكمال ما بدأته الحكومة الحالية من تنويع لمصادر التسليح وتجاوز الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة”.
وأكد في ختام حديث أن “النهوض بالمؤسسة العسكرية العراقية يتطلب إعادة بناء مصانع التصنيع الحربي، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة، لأن بناء الجيوش الحديثة لم يعد قائمًا فقط على العقيدة والانضباط، بل على امتلاك أدوات الردع والتكنولوجيا المتقدمة”.
*******************************************
ترجمة وإعداد: طريق الشعب
العراق في عين العاصفة
نشرت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية على موقعها مقالاً عن أوضاع العراق في ظل الحرب الدائرة في المنطقة والعدوان الذي شنه الكيان على غزة ولبنان وإيران، ذكرت فيه بأن الشرق الأوسط عموماً يواجه اختبارًا جيوسياسيًا جديدًا. فبينما يراقب العالم المواجهة الخطيرة بين إيران وإسرائيل، تتكشف دراما عراقية، لا تقل أهمية في ظل عناوين الأخبار، فالبلد العالق جغرافيًا وتاريخيًا وسياسيًا بين الجبهتين، بات يواجه سؤالاً، لم يُّطرح بجدية قبل الآن، ويتعلق بماهية سياسته الخارجية وأولوية مصالحه الوطنية.
العلاقات الإقليمية
وذكر المقال بأنه ولسنوات، كان هناك محور غير رسمي، مكون من تحالفات سياسية موازية لنظام الدولة، شمل إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وشكّل نوعًا من الدفاع الأمامي ضد إسرائيل، وهو ما دفع بطهران لتمويله بالمال والسلاح والنفوذ السياسي والأيديولوجي، قبل أن يشهد هذا المحور بعض التراجع بسبب الحرب الأخيرة، رافقه تجنب إيراني للتدخل العسكري المباشر، وتقديم المصالح الوطنية على تعهدات الولاء الأيديولوجية، مما آثار تساؤلات عديدة لدى العراقيين، عما إذا كان عليهم أن يعتمدوا ذات الاستراتيجية. واعتبر المقال ذلك سبباً لعدم مشاركة حلفاء طهران في المعارك، وفق حسابات سياسية، أخذت بنظر الاعتبار أمرين، أولهما عدم وضع حكومة بغداد في موقف صعب، لاسيما في وقت يسعى فيه رئيسها بالفعل لحماية البلاد من صدام مفتوح مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، وثانيهما استعداد هذه القوى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني، في بلد، يعيش نظاماً سياسياً معروفا بهياكله الزبائنية، حيث تعني الأغلبية البرلمانية أكثر بكثير من مجرد سلطة تشريعية، لأنها تتيح الوصول إلى الموارد والحصانة والشرعية الدولية، وفق تصور كاتب المقال.
هل يمكن درء الخطر؟
وأشار الكاتب إلى أن من يعتقد بأن العراق قادر على البقاء بمنأى عن الصراع على المدى البعيد يقع في تقدير خاطئ للواقع، فالعراق ليس مجرد جار لإيران بل هو بالنسبة لها ركيزة استراتيجية، ترتبط بالتاريخ المشترك والتشابه المذهبي والترابط الاقتصادي، وهو في ذات الوقت ساحة هشة لعبور الأسلحة وإقامة صلات تحالفية وكسب المزيد من الأتباع، وبشكل قد تكفي شرارة محلية فيه لإشعال حريق إقليمي.
وحذر المقال من حجم المخاطر الاقتصادية لانفجار إقليمي، فإذا ما أُغلق مضيق هرمز - أهم طريق لنقل النفط في العالم - فإن الصادرات العراقية من النفط ستتوقف بنسبة تزيد عن 95 في المائة، معّرضة العراق الذي تعتمد ميزانيته الوطنية بشكل شبه كامل على صادرات النفط لصدمة اقتصادية في وقت قصير جدًا، وقد تغمره موجة محتملة من اللاجئين، تُثقل كاهل البنية التحتية العراقية، المُنهكة أصلًا.
الديمقراطية الهشة
ونبه الكاتب إلى مخاطر استغلال البعض، من عشاق الاستبداد، للأوضاع لشن حملات قمعية على المعارضين، وهو أمر بدت ملامحه بالظهور في ملاحقة العديد من المدونين والصحفيين العراقيين، وتزايد ضغوط الترهيب والابتزاز والتهديدات المجهولة عليهم، وهو ما دفع بالكثيرين منهم إلى الفرار إلى إقليم كردستان.
سياسة خارجية عائمة
وزعم الكاتب بأن العراق يفتقر إلى سياسة خارجية واضحة، لا تهدف فقط إلى تحقيق الهدوء على المدى القصير، بل تضمن أيضًا المصالح الوطنية على المدى الطويل، عبر الحفاظ على الحياد دون التقاعس، وتأمين الحدود، ماديًا وسياسيًا، وحصر السلاح بيد الدولة، وتمتين التعاون الإقليمي، بشكل يشترك فيه العراق بنشاط في الحلول السياسية، مما يمكنه من ترسيخ مكانته كعامل استقرار، بدلاً من أن يكون مرة أخرى منطقة عبور للمصالح الأجنبية، وهي السياسة التي تتحول بها بغداد من بيدق إلى منصة لتهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق التعاون الاقتصادي، وقيام تحالفات جديدة تتجاوز منطق التكتلات.
***************************************
أفكار من أوراق اليسار.. قناديل تموز
إبراهيم إسماعيل
ما الذي يمكن أن تكتبه في ذكرى ثورة 14 تموز؟ وهل هناك حاجة للمزيد؟ سؤال يواجهني كل عام حين تقترب المناسبة، وكل مرة أجد له في واقع الحال جوابا، فسماء تلك المأثرة التي اجترحها شعبنا بعماله وفلاحيه وجنوده ومثقفيه، تبقى سخيةً في الكشف عما تختزنه من قناديل، لعل من أهمها، قدرة العامل الذاتي، على إيصال الصراع الطبقي لعلياء الثورة، إذا ما فُعّلت مفاتيحه عند احتدام التناقضات داخل البنية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد شكّل 14 تموز بحق مفتتحاً للثورة الوطنية الديمقراطية، مذ حرر البلاد من المستعمر وأحلافه العسكرية وكسر الهيمنة الإمبريالية عليها وهشّم البنية الإقطاعية في الريف وطوّر الإنتاج الصناعي وعزز دور الرأسمال الوطني وأعاد توزيع الثروة عبر توفير الخدمات المجانية في التعليم والرعاية الصحية، وعبر زيادة الأجور وبناء المساكن الشعبية والتحكم بالغلاء، إضافة إلى الخطوات التي قُطعت على طريق التحرر الاقتصادي وعرقنة الثروة النفطية وبناء قاعدة اقتصادية أكثر استقلالاً عن النظام الرأسمالي العالمي. كما تخلصت البلاد به من التناقض الأساسي بين الدولة ومكوناتها الاجتماعية، والمتمثل باحتكار الأقلية للسلطة السياسية، بعد تغليفها بديمقراطية صورية مستندة لهيمنة أجنبية. وبالتالي كان بديهياً، أن يتخذ شعبنا من هذا اليوم، الذي حقق له الحرية والعدالة والوحدة لأول مرة في تاريخه، عيده الوطني.
غير أن كل هذه المنجزات، لم تك كافية لصيانة المسار وبلوغ عليائه، ولا حتى لمنع حفنة معزولة من شذاذ الآفاق من ذبح الثورة أمام أنظار أغلبية صامتة، بقيت مشلولة الإرادة وكأن على رأسها طير من الخوف أو اللامبالاة أو الخيبة العميقة.
وكي نجد تفسيراً مفيداً لما جرى، لا بد من أن نمرر السماء الصافية في غربال الحياة، كما قال إيلوار، لنجد فشلاً في إقامة شرعية للحكم على أساس المواطنة، وتغييباً للقوى السياسية الرئيسية الممثلة للعراقيين، عن المشاركة في إدارة الدولة، وتصاعداً فجاً في تأثيرات الفكر القوماني العربي المثقل بانقلابيته والكردي المتطرف باغترابه، ونزوعاً نرجسياً لدى عساكر، أوهمها إعجاب الجماهير بما قامت به القوات المسلحة، ويساراً تشتّت رؤاه، ووهنت فيه وحدة الإرادة والعمل، فتلكأ عن قيادة حركة جماهيرية طامحة بقوة لمواصلة تطبيق برنامج الثورة حتى نهايته وقطع الطريق على محاولات النكوص عن ذلك.
ومن غربال الحياة هذا، سنجد تحالفاً برجوازياً صغيراً، يتناسى التحول نحو نظام حكم ديمقراطي مؤسساتي، حتى حين أدى عشقه للسلطة للإضرار بنجاحاته، كتراجع الإصلاح الزراعي وتوقف رسملة الريف ومنع قيام مؤسسات ديمقراطية جماهيرية وتشديد التناقض بين الإنجازات التقدمية وبين تبني المركزية الشديدة وتعمق عزلة النظام عن المجتمع مجدداً، لحد تيسّر عنده سقوطه التراجيدي. ولعل خير تشخيص لهذا المآل قد جاء في بيان حزبنا الشيوعي (8 تموز 1962) الذي انتقد قمع الحقوق والحريات ودعا لصيانة الاستقلال الوطني وحل أزمة كردستان حلاً سلمياً ديمقراطياً وانتخاب مجلس تأسيسي وإقرار دستور دائم.
وكما أرانا غربال الحياة بأن المنجزات العظيمة لحكومة 14 تموز قد محت الكثير من أخطائها قبل أن تتحول لخطايا، فإنه بقيّ ينبهنا إلى أن تشخيص الحلقة المركزية لنضال اليسار، على أهميته الاستثنائية، لن يكون فاعلاً الاّ إذا ما اقترن بخطط عملية وميدانية، توطّد الوحدة وتستّنهض المفاصل التنظيمية وتمتّن التحامها بالناس، وتدقق في طبيعة الحلفاء الذين يستحقون التضامن والثقة، وتضاعف اليقظة عند السراء قبل الضراء، ولا تتساهل في قضية الحريات والشكل الديمقراطي الذي ينظمها مهما كانت الظروف.
للذكرى المجد، ولشهداء الثورة الأبرار، شارة الخلود في ضمير العراق.
***********************************************
الصفحة الرابعة
مطالبات بقاعدة بيانات حقيقية وحماية فاعلة للصغار.. عمالة الأطفال: قوانين معطلة وظاهرة تتفاقم
بغداد – تبارك عبد المجيد
بين واقع اقتصادي مأزوم وتفكك اجتماعي متزايد، تتفاقم ظاهرة تشرد الأطفال وعمالتهم، لتتحول من حالات فردية إلى أزمة مجتمعية تهدد جيلا كاملا، بينما تقف خلف هذا المشهد عوامل متعددة، أبرزها الفقر والنزوح والعنف الأسري، إلى جانب ضعف تطبيق القوانين وغياب السياسات الفاعلة في حماية الطفولة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لاحتواء هذه الظاهرة، لا تزال الشوارع والأسواق والورش تعج بأطفال فقدوا حقهم في التعليم والحياة الآمنة، ليجدوا أنفسهم في بيئات قاسية، لا ترحم أعمارهم الصغيرة.
تراكمات اجتماعية واقتصادية
تحدثت إلهام قدوري، ناشطة ومدير منظمة عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تشرد الأطفال وانحرافهم في المجتمع العراقي، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية، بل نتيجة تراكمات اجتماعية واقتصادية.
تقول قدوري لـ "طريق الشعب"، ان "من أبرز العوامل التي تدفع الأطفال إلى الشارع وتؤدي إلى انحرافهم، هو التفكك الأسري، خصوصاً حالات الطلاق. حين ينفصل الأبوان، غالباً ما يترك الطفل دون رعاية أو احتضان حقيقي، حتى وإن كان يعيش في كنف الجد أو الجدة. في هذه المرحلة العمرية الحساسة، يحتاج الطفل إلى دعم نفسي واجتماعي مستقر، وإن غاب ذلك، يصبح معرضاً للانخراط في علاقات غير سوية ورفاق سوء".
وتضيف أن "الفقر لا يقل خطورة عن التفكك الأسري، بل ربما يكون أقوى الأسباب التي تدفع الأطفال إلى الشارع والعمل القسري"، موضحةً أن "الفقر يدفع الأطفال لترك مقاعد الدراسة والبحث عن لقمة العيش، في غياب أي دعم مؤسساتي حقيقي يعيدهم إلى طريق التعليم".
وتشير أيضاً إلى أن الجهل، سواء لدى الأب أو الأم يفاقم المشكلة، قائلة: "عندما لا يكون لدى الوالدين وعي كاف أو اهتمام بتعليم أبنائهم، أو حين يتركونهم دون رقابة أو توجيه، فإن الطفل يصبح أكثر عرضة للانحراف".
وتتابع ان "العنف الأسري أيضاً من العوامل الأساسية. حين يتعرض الطفل للعنف المتكرر داخل البيت، يكون من الطبيعي أن يهرب نحو الشارع، لكنه لا يجد فيه سوى مزيد من الانحراف".
وعن الحلول، تؤكد قدوري أن "الوعي المجتمعي، والمراقبة، وتفعيل القانون" هي مفاتيح المعالجة الحقيقية، مشددة على أن "فرض القانون بشكل حازم، ووجود مؤسسات تتابع حالات التسرب والعنف الأسري، كفيل بأن يمنح الطفل فرصة ليعيش حياة متوازنة وسليمة".
وختمت بالقول: "هذه الظاهرة لن تعالج إلا من خلال فهم الأسباب الحقيقية، ووضع خطة وطنية واضحة المعالم، تشمل دعم الأسرة، وتوفير التعليم، ومكافحة الفقر، وبناء بيئة قانونية تحمي الطفل وتضمن مستقبله".
برنامج وطني لدعم الفقراء؟
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، أن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، خصوصا في المناطق الصناعية داخل بغداد وفي المحافظات، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أرباب العمل الذين يشغلون أطفالًا دون السن القانوني.
واشار الى ان الوزارة تملك لجنة مختصة في مكافحة عمالة الاطفال.
وأوضح العقابي لـ "طريق الشعب"، أن "الوزارة تحيل المخالفين إلى الجهات المختصة، في إطار سعيها لحماية الأطفال وضمان حقوقهم"، لافتا إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع برنامج وطني واسع لدعم الأسر الفقيرة.
وأضاف العقابي أن هناك نحو 4 ملايين طفل مشمولون ببرامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، ودعم الاسر العراقية من خلال توزيع سلات غذائية ومنح مالية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، حيث يحصل الطالب على مبلغ شهري يبلغ 30 ألف دينار، بهدف تشجيعهم على العودة إلى مقاعد الدراسة.
كما أعلن العقابي عن إطلاق وجبة جديدة من الدعم المالي بالتعاون مع المنظمات الدولية، ضمن برنامج "كاش بلاس" حيث تم منح مبلغ 240 ألف دينار لكل مستفيد لمدة 6 أشهر.
ولفت إلى أن محافظة المثنى، باعتبارها من أكثر المحافظات فقرا، كانت من أوائل المناطق المستفيدة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى شمول نحو 7 آلاف مستفيد فيها خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل أيضا النساء الحوامل، مع الأخذ بالاعتبار الجانب الصحي، مؤكدا أن الوزارة ستواصل التوسع التدريجي في البرنامج ليشمل محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وخلص العقابي الى أن الوزارة "عازمة على تحسين واقع الأسر الفقيرة وتوفير بيئة ملائمة للأطفال، بعيدًا عن بيئة العمل والاستغلال".
وكانت وزارة التخطيط كشفت في وقت سابق، أن 17.5 في المائة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يزيد على 8 ملايين شخص. وتؤكد منظمة يونيسف أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من بين 4.5 مليون عراقي معرضين للفقر، ما يدفع آلاف الأسر إلى دفع أطفالها للعمل في الشوارع والأسواق لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.
غياب الرقابة المؤسسية
وقال القانوني مصطفى البياتي، إن عمالة الأطفال في العراق تمثل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن قانون العمل العراقي رقم (37 لسنة 2015) منع تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ووضع شروطا صارمة لتشغيل من هم بين 15 و18 عام، من بينها توفير بيئة آمنة، وساعات عمل محددة، وتدريب مهني مناسب.
وأضاف البياتي لـ "طريق الشعب"، ان "رغم وجود هذا الإطار القانوني، إلا أن عمالة الأطفال لا تزال تنتشر بشكل مقلق في العراق، بفعل عوامل متعددة في مقدمتها الفقر، وغياب الرقابة المؤسسية، وضعف تطبيق القوانين، وغياب السياسات الفاعلة في حماية الطفولة". وأشار البياتي إلى أن "الحروب والنزوح كانا من أكبر العوامل التي ساهمت في تفاقم الظاهرة، فمنذ اجتياح تنظيم داعش لعدة محافظات عراقية عام 2014، اضطرت ملايين الأسر للنزوح وفقدت مصادر دخلها، ما دفع العديد من الأطفال إلى تحمل أعباء الكبار في وقت مبكر".
وتابع قائلا "تُمارس عمالة الأطفال في بيئات شديدة الخطورة، لا تراعي الحد الأدنى من شروط السلامة أو الصحة المهنية، كورش تصليح السيارات، وتحميل المعدات الثقيلة، وجمع النفايات، فضلا عن التسول المنظم، الذي بات يُدار من شبكات منظمة، بعضها على ارتباط بجرائم الاتجار بالبشر".
ودعا البياتي إلى تحرك عاجل على المستوى الحكومي والمؤسسات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، من خلال تفعيل قانون حماية الطفل، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأطفال العاملين، وتقديم برامج دعم اجتماعي وتعليمي عاجلة للأسر المتضررة.
واختتم بالقول ان "المعالجات الشكلية لم تعد كافية، فنحن بحاجة إلى سياسة وطنية شاملة لحماية الطفولة، تبدأ من الوقاية، ولا تنتهي عند المساءلة والمحاسبة".
********************************************
أطفالها يمشون 5 كيلومترات للوصول إلى صفوف المدارس الكرفانية.. العطش وانعدام الخدمات الأساسية يلتهمان قرية {آل عبس} في المثنى
بغداد – طريق الشعب
رغم التحذيرات المتكررة من تفاقم أزمة المياه وتراجع الزراعة في محافظة المثنى، تبقى قرية "آل عبس" شاهداً حياً على التدهور المستمر في واقع الريف الجنوبي، وسط غياب واضح لأية تدخلات تنموية جادة تجاه سنوات من الجفاف، وتقلص الحصص المائية، وتراجع الدعم الزراعي، ما دفع السكان نحو الهجرة القسرية، ودُفِن ما تبقى من أمل في حياة كريمة داخل قريتهم.
تقع قرية ال عبس في عمق البادية الجنوبية لمحافظة المثنى، إحدى المناطق الريفية التي كانت عامرة بالزراعة والمياه، وتحولت اليوم إلى صحراء قاحلة بفعل التغيرات المناخية والإهمال الحكومي. هذا ما يؤكده محسن محمد، أحد سكان عشيرة آلبوحسن، التي تقطن القرية منذ عقود، حيث يروي بداية التحولات قائلاً، ان "المنطقة كانت عامرة بالمياه، وكان عندهم أنهار ومشاريع وبذور، لكن التغيرات المناخية قلبت كل شيء. اليوم، المياه جفت، والزراعة اختفت، والناس بدأت تترك القرية وتتجه للمدينة".
لا زراعة ولا خدمات
ويقول محسن لـ"طريق الشعب"، موضحا أثر الجفاف في القرية: "كنا نزرع بالاعتماد على نهر الفرات، لكن الآن قل منسوب الماء، وحتى المضخات التي كانت تنصبها العشائر ما عادت تنفع. الزراعة اليوم صارت شبه منعدمة".
وعن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، يضيف محسن، ان "ليست لدينا شوارع معبدة ولا طرق سليمة وسالكة. أكثر الطرق الموجودة ترابية وعرة، والبيوت كلها قديمة مبنية من الطين"، ويتابع ان "المدارس قليلة، وأكثرها مشيدة بمواد الساندويش بنل، وتبعد عن منازلنا حوالي 4 أو 5 كيلومترات. الأطفال يعانون كثيرا في الذهاب للمدرسة، وفي الغالب يتركونها، وهذا أحد أسباب ارتفاع الأمية بين النساء وكبار السن".
ثم يشير محسن إلى الوضع الصحي: "يوجد مركز صحي واحد فقط، ويبعد تقريبا 15 كيلومترا عن المنطقة. كما يخلو من الكوادر الكافية، والتجهيزات الطبية، وإذا صار طارئ".
ويذكر أيضا ان المعاناة من شح الماء وغياب الكهرباء لها قصة اخرى: "ننقل الماء بالتناكر، والكهرباء نعتمد على المولدات الأهلية. ليست لدينا شبكات مياه أو كهرباء".
ويبين بأن نساء القرى من الأرامل والمطلقات يحتجن الى توعية قانونية ودورات تدريب.
ويختتم محسن حديثه بمناشدة واضحة: "لا توجد معامل ولا شغل، حتى الحرف اليدوية اندثرت. نحتاج لمشاريع تنموية حقيقية، نحتاج لفرص عمل، نحتاج لدورات تعليم مهني وغيرها".
تردي الأوضاع البيئية
وعن واقع الزراعة، يتحدث سفر محمد، أحد مزارعي قرية آل عبس، قائلاً إن الزراعة التي اعتمدت عليها العائلات لسنوات أصبحت شبه متوقفة، نتيجة شح المياه وتردي الأوضاع البيئية.
ويقول محمد لـ"طريق الشعب"، أن "مياه الري غير متوفرة، واراضينا تتآكل بفعل الجفاف"، مؤكدا قيام الكثير من المزارعين ببيع مواشيهم بسبب عدم القدرة على توفير العلف والماء.
ويضيف أن "النزوح نحو مراكز المدن لم يكن خياراً، بل فرضته الظروف الصعبة"، حيث يواجه النازحون أوضاعاً معيشية قاسية، في ظل غياب فرص العمل والسكن اللائق، والضغط الكبير على الخدمات الأساسية داخل المدن.
ويدعو محمد الحكومة إلى إعلان المثنى منطقة منكوبة بيئياً ومائياً، وتوفير موازنة طارئة لإعادة تأهيل شبكات الري وحماية ما تبقى من الأراضي الزراعية، لأنه "من دون ماء، لا حياة للناس ولا للأرض".
ويذكر أن مشروع التبليط القرية رأيناه للمرة الأولى في عام 2023، إلا أنه ما زال متعثراً ولم يُستكمل، مبيناً أن الأهالي لم يلمسوا أي تحسن فعلي في البنية التحتية، رغم الوعود المتكررة.
الوضع تحت السيطرة!
وفي السياق، يكشف المهندس يوسف سوادي، معاون محافظ المثنى لشؤون الزراعة والموارد المائية، عن حجم التحديات التي تواجهها المحافظة نتيجة شح المياه، لا سيما من نهر دجلة، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في موجات نزوح واسعة بين المزارعين، وتركهم لمهنتهم التي لم تعد ممكنة في ظل هذه الظروف.
ويصرح سوادي لـ"طريق الشعب"، أن المحافظة اضطرت، أمام هذا الواقع، إلى التوسع باتجاه البادية الجنوبية وتخصيص مساحات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير والذرة، والتي تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، مؤكداً أهمية استخدام تقنيات الري الحديثة للحفاظ على هذا المورد.
وفيما يحذر من الاستخدام المفرط للمياه الجوفية لما له من تأثير سلبي على التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، يشير إلى أن المثنى ما تزال تحتفظ بمورد مائي وفير نسبياً. ويؤكد أن هناك جهودا مستمرة لتنظيم استخدامه وضمان استدامته.
ويطمئن أن "الوضع لا يزال تحت السيطرة".
ويسلط سوادي الضوء على تفاقم الهجرة من القرى الواقعة على مقربة من نهر الفرات، ومنها "آل عبس"، موضحاً أن تراجع الإطلاقات المائية يعود إلى سياسة دول المنبع المائية – وعلى رأسها تركيا – فضلاً عن تجاوزات المحافظات المجاورة مثل بابل والديوانية والنجف، التي أثرت بشكل مباشر على حصة المثنى المائية، داعيا إلى إجراءات حازمة لوقف التجاوز على المياه الجوفية، بالتزامن مع جهود الحكومة المحلية لضمان وصول الحصة المائية العادلة من نهر الفرات. كما يشدد على أهمية التنسيق مع دول الجوار لتأمين تدفق المياه إلى العراق عموماً، والمثنى على وجه الخصوص.
******************************************
الصفحة الخامسة
من استخراج النفط إلى حرق النفايات {الكربون} يغلّف أجواء العراق وينشر السرطانات
متابعة – طريق الشعب
بفعل عمليات استخراج النفط وحرق النفايات بطرق عشوائية، تتصاعد نسب الانبعاثات الكربونية في سماء العراق بشكل كبير، مخلفة أضرارا بيئية وصحية شديدة. وبينما تؤكد تقارير ودراسات محلية ودولية ارتفاع نسب التلوّث الكربوني في معظم مدن البلاد، لا يبدو في الأفق أي إجراء حكومي للحد من تلك الملوّثات، لا سيما في ظل مواصلة تآكل الغطاء النباتي بفعل التجريف والتغير المناخي، والذي يُفترض أن يُساهم بشكل كبير في تقليل نسب ثاني أكسيد الكربون.
وتُشكل الانبعاثات الكربونية تحديات بيئية عالمية كبيرة. إذ تصدر عنها غازات تحتوي على الكربون، تنتشر في الغلاف الجوي وتسبب أضرارا بيئية وصحية. وتنجم تلك الانبعاثات عن أنشطة بشرية متعددة، مثل حرق الوقود الأحفوري في توليد الطاقة وفي النقل والصناعة، فضلا عن عمليات استخراج النفط وحرق النفايات. وإضافة إلى أضرارها البيئية والصحية، تُعتبر الانبعاثات الكربونية المسؤول الرئيس عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيّر المناخ – حسب ما تؤكده دراسات علمية متخصصة.
في حديث صحفي، يقول الاختصاصي في الشأن البيئي عمر عبد اللطيف: أن "الآليات والأساليب غير الصحيحة المتبعة في حرق النفايات، والتلوث الذي تحدثه عوادم المولدات الأهلية ومعامل الأسفلت والأدوية وغيرها، كل ذلك له دور كبير في ارتفاع نسبة انبعاث الكربون والتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الأعوام الأخيرة".
وسبق أن أظهر تقرير حصلت عليه ونشرته وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، ارتفاع نسب انبعاثات الكربون في الدول العربية خلال العام الماضي، وتحديدا في 5 بلدان بينها العراق الذي حل وفق التقرير في المرتبة الثالثة، بنسبة انبعاث تقدر بـ 342.8 مليون طن.
وفي المقابل، نفت وزارة البيئة ما ورد في ذلك التقرير، معتبرة إياه مجهول المصدر، إضافة إلى عدم وجود مصادر علمية تثبت النسب التي وردت فيه.
ووفقا لما ذكره المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار، في حديث صحفي، فإن "العراق بدأ بخطوات جديدة للتخلص من الانبعاثات الكربونية وخفضها إلى أدنى حد ممكن"، مضيفا قوله أن "العراق أنشأ العام الماضي شركة اقتصاديات الكربون، التي تنفذ مشاريع ذات مردودات بيئية واقتصادية إيجابية".
وأشار المختار إلى أن "الشركة تسعى لإنتاج مشاريع تعتمد الطاقة النظيفة وتراعي تقنيات خفض الانبعاثات"، مؤكدا أن "الشركة تمضي بخطوات متسارعة، بعد عقد المؤتمر الأول لاقتصاديات الكربون بحضور شركات محلية وعالمية، والذي تم خلاله توقيع مذكرات تفاهم من شأنها المساهمة في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".
وبيّن أن "لكل فرد في العالم بصمة كربونية ناتجة عن مجموعة من الأنشطة اليومية وحجم النفايات التي يولدها، وأنه بوسع الإنسان خفض البصمة الكربونية باتخاذه خطوات صحيحة في جمع النفايات والفائض من الأطعمة وغير ذلك".
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، قد أفاد العام الماضي بأن عام 2021 سجل انبعاثات في تركيز ثاني أكسيد الكربون في العراق، نسبتها 177.8 مليون طن، وان هذه النسبة تزداد سنوياً بمقدار 4.88 في المائة.
وأوضح الغراوي أن "بغداد تأتي في المرتبة 13 في قائمة المدن الاكثر تلوثاً بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".
طليعة دول التلوث الكربوني
من جانبه، قال الخبير البيئي خالد سليمان، أن "ما يجعل العراق في طليعة دول التلوث الكربوني، هي الصناعات النفطية والغازية. إذ تؤدي هذه الصناعات إلى المزيد من انبعاثات الكربون". لكنه شكك بصحة المعلومات الواردة في التقرير المذكور.
وبينما أكد أن "الصناعة النفطية العراقية أقل من الصناعة السعودية"، نوّه إلى "افتقار العراق إلى الغطاء النباتي مقارنة مع صناعته النفطية، وان نسب الانبعاثات التي تطلق إلى الجو تساهم بشكل كبير في الاحترار". وأضاف سليمان أن "العراق لا يتعامل مع الانبعاثات بشكل علمي. لذا فهو متأخر من ناحية خفضها"، مشيرا إلى ان "العراق يسعى لزيادة إنتاجه النفطي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسب الانبعاثات خلال السنوات المقبلة، وبالتالي يتسبب ذلك على الصعيد المحلي، في ارتفاع درجات الحرارة ونسب التلوث في الهواء والتربة". وكثيرا ما يُطالب اختصاصيون في البيئة، الحكومة بوضع سياسات بيئية ومناخية تهدف إلى تقليل نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وبإطلاق المبادرة الوطنية للغابات، وإلزام المحافظات كافة بزراعة طوق أخضر ومصدات للرياح، فضلاً عن الاستثمار في المناطق الصحراوية، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تساهم في تعزيز الغطاء الأخضر.
استثمار الغاز وتقليل نسب الكربون
في السياق، ذكرت الأكاديمية المتخصصة في الشأن البيئي، منار ماجد، ان "التقرير السنوي لنسب احتراق الغاز عالميا للعام 2024، أفاد بارتفاع معدل الاحتراق في منشآت استخراج النفط والغاز، بزيادة مقدارها 7 في المائة".
ورأت في حديث صحفي أن "العراق لو اعتمد عمليات استثمار صحيحة في استخراج النفط والغاز والمشاريع الصناعية الأخرى، لقلل من نسب انبعاث الكربون"، مبينة أنه "من الممكن الاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط في التصدير، كما يحدث في قطر التي تعد الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي".
ونوّهت إلى أنه "في حال اعتمد العراق استثمار الغاز وسياسات فعالة أخرى لتقليل كميات الهدر والحرق، سيصل إلى مرحلة الاستدامة في هذا المجال، وسيوفر العديد من الوظائف وفرص العمل".
لكن الأكاديمية منار أشّرت "غياب البرامج والمشاريع الجادة المعنية بخفض انبعاثات الكربون في العراق"، مشيرة إلى أن "العمل في هذا الخصوص يجب ألا يقتصر على مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة، وأنه لا بد من الاستعانة بخبرات عالمية في هذا الشأن". ولعبت الانبعاثات الكربونية والجفاف وغياب خطط الاستزراع والتشجير، فضلا عن اتساع التصحر، دوراً كبيراً في تغير المناخ في العراق وارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز أحياناً نصف درجة الغليان، وهو ما يوجب على الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة وتبني سياسات علمية ممنهجة تهدف إلى خفض انبعاث الكربون الذي يهدد الناس بمخاطره الشديدة. وترى دراسات علمية عديدة، أن انبعاثات الكربون، خاصة تلك الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري، تحتوي على جسيمات دقيقة ومواد كيميائية مسرطنة، وأن هناك أدلة قوية من دراسات بشرية وحيوانية تربط تلوث الهواء الجسيمي بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، فضلا عن سرطاني المثانة والثدي.
******************************************
اگول.. رائحة احتراق وصمت مسؤول!
أسامة عبد الكريم
عند أطراف المدينة، حيث يظن البعض أن العين لا ترى، والنفس لا تتأذى، تتصاعد أعمدة الدخان السوداء كل صباح ومساء، معلنة ًعن محرقة غير مرئية لصحة الإنسان والبيئة. حرق النفايات أصبح ممارسة شبه يومية، يتعمدها البعض ويغضّ الطرف عنها كثيرون، وكأنها طقس اعتيادي لا يستحق التوقف عنده، بينما تدفع الأجساد ثمناً باهظاً من الرئتين والدم.
إنها ليست مجرد "زبالة تحترق" كما قد يهونها البعض. إنها كيمياء سامة تتسلل إلى صدور السكان، أطفالاً وكباراً، وتحوّل الأحياء السكنية القريبة إلى مناطق موبوءة بآثار التلوث: الربو، الحساسية، تهيج العينين، وحتى أمراض أشد خطراً على المدى الطويل. لكن الأخطر من النار، هو من يشعلها بلا وعي أو محاسبة.
عددٌ من ناقلي النفايات، وهم في الأصل مأجورون على التنظيف، تحوّلوا إلى مصدر مباشر للقذارة. يُفرغ بعضهم حمولة القمامة في الشوارع العامة، جهاراً نهاراً، وكأن المدينة مجرّد مكب مفتوح. لا رادع أخلاقيا، ولا وازع قانونيا، بل تجاوز فجّ على الذوق العام وحق المواطن في بيئة نظيفة.
هنا يطرح السؤال الأكثر إحراجاً: أين الرقابة؟ أين أمانة العاصمة والمجالس المحلية التي من المفترض أنها تتحمل مسؤولية الإشراف والمساءلة؟ هل يعقل أن تمر هذه المخالفات من تحت أنف الإدارات بلا تقرير أو متابعة؟ أم أن بعض المواقع تُترك عمداً بلا رقابة لأنها تقع "خارج الخدمة الإدارية"؟
الحل ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إرادة وشفافية. أول الخطوات العملية تبدأ بنصب كاميرات مراقبة في مواقع التفريغ والمرور، لتوثيق المخالفات، وردع من تسوّل له نفسه العبث بالبيئة. يلي ذلك تفعيل العقوبات والغرامات بحق المتجاوزين، ونشرها للرأي العام كي يدرك الجميع أن العبث بالنظافة جريمة، لا مجرد مخالفة عابرة.
إن حماية المدينة تبدأ من التفاصيل، من حاوية تُفرغ في مكانها الصحيح، ومن شاحنة او حتى الستوتة تُحاسب إذا خرجت عن مهمتها. فصحة الناس لا تُترك على قارعة الطريق، والنظافة ليست ترفاً بل هي حق أساسي من حقوق العيش الكريم.
**************************************************
كاميرات ذكية ولكن!
بغداد – طريق الشعب
اعلنت مديرية المرور العامة انها فعّلت عددا من الكاميرات الذكية في الشوارع الرئيسة لرصد المخالفات المرورية الكترونيا. وطلبت من المخالفين مراجعة دوائرها خلال 72 ساعة بعد المخالفة، وبخلاف ذلك سوف تتضاعف الغرامات التي تسجل ضدهم.
وفي أحاديث لـ"طريق الشعب"، ذكر عدد من أصحاب المركبات ان "هذا الإجراء مهم وضروري لحصر المخالفات بصورة الكترونية، وارغام اصحاب السيارات على السير وفقاً للقانون وعدم التهور والقيادة بسرعة، ما يحد من الحوادث المميتة التي تتكرر بشكل شبه يومي". وبينما أكدوا اهمية هذه الكاميرات، انتقدوا عدم وجود منظومة للإبلاغ تُقدم للمخالف إشعارا بمخالفته، كما هو الحال في اقليم كردستان.
ونوّهوا إلى انهم لا يعرفون متى يُتخذ قرار الغرامة ضدهم. اذ ان غالبية الكاميرات تؤشر على المركبات المارة أمامها بواسطة الضوء المصاحب (الفلاش)، وبالتالي تُصعب معرفة ما اذا كانت المركبة مخالِفة أو لا. وبهذا قد تُسجل مخالفات على مركبات دون أن ينتبه أصحابها للأمر، ومع استمرار الجهل بالمخالفة سيتضاعف مبلغ الغرامة!
واشار المتحدثون الى أهمية تطوير هذا النظام، عبر إرسال رسائل نصية الى هواتف سائقي المركبات المخالفين، تُشعرهم بمخالفاتهم، وبالتالي يخضعون للقانون ويتوجهون إلى سداد الغرامات قبل أن تتضاعف.
وشددوا على أهمية ألا يكون الغرض الأساسي من نصب الكاميرات هو جني الغرامات، إنما تنبيه السائقين إلى ضرورة السير وفق القواعد القانونية. وفي حين دعوا الى زيادة أعداد الكاميرات، خصوصاً على الطرق السريعة، نبهوا إلى اهمية تعبيد الطرق وتأثيثها لتكون صالة للسير.
**********************************************
مواساة
- تتقدم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في بابل، بالتعازي الحارة إلى السيد عيسى علوان، برحيل رفيقة دربه، شقيقة شهيد الحزب المناضل الصلب محمد هاشم جبر الموسوي، وأم الرفيق علي وأحمد ونوفل.
كانت الراحلة مثالا للمرأة النبيلة، التي وقفت سندًا لشقيقها في دربه النضالي، وآمنت بقضيته وشدّت من أزره.
لها الذكر الطيب، ولأسرتها الكريمة خالص العزاء.
***************************************************
الصفحة السادسة
الاتحاد الأوروبي يستضيف وزير خارجية الاحتلال رغم ادعائه طلب ايقاف الحرب! رفض واسع لمقترح المدينة الإنسانية: معسكر اعتقال
متابعة – طريق الشعب
يتوجه ناشطون على ظهر سفينة جديدة تابعة إلى أسطول الحرية، من ايطالياً، إلى غزة، تقل ناشطين مؤيدين للشعب الفلسطيني، وتحمل مساعدات إنسانية، وذلك بعد شهر على اعتراض قوات الاحتلال الفلسطيني، سفينة سابقة، وتأتي هذه التحركات في إطار توسع التضامن الشعبي الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة.
كما شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أخيراً، مسيرة جماهيرية حاشدة جابت الشوارع الرئيسية ومحيط أبرز المعالم، دعماً للشعب الفلسطيني ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
معسكر اعتقال
وصفت وكالة الأونروا مشروع بناء مدينة إنسانية من قبل الاحتلال الاسرائيلي بـ "معسكر اعتقال"، فيما حذرت منظمة العفو من أن الخطة ترقى إلى جريمة حرب.
فيما قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، إنه "مصدوم من الخطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا ينبغي تقليص الأراضي الفلسطينية ولا منع السكان من العودة إلى بلداتهم".
كما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معارضته الخطة وشدد على أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأوضح ميرتس أنه أعرب مرارا عن عدم رضاه، وأنه ناقش هذه المواضيع أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأشعلت الخطة الإسرائيلية الرامية لنقل سكان قطاع غزة إلى ما سُمّي بـالمدينة الإنسانية موجة غضب وانتقادات حادة، وُصفت بأنها تمهيد لتهجير قسري واسع النطاق.
هل ستتوقف الشراكة؟
شارك وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول جوار البحر المتوسط في بروكسل، على الرغم من الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة. وادعاء عدد من هذه الدول أنهم يدعون إلى وقف الحرب وتحقيق السلام.
وقالت خارجية الاحتلال، إن " الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا وجهت دعوة إلى ساعر للمشاركة في الاجتماعات".
في الأثناء، دعا خبراء في القانون الدولي الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل لتجنب انتهاك القانون الدولي، وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، غدا الثلاثاء، حيث ستُناقش الاتفاقية.
وأكد الخبير بقوانين الاتحاد الأوروبي وسياساته ألبرتو أليمانو أن "الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن تشير إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، المعروفة باسم "بند حقوق الإنسان".
من جانبه، قال جنتيان زيبيري لوكالة للأناضول إن الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانه تجاهل انتهاكات إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، وأضاف زيبيري: "يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني ووقف الفظائع الجماعية التي تحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
**********************************************
سوريا.. اشتباكات في السويداء تسفر عن قتلى وجرحى
دمشق - وكالات
رفضت الرئاسة الروحية للدروز في سوريا، أمس، دخول أي جهات، ومنها الأمن العام، إلى السويداء جنوبي البلاد. وقالت في بيان صحفي: "نرفض دخول أي جهات إلى المنطقة، ومنها الأمن العام السوري وهيئة تحرير الشام"، متهمة إياهما بـ "المشاركة في قصف القرى الحدودية ومساندة مجموعات تكفيرية باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة".
وحملت الرئاسة "كامل المسؤولية لكل من يساهم في الاعتداء أو يسعى لإدخال قوى أمنية إلى المنطقة"، مطالبة بـ "الحماية الدولية الفورية كحق لحماية المدنيين وحقنا للدماء".
وارتفع عدد الضحايا من جراء الاشتباكات والقصف المتبادل في السويداء جنوبي سوريا منذ صباح الأحد، إلى 89 قتيلا وعشرات المصابين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتواصل الاشتباكات في محافظة السويداء بين مجموعات عشائر البدو وعناصر وزارتي الدفاع والداخلية من جهة، ومسلحين دروز من جهة أخرى، في الجهة الغربية من المحافظة، منذ الأحد.
واندلعت الاشتباكات الأعنف أمس، بعد هجوم مسلح نفذته مجموعات من أبناء عشائر البدو بمشاركة عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، انطلاقا من ريف درعا الشرقي، مستهدفة عددا من قرى ريف السويداء الغربي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن "تدخل الدولة وفرض هيبة القانون داخل محافظة السويداء بات أمرا ضروريا ومطلبا شعبيا".
من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال، أنه نفذ هجوما استهدف عددا من الدبابات في قرية سميع بمحافظة السويداء، وقال في بيان صحفي: "هاجمنا عددا من الدبابات جنوب سوريا". دون تقديم مزيد من التفاصيل إضافية.
****************************************************
موسكو: الناتو يريد زج مولدوفا في الصراع معنا ترامب يدعم أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
موسكو - وكالات
أسقطت روسيا طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق مختلفة مساء الأحد، في الوقت الذي تعتزم فيه الإدارة الأميركية إعلان خطة جديدة لتسليح كييف بأسلحة هجومية كما سيطرح مجلس الشيوخ مشروع قانون يتيح للرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا.
وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية، في تراجع كبير عن موقفه السابق.
وذكر المصدران لأكسيوس أن الخطة، التي اقترحها الرئيس الأوكراني خلال قمة الناتو قبل أسبوعين، ستشمل على الأرجح صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى عمق روسيا.
كما نقلت أكسيوس عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن ترامب غاضب حقا من بوتين وإعلانه سيكون عدوانيا للغاية.
وكان ترامب أعلن مساء أمس أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ضرورية لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لأن بوتين "يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء".
من جانب آخر، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أمس، أن حلف شمال الأطلسي الناتو يستعد لزجّ مولدوفا في صراع مسلح محتمل مع روسيا.
وأفاد المكتب الصحفي للجهاز بأنه "وفقًا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن الناتو يستعد بنشاط لإقحام مولدوفا في صراع مسلح محتمل مع روسيا".
وأوضح أنه قد "اتُخذ قرار في بروكسل لتسريع تحويل مولدوفا إلى رأس حربة للحلف على الجناح الشرقي، مع الأخذ في الاعتبار تقدم القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا".
وأوضح البيان أنه: "بعد أن حسم الناتو أمره، يعمل جاهدًا على تحويل هذه الجمهورية الزراعية التي كانت في السابق منطقة سلمية إلى ميادين تدريب عسكرية. إنهم يحاولون جعل أراضي مولدافيا مناسبة للنقل العملياتي لقوات الناتو إلى الحدود الروسية".
************************************************
برلمان الاحتلال الصهيوني يقصي نائباً دافع عن فلسطين
القدس - وكالات
تسعى الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، إلى إقصاء النائب أيمن عودة من عضويته على خلفية منشورات له يؤيد فيها الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.
وحتى يصبح القرار نافذا يلزم الحصول على تأييد 90 نائبا من أصل 120، وسط تقديرات بعدم الحصول على هذه الأصوات.
وأصدرت جبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليسارية والرافضة للحرب على الشعب الفلسطيني، التي يرأس النائب أيمن عودة قائمتها في الكنيست، بياناً رفضت فيه هذا الإجراء.
وقالت الجبهة إن "الهيئة العامة تسعى إلى إقصاء عودة، وسط تباين بالتقديرات حول نجاح القائمين على هذه المحاولة بتجنيد 90 عضوا لصالح اتخاذ هذا القرار، وهي الأغلبية المطلوبة وفقا للقانون".
وأضافت: "محاولة إقصاء الرفيق والنائب أيمن عودة، هي استهداف للعمل السياسي ككل، وتندرج ضمن الحملة الممنهجة لاستهداف كتلة الجبهة البرلمانية كونها المعارضة الأشرس في الكنيست لحرب التجويع والإبادة وسياسات وممارسات اليمين الفاشي".
وأردفت: "هذه الملاحقات التي تطال قياداتنا وكوادرنا ليست إلا جزءا من الهجمة الفاشية على الجماهير العربية وقياداتها وعلى القوى اليهودية الديمقراطية وكل من يقول لا للحروب وللفوقية العنصرية وللفاشية".
وكانت لجنة من الكنيست صوتت في 30 حزيران الفائت بأغلبية 14 مقابل 2 على إقصاء النائب عودة ما مهد الطريق لطرح التصويت في الهيئة العامة.
وأُطلقت هذه الحملة على خلفية شكوى قدّمها عضو حزب الليكود، أفيخاي باروون، استندت إلى منشور وحيد على وسائل التواصل الاجتماعي نشره عودة في كانون الثاني 2025، عبّر فيه عن دعمه لصفقة تبادل الأسرى بغزة.
وكتب عودة بمنشوره آنذاك: "سعيد بتحرر المخطوفين والأسرى، من هنا يجب أن نحرر الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) من عنف الاحتلال، لقد وُلدنا جميعًا أحرارًا".
************************************************
إيران تلوح بالرد على العقوبات الأممية
طهران - وكالات
قالت الخارجية الإيرانية، إنه "لم يتم تحديد أي موعد أو موقع لعقد لقاء بين الوزير عباس عراقجي وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أن طهران سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أنه "لم يعد من المنطقي اللجوء إلى آليات الاتفاق النووي بعد الهجوم على المنشآت النووية السلمية". وأكد بقائي أن ما يهم طهران الآن وتعتبره أولوية هو رفع العقوبات "الظالمة" عنها.
كما أشار إلى أن آلية إعادة فرض العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة ليس لها أساس قانوني.
وقال بقائي إن بلاده سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية فرض العقوبات التلقائية.
وأضاف أن الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات.
وكان مصدر دبلوماسي فرنسي قال لرويترز الأسبوع الماضي إن قوى أوروبية ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب ما يسمى "آلية العودة السريعة" حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي يضمن المصالح الأمنية لأوروبا.
************************************************
كولومبيا.. مصادرة أصول شركة النفط البريطانية - الفرنسية لدعمها المليشيات
رشيد غويلب
لأول مرة، صادرت النيابة العامة الكولومبية أصول الشركة البريطانية – الفرنسية، كأجراء احترازي، بسبب تمويلها مليشيات خلال النزاع المسلح الداخلي. وخلال فترة حل أكبر مليشيا في البلاد " قوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا "، التي استمرت عشر سنوات، كشفت تصريحات عناصر المليشيا السابقة أن الشركة البريطانية الفرنسية تعاونت مع المليشيا المذكورة.
تخادم
في سنوات ١٩٩٧ - ٢٠٠٥، قامت الشركة بدعم مليشيا " قوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا " في مقاطعة كاساناري بالمال والوقود والغذاء والنقل، مقابل خدمات أمنية خاصة لحماية آبار النفط التابعة لها. ووفقًا لمكتب المدعي العام الكولومبي، مكّنت هذه المليشيات الشركة النفطية من زيادة إيراداتها خلال هذه الفترة المذكورة.
بواسطة شبكة استرداد الأصول التابعة لـ "مجموعة العمل المالي لأمريكا اللاتينية"، تمكن مكتب المدعي العام الكولومبي من الحصول على معلومات مهمة بشأن هيكل شركة النفط وهيكلية المراقبة داخلها. تقوم الأمم المتحدة بدعم هذه الشبكة، وتُسهّل على الدول الأعضاء فيها تحديد مصادر الأصول المتأتية من أنشطة غير مشروعة واستردادها. وقد قدّمت تقنيات التحليل الجنائي أدلة على تورط أعلى مستويات الشركة المذكورة في التمويل غير المشروع.
وافقت المحكمة العليا في كولومبيا باتخاذ إجراءات احترازية لمصادرة الأصول وتعليق صلاحية التصرف. وداهمت السلطات مكتبين تابعين للشركة. توظف الشركة حاليًا 400 منتسب في كولومبيا، وتنتج حوالي 14 ألف برميل نفط يوميًا.
وقامت النيابة العامة بتحويل الأصول المصادرة، التي تصل قيمتها إلى قرابة10 ملايين دولار أمريكي، إلى صندوق تعويض الضحايا حتى يمكن استخدامها لتعويض المتضررين من عنف المليشيات في مقاطعة كاساناري.
ورفضت الشركة، الأربعاء الفائت الاتهامات، نافية أي علاقات تربطها بجماعات غير قانونية، وترفض صرف أصول الشركة لصناديق التعويضات.
تعمل شركة النفط بشكل رئيسي في القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية، وقد اتُهمت بانتهاكات بيئية وحقوقية في مناسبات عديدة. في بيرو، خضعت الشركة لعشر عقوبات إدارية، بسبب 58 انتهاكًا بيئيًا في مقاطعة لوريتو بمنطقة الأمازون. وتزايد الضغط على شركة النفط بعد أن أعلنت وزارة الثقافة في بيرو عن وجود مجموعتين من آخر الشعوب الأصلية التي تعيش منعزلة في منطقة الغابات المتضررة.
في كولومبيا، تتورط شركات أخرى متعددة الجنسية في تمويل المليشيات. وتُتهم شركة كوكاكولا وشركة الموز تشيكيتا بدعم المليشيات واستغلالها لأغراضهما التجارية الخاصة، بما في ذلك اغتيال نقابيين وأعضاء في حزب الاتحاد الوطني اليساري في مقاطعة أورابا.
وفقًا للجنة كشف الحقائق في كولومبيا، كان 85 في المائة من ضحايا النزاع المسلح، الذي استمر لأكثر من نصف قرن، مدنيين. وكان العقد الممتد بين عامي 1995 و2004 عقدًا وحشيًا للغاية.
قرارات سابقة
وكانت هيئة محلفين أمريكية قد أدانت في 10 حزيران 2024 في ميامي شركة الموز" تشيكيتا براندز إنترناشيونال" لتمويها مليشيا «قوات الدفاع الذاتي المتحدة» في كولومبيا، وهي واحدة من المليشيات المعروفة بـ «فرق الموت». وفرض القرار على الشركة دفع 38 مليون دولار كتعويض لضحايا ثمانية أسر من عمال المزارع الكولومبيين تمت تصفيتهم. ويعد القرار أول انتصار كبير لأسر ضحايا عنف المليشيات في كولومبيا بعد 17 عامًا من الملاحقة القانونية.
وأكد القرار، الذي اعتبر تاريخيا أن شركة الموز قامت بتمويل مقصود للمليشيات بهدف تحقيق المزيد من الأرباح، على الرغم من انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان. وفي الولايات المتحدة تم تصنيف مليشيات فرق الموت كمنظمات إرهابية. وبواسطة دفع أكثر من 1,7 مليون دولار من الأموال غير الشرعية إلى المليشيات في سنوات (1997 إلى 2004)، ساهمت شركة الموز في معاناة وخسائر لا توصف في مناطق الموز الكولومبية على ساحل البحر الكاريبي، وشمل ذلك القتل الوحشي للمدنيين الأبرياء. واعترفت الشركة بما يسمى «مدفوعات الحماية» للميلشيات. وبهذا تم أخيرًا تعويض بعض ضحايا سلوك الشركة وعائلاتهم..
وتعتبر مليشيا" قوات الدفاع الذاتي المتحدة" واحدة من أكثر المليشيات اليمينية وحشية في الصراع المسلح في كولومبيا، وهي المسؤولة عن معظم عمليات القتل على الإطلاق. وتم تأسيسها لمحاربة حركات الكفاح المسلح اليسارية مثل القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وقام كبار ملاك الأراضي والشركات بتوظيف هذه المليشيات للدفاع عن ممتلكاتهم. كما تعاونت حكومات اليمين الكولومبية المتعاقبة وجيشها معهم، مما أدى إلى ارتكاب جرائم خطيرة ضد حقوق الإنسان. وبواسطة التهجير القسري، أنشأت المليشيات مناطق ضخمة لتربية الماشية والزراعة الأحادية للموز وزيت النخيل، حققت الشركات الكبيرة أرباحا طائلة منها.
*************************************************
الصفحة السابعة
ما حققته ثورة 14 تموز في القطاع الزراعي والريف العراقي يُؤشّر نجاحها
عبد الكريم عبد الله بلال*
تُعدّ ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة واحدة من أهمّ الأحداث التاريخية التي شهدها العراق في القرن العشرين، والتي أثّرت بعمق على الوضع العراقي في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تأثيرها الكبير في البنية التحتية للبلاد، لا سيّما في الريف العراقي الذي يُمثّل الشريحة السكانية الأكبر آنذاك، والذي طالته – إن لم يكن أكثر من غيره – تغييرات جذرية أعقبت انطلاق الثورة، شملت شتى جوانب الحياة. ويمكن إبراز أبرز هذه التغييرات في الآتي:
أولًا– في مجال التشريع: سعيًا لإنهاء الدور السياسي والاقتصادي للإقطاعيين وكبار الملاّك، وإجهاض أي تحرك مضاد للثورة من جانبهم، كان لا بدّ من تحجيم قوتهم الاقتصادية والسياسية عبر حزمة من التشريعات، أبرزها:
أ- قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958، الذي صادَرَ معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها الإقطاعيون وكبار الملاّك، حيث كان 1بالمائة فقط من السكان يمتلكون نحو 75بالمائة من أراضي العراق. وقد أُعيد توزيع هذه الأراضي على الفلاحين الفقراء، واستفادت من هذا الإجراء أكثر من 400 ألف عائلة فلاحية. ورغم وجود بعض الملاحظات على القانون، إلا أنه مثّل خطوة تقدمية بارزة في مسار الإصلاح الزراعي.
ب- إلغاء قانون دعاوى العشائر المدنية والجزائية، الصادر عام 1918، والذي كان يُستخدم كأداة قمع بيد الإقطاعيين وكبار الملاّك للهيمنة على الفلاحين في شتى مناحي الحياة.
ج- تنشيط العمل النقابي في الريف وتطوير الديمقراطية الاجتماعية، من خلال تشريع قانون رقم 79 لسنة 1959 الخاص بتأسيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، وقد شُكّلت آلاف الجمعيات من الشمال إلى الجنوب. إلا أن هذه الخطوة لم تلقَ رضا البرجوازية الوطنية الحاكمة آنذاك، التي رأت في هذا الاتحاد تهديدًا لهيمنتها على الريف، فتحركت لاحقًا لإصدار قانون جديد أنهى دور الاتحاد في تشكيل الجمعيات، وأسند إدارتها للسلطات المحلية، التي قامت بدورها بإلغاء أكثر من 3 آلاف جمعية فلاحية، ومن ثم سلّمت إدارتها لأتباعها. ورغم ذلك، استمرت الكوادر الفلاحية النشطة في إدارة الصراع داخل الريف والدفاع عن حقوق الفلاحين حتى انقلاب شباط الأسود، الذي أجهض الثورة.
د - تطوير العمل التعاوني والجماعي في الريف، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الاقتصاد الريفي، من خلال تأسيس جمعيات تعاونية زراعية. فقبل الثورة، لم يكن هناك سوى 16 جمعية تعاونية، بينما ارتفع العدد بعد الثورة إلى 436 جمعية تعاونية زراعية، ما يُعدّ قفزة نوعية في العمل الزراعي.
ثانياً– إعادة البناء وتطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي والريف عمومًا، وشمل ذلك ما يلي:
أ- بناء وتشغيل أربعة سدود: دوكان، الثرثار، أسكي كلك، وأعالي الفرات.
ب- إنشاء معملين في مجال الصناعة الزراعية: أحدهما للآلات والمعدات الزراعية، والآخر لصناعة الجرارات الزراعية في الإسكندرية.
ج- شملت الجهود أيضًا بناء العديد من المصانع في مجال الصناعات التحويلية، إذ أُنشئ 25 معملًا للطحين، و14 معملًا لكبس التمور، بالإضافة إلى معمل لدباغة الجلود والسجائر في السليمانية، ومعملي الأسمدة الكيمياوية والورق في البصرة، فضلًا عن معمل ألبان أبو غريب. وفيما يتعلق بالبنى التحتية الريفية، فقد شهدت القرى والأرياف نهضة عمرانية واضحة، تمثلت في تعبيد وتبليط آلاف الكيلومترات من الطرق الريفية، وبناء آلاف المدارس والمستوصفات في مختلف مناطق الريف العراقي، إلى جانب إنشاء مئات المراكز الخاصة بتطوير المرأة الريفية ومراكز للنشء الريفي. إلا أن هذه الإنجازات، للأسف، لم تصمد في وجه المتغيرات السياسية التي أعقبت عام 2003، حيث استولت جهات متنفذة وبعض الأحزاب على عدد كبير من هذه المراكز، وحوّلتها إلى مقار حزبية أو دور سكنية خاصة.
لقد تحقّقت هذه الإنجازات الكبيرة خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الأربع سنوات، رغم الصراع الحاد بين قوى الثورة والقوى المضادة، إلى جانب الضغوط الخارجية المكثفة التي سعت لإسقاط التجربة الثورية. ومع ذلك، تم إنجاز ما يُعدّ ثورة حقيقية في القطاع الزراعي والريف العراقي، وهو ما يكفي للتدليل على أهمية وتأثير ثورة تموز 1958.
ـــــــــــــــــــــــ
* مهندس زراعي استشاري
***********************************************
لمصلحة منّ حل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية؟
سعد كاظم
قبل أيام وبشكلٍ مفاجئ صوّت مجلس الوزراء على تصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وهي واحدة من أهم المؤسسات الداعمة للقطاع الزراعي في العراقي، المؤسسة شبه حكوميّة تأسست لدعم وتطوير القطاع الزراعي في العراق بموجب قانون وزارة الزراعة والري، والقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٧، وهي إحدى شركات التمويل الذاتي.
يتمحور تفويضها التأسيسي حول ضمان توفير المدخلات الزراعية الحيوية، وإمكانية وصولها للمزارعين في جميع المحافظات. وتُعد الشركة ذراعًا رئيسيًا لتنفيذ السياسات، والبرامج الحكومية الرامية إلى النهوض بالزراعة، ودورها المحوري يدخل في صميم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي. و يمكن اعتبار الشركة ليست مجرد كيان إداري، بل هي شريك فعّال للمزارعين، و ركيزة أساسية للسياسة الزراعية في العراق، حيث تعمل بشكلٍ رئيسي كذراع تنفيذي للحكومة لتوزيع المدخلات الزراعية الأساسية، والتي غالبًا ما تكون مدعومة لضمان الجودة و النوعية والدعم الفني، وتحقيق استقرار السوق، وهي توفر مجموعة واسعة من الفوائد، غالبًا ما تكون بأسعار مدعومة، للمزارعين والكيانات الزراعية في جميع أنحاء العراق، تشمل جميع أنواع الأسمدة، و منظومة الري الحديثة، والمكننة الزراعية والبذور وشتلات الفاكهة، و المبيدات و اللقاحات البيطرية، وبأسعار رمزية، وتأثيرها الاستراتيجي على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي الوطني كبير جدا، فضلا عن إسهامها مع الشركات التابعة لوزارة الزراعة ومديرية الإرشاد الزراعي بمعالجة التحديات التي يواجهها الفلاح، سواء تكنولوجية أو فنية او نظامية، كما تسهم في توفير مكملات الإنتاج الزراعي وتسهيل تبني التقنيات الزراعية الحديثة من خلال ضمان حصول المزارعين عليها، بالأخص الأسمدة و نظم الري الحديثة من خلال توفير أدواتها في ظل ندرة مياه الزراعة في العراق بعد تحديد نسبة المياه في كل من دجلة والفرات من دول المنبع التي تُعد كارثة اقتصادية متفاقمة بسبب انخفاض مستمر في كميات المياه الواردة من دول الجوار، وتصرفات تركيا وإيران، و انخفاضها إلى 80 بالمائة، اي ما يحصل عليه العراق هو 20 بالمائة فقط من استحقاقه، مما يُهدد الأمن المائي والثروة الوطنية فهي ليست مجرد كيان تجاري، بل هي أداة حاسمة للسياسة الحكومية الهادفة إلى الدعم الاجتماعي وتحقيق استقرار السوق.
فهذه الشركة تعد لاعبًا حيويًا في المشهد الزراعي العراقي، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاجية والأمن الغذائي وتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المزارعين في العراق.
وقرار حلها سيسهم في تدهور القطاع الزراعي ويرجعنا للوراء وستُنشَأ شركات بديلة لها يديرها الإقطاعيون الجدد، وأصحاب الأموال المنهوبة، ليقوموا بدور ما توفره الشركة إلى المزارع والفلاحين، ولكن بأسعار عالية جدا ترهق المزارع، وهذه دعوة للتراجع عن هذا القرار الخاطئ، حفاظا على تاريخ وتراث وأهمية هذه الشركة للقطاع الزراعي.
ــــــــــــــــ
* مهندس زراعي
***********************************************
حفظ التمور
د. علي سالم
التمور من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية والانتشار الواسع في المناطق الحارة والجافة، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحتل العراق – حسب تصريح لوزارة الزراعة - المركز الأول عالميا بعدد النخيل والذي يصل الى أكثر من 22 مليون نخلة، كما يّعد رابع منتج للتمور على مستوى العالم حيث تم تصدير 700 ألف طن من التمور في عام 2024 حسب نفس التصريح.
وتُعد عملية حفظ التمور ذات أهمية قصوى لضمان سلامتها أثناء التخزين والنقل والتسويق. ومع التقدم في تقنيات الحفظ الغذائي، ظهرت طرق جديدة ومبتكرة تتجاوز طرق التجفيف الشمسي والتخزين في غرف باردة.
تُصنّف التمور حسب نسبة الرطوبة إلى ثلاثة أنواع، التمور الجافة (رطوبتها أقل من 15بالمائة)، نصف الجافة (رطوبتها 15-25بالمائة) والطرية (تزيد رطوبتها عن 25بالمائة). وكلما زادت الرطوبة زادت الحاجة إلى تقنيات متقدمة للحفظ، لتقليل احتمالية التخمّر أو نمو الفطريات والبكتيريا. ومن أهم هذه الطرق:
- التبخير الحراري والبخاري: حيث يستخدم البخار الساخن لتعقيم التمور قبل التخزين أو التعبئة، بهدف قتل الحشرات ومسببات الأمراض. يُعد هذا البديل أكثر أمانًا من المبيدات الكيميائية، ويساهم في التخلص من بيض الحشرات والآفات دون التأثير على الطعم أو الجودة.
- التعبئة في الهواء المعّدل (Modified Atmosphere Packaging - MAP): تتم تعبئة التمور داخل عبوات تحتوي على خليط من الغازات مثل النيتروجين وثاني أكسيد الكربون بدلًا من الهواء العادي، مما يؤخر الأكسدة ونمو الفطريات دون إضافة مواد حافظة. تحتاج الطريقة لقاعات محكمة الإغلاق لضبط تركيبة الغازات.
- التبريد والتجميد، خاصة للتمور الطرية، حيث تُخزَّن في درجات حرارة منخفضة تتراوح بين 0 و4 درجات مئوية، أو تُجمَّد تحت -18 درجة مئوية لفترات طويلة. وتحافظ هذه الطريقة على الطزاجة واللون والنكهة، مع ملاحظة تغير نسيج التمرة عند الذوبان بعد التجميد.
- استخدام النانوتكنولوجيا في التغليف: بدأت بعض الأبحاث في تطبيق تقنية النانو في أغلفة التمور، لجعلها أكثر مقاومة للميكروبات، وتنظيم نقل الرطوبة والأكسجين من وإلى الثمرة، لحمايتها من التلف والعفن. وهي على العموم طريقة في مرحلة البحث ولم تُعمّم تجاريًا بعد.
- الطلاء الحيوي (Edible Coatings): يُستخدم طلاء شفاف يؤكل، مصنوع من مكونات طبيعية مثل الكيتوزان أو البروتينات النباتية، لتغطية التمور ومنع جفافها وتلوثها. وتعّد هذه طريقة طبيعية لإطالة عمر المنتج دون التأثير في المذاق، لكنها تتطلب الدقة في التطبيق للحفاظ على الجودة.
وأخيراً، تمثل التمور ثروة غذائية واقتصادية، ويصبح تبنّي الطرق الحديثة في حفظها خطوة ضرورية لتحقيق سلامة الغذاء وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. كما ينصح بالجمع بين تقنيات الحفظ الفيزيائية (كالحرارة والتبريد) والبيولوجية (كالطلاء الحيوي والتغليف النانوي) فلهذا الجمع مستقبل واعد.
**************************************************
توفير الماء والطعام ليس تفضلاً أو خياراً سياسياً، بل هو جوهر العقد الاجتماعي
عصام الياسري
في بلد يعرف تاريخيا بأنه "أرض الرافدين"، بات الحديث عن نقص المياه واتساع رقعة الجفاف، حديث الساعة وغير منفصل عن أزمة الكهرباء في فصل الصيف ومن أكثر القضايا إلحاحا وخطورة على الأمن القومي والمعيشي والبيئي. ففيما تستمر تركيا وإيران بسياسات مائية أحادية تهدد حياة الملايين من العراقيين، يبرز غياب التحرك الحكومي الفاعل كواحد من أبرز أسباب تفاقم الأزمة.
في العرف القانوني والمجتمعي، يعتبر توفير الماء والغذاء من أهم الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق أي حكومة. فالماء ليس موردا طبيعيا فحسب، بل هو حق إنساني أساسي، منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومؤكد عليه في الاتفاقيات البيئية والمائية الدولية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية.
إلا أن هذا الواجب في العراق بات محل تساؤل، لا سيما مع ما تشهده البلاد من انخفاض حاد في مناسيب نهري دجلة والفرات، وتصاعد معدلات التصحر، وتراجع المساحات الزراعية، وتزايد حالات النزوح الداخلي المرتبطة بشح المياه، خاصة في الجنوب
ما من شك في أن تركيا تتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم أزمة المياه في العراق، بسبب مشاريعها الضخمة، وعلى رأسها "سد إليسو"، الذي تم تشغيله دون تنسيق مع بغداد، رغم ما يترتب عليه من تقليص حاد في تدفق نهر دجلة ومع أن تركيا لم تصادق على اتفاقية 1997، إلا أنها تبقى ملزمة بمبادئ القانون العرفي الدولي، الذي ينص على الإنصاف، وعدم الإضرار، والتشاور المسبق في مشاريع الأنهار المشتركة.
أما إيران، فقد ذهبت إلى خطوات أكثر حدة، من خلال قطع وتغيير مجاري الأنهار والروافد التي تصب في الأراضي العراقية، دون أي التزام بالقواعد الأخلاقية أو القانونية، مما زاد من حدة الجفاف في محافظات ديالى، واسط، وميسان...
إن سياسات الأمر الواقع وتجاهل القانون الدولي والضغوط المتعددة الأشكال التي تمارسها تركيا وإيران: يتطلب من الحكومة العراقية ومؤسساتها صاحبة الشأن، القيام وبكل الوسائل بما في ذلك استعمال ورقة العقود التجارية والاقتصادية كأداة ضغط للوصول إلى آلية دائمة لمراقبة وتقييم التصريفات المائية من خلال تحديث الاتفاقيات الثنائية مع تركيا وإيران، والسعي لإبرام اتفاقيات ملزمة جديدة تضمن الحصص المائية العادلة للعراق، على أساس مبادئ الإنصاف، وعدم الإضرار، والتقاسم العادل.
داخليا، يجب أن تعمل الحكومة على إصلاح الإدارة المائية، وتطوير البنى التحتية للري والتخزين، وتحفيز الزراعة الذكية المستجيبة للواقع المائي الجديد، والتقليل من الهدر في الاستخدامات الزراعية والصناعية، لتخفيف الاعتماد على المصادر الخارجية.
ومن المنظور القانوني، تلزم الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والمجتمعية ـ الدول الأطراف ـ باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأفراد "المواطنين" على الغذاء الكافي والماء النظيف والآمن ويعد الإخلال بهذه الالتزامات انتهاكا صريحا للحقوق الأساسية المنصوص عليها، وقد يترتب عليه مسؤولية قانونية تجاه الأفراد الذين تسببوا في نشوء الأضرار البشرية والبيئية.
أما من المنظور الأخلاقي والمجتمعي، فإن توفير الطعام والماء لا يعد تفضلا أو خيارا سياسيا، بل هو واجب أصيل يعبر عن جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. فمستوى وفاء الحكومة بهذه المسؤولية يعود معيار مركزي لقياس مدى التزامها بواجباتها الإنسانية، ومدى احترامها للكرامة البشرية، خصوصا- في ظل الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
إن أزمة المياه في العراق ليست قضية بيئية فقط، بل قضية وجودية وسيادية. فاستمرار الصمت الحكومي والركون إلى الخطابات الدبلوماسية دون فعل، سيفتح الباب أمام انهيار بيئي ومعيشي واسع، ويفاقم من الهجرة والنزاعات الداخلية مستقبل. وعليه، فإن ضمان حق المواطنين في الغذاء والماء يمثل ليس فقط التزاما قانونيا على الدولة، وإنما مسؤولية أخلاقية عميقة تجسد جوهر وجودها ووظيفتها الاجتماعية.
الوقت لم يعد يسمح بالتأجيل أو المجاملة واستمرار الصمت أو التحرك المحدود أمام ما يشهده العراق من أكبر أزمة مائية في تاريخه الحديث. بل يعد خرقا خطيرا للواجب السيادي والإنساني الذي تتحمله الدولة، ويهدد مستقبل الاستقرار السكاني والغذائي والاقتصادي للبلاد.
في كل دساتير العالم، يعد الماء والغذاء من أقدس الحقوق التي لا يجوز المساس بها. لكن الواقع العراقي يقول العكس تماما. ملايين العراقيين اليوم مهددون بالعطش، والنزوح، وانهيار سبل العيش، في وقت يفترض أن تكون الحكومة هي الجدار الأول لحماية هذا الحق، لا أول المتقاعسين عنه أمام تلاعب تركيا وإيران بحقوق العراق الطبيعية، وانتهاكهما الفاضح للقوانين الدولية.
إن التقصير الرسمي لا يكمن فقط في غياب الضغط، بل في غياب الرؤية أيضا. لكن، حتى لا يتحول العراق إلى بلد صحراوي بالكامل، لا بد من تحرك وطني، شعبي وإعلامي ومؤسساتي، سريع وشجاع، يقوم على: مطالبة الحكومة العراقية بالتحرك الفوري والحاسم، وإلا فإن الجفاف لن يكون مجرد موسم عابر، بل عنوانا دائما لمستقبل البلاد.
***********************************************
الصفحة الثامنة
من كتاب التاريخ السياسي العراقي الحديث سطوة الشركات وانقلابات الحكم
خليل إبراهيم العبيدي
من يتصفح كتاب مباحثات الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم مع المفاوض البريطاني هدريج، يدرك حقيقة تأثير شركات النفط البريطانية، وفي مقدمتها شركة I.P.C، على قرارات العراق السياسية آنذاك. وكان من نتائج الخلاف الحاد مع ممثل تلك الشركات أن أصدرت حكومة ثورة 14 تموز قانونًا تاريخيًا هو القانون رقم 80 لسنة 1961، الذي تم بموجبه تحديد مناطق استخراج النفط للشركات الأجنبية. وقد اعتبر هذا القرار أحد الأسباب المباشرة لإعدام الزعيم في انقلاب 8 شباط الأسود عام 1963.
حين عرض عبد الكريم قاسم القانون على مجلس الوزراء للتوقيع، قال عبارته الشهيرة: "وقّعوا على قانون إعدامكم"، في إشارة إلى تداعيات القرار السياسية والأمنية.
رغم ذلك، استمر استغلال الشركات لموارد العراق النفطية، مما أدى إلى أزمة سيولة نقدية حالت دون إمكانية دفع رواتب موظفي الدولة لعدة أشهر خلال عام 1967. وقد كنت شاهدًا على تلك المرحلة الاقتصادية المتعثرة، إذ اضطُر الرئيس عبد الرحمن عارف إلى الاستدانة من أجل تغطية الرواتب، وقيل حينها إن القرض جاء من جمهورية الصين الشعبية.
في هذا السياق، أصدرت الحكومة القانون رقم 97 لسنة 1967، تأكيدًا للقانون رقم 80، وكلفت بموجبه شركة النفط الوطنية العراقية بالبحث عن الأسواق وتسويق النفط، في ظل استمرار الخلاف مع الشركات الأجنبية التي كانت تصرّ على حرية الاستكشاف والاستخراج في جميع الأراضي العراقية، بينما كانت الدولة تصر على الالتزام بالمناطق المحددة بالقانون، وضرورة الحصول على موافقة الحكومة قبل أي استكشاف جديد. إضافة إلى ذلك، لم تكن الشركات تقدم عائدات منصفة لخزينة الدولة، ما جعل الحالة المالية للبلاد تتدهور.
ورداً على هذا الوضع، منح الرئيس عبد الرحمن عارف امتياز استثمار حقل شمال الحلفاية إلى شركة "إيراب" الفرنسية، ما أثار استياء الشركات الأمريكية. وفي تلك الفترة، وصل إلى بغداد وزير المالية الأمريكي الأسبق هندرسون حاملاً رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر، يدعو فيها الرئيس عارف إلى التعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط والكبريت. لكن الرئيس عارف فضّل الشركات الفرنسية في استثمار النفط، والشركات البولندية في استثمار الكبريت.
وقد كانت هذه الواقعة هي "القشة التي قصمت ظهر البعير"، إذ لم تمضِ فترة طويلة حتى نُفذ انقلاب 17 تموز 1968. وتشير مصادر إلى أن الدكتور ناصر الحاني، الذي كان على علاقة وثيقة بالسفارة الأمريكية في بيروت، قام بتسليم حردان التكريتي أموالًا من الولايات المتحدة لتنفيذ الانقلاب. وبعد فترة وجيزة من نجاح الانقلاب، تم تصفية الحاني، الذي شغل منصب وزير خارجية الانقلاب لأسبوعين فقط، لتُطوى معه أسرار التآمر على شخصية وطنية مثل عبد الرحمن عارف.
وفي تصريح صحفي له من إسطنبول، قال الرئيس عبد الرحمن عارف:"إن النايف لم يكن سوى أداة حركها إغراء المال من قبل شركات النفط العاملة في العراق، والدول التي تقف وراءها، لأن السياسة النفطية التي اتبعتها حكومتي أضرت بمصالح هذه الشركات."
وأوضح أنه منح عقدًا لشركة "إيراب" الفرنسية بدلًا من الأمريكيين، وعقد اتفاقية تفاهم ومساعدة فنية مع الاتحاد السوفيتي لاستثمار حقل الرميلة، وربطه بشركة النفط الوطنية. كما حرمت الحكومة شركة "بان أمريكان" الأمريكية من امتياز استثمار الكبريت، وقررت استثماره وطنيًا، مما دفع تلك الشركات ودولها إلى السعي لإسقاط الحكم.
ويتابع عارف قائلاً إنهم وجدوا في عبد الرزاق النايف الشخص المناسب، و"اشتروه" عبر وسطاء هما الدكتور ناصر الحاني وبشير الطالب، مؤكدًا أن هذه المعلومات "عن معرفة وليست مجرد شكوك."
30 تموز.. انقلاب على انقلاب
لم تدم حكومة عبد الرزاق النايف سوى أسبوعين فقط. ففي 30 تموز 1968، زحفت منظمة حنين وعدد من الجنرالات نحو القصر الجمهوري. وبعد غداء ذلك اليوم (وكان من لحم الغزال)، أشهر صدام حسين مسدسه بوجه الجنرال النايف واقتاده إلى منفاه. أما الجنرال الداوود، فكان آنذاك في عمان يتفقد القطعات العسكرية العراقية المعسكرة في الأردن، بصفته وزيرًا للدفاع. وهكذا، كان ما جرى في 30 تموز انقلابًا على الانقلاب، وأدى إلى استقرار الحكم في يد حزب البعث منفردًا.
ذلك الحكم الذي سيطر عليه صدام حسين لاحقًا، وملأ كل فصوله، وصولًا إلى احتلال العراق عام 2003. والغريب أن صدام، الجنرال المزيّف، وافق لاحقًا على منح راتب تقاعدي للرئيس عبد الرحمن عارف، بعد أن شكا الأخير لضباط عراقيين من سوء حالته المعيشية.
ويبقى السؤال.. أي دور خطير لعبته شركات النفط الأجنبية في رسم مصير العراق؟ وكم انقلابًا كانت وراءه؟
**********************************************
أغنية دم جديدة
رشدي العامل
الى عبد الكريم قاسم....
نطفئ عينيه...
وغارت أرجل الديدان،
تحفر في الليل، طريق الموت للإنسان
تأكل حتى رعشة الجذور، في البستان
حتى العيون الليل،
حتى حلم الأجفان
تأكل حتى الموت،
حتى نفسها....الديدان
(تطفئ عينيه....)
فيا... زغردة الحسان
يا ضحكة الصبيان،
موتى على الشفاه،
حلما،
بائسا، مهان
موتى بلا لون، أذا ما اختلج الدخان
في ظل عينيه، وماجت أذرع الديدان.
***
كنا هنا يوما،
وكان الموت....
يا ما كان
في أضلع الشيوخ، والنساء، والفتيان
تنحه العيون،
في وداعة النسيان
لكنه اليوم..
ويا متاهة الأحزان
أسود، مما تترك الأغان
حين يموت الصوت..
والرجفة...
والألحان
***
(تطفئ عينيه....)
أيا عمرا بلا ثوان
لن تخنق الفرحة عند شعبنا يدان
لن تخنق الجذور،
لن تكسر الأغضان،
كل فؤوس الليل،
كل اذرع الديدان
فارتجفي يا رعشة الهوان
في المقل الصفر...
وموتي في فم الجبان
والمجد يا كريم........
إن المجد....للإنسان
**************************************************
في كربلاء.. الشيوعيون يحتفلون بذكرى الثورة
كربلاء – طريق الشعب
أقامت المختصة الثقافية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، يوم الاحد الماضي، احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 14 تموز 1958، التي عدّها المشاركون "نقلة نوعية في حياة الإنسان العراقي". استُهلت الأمسية، التي استضافت الرفيق سلام القريني، بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء الثورة والحركة الوطنية.
وأكد القريني في كلمته أن قوى اليسار والحركات الوطنية دأبت على إحياء ذكرى الثورة سنويًا، تقديرًا لما حققته من منجزات في مجالات السكن والتعليم والاقتصاد والثقافة، رغم أن قوى الظلام سعت لإجهاض الثورة واغتيال قادتها.
وقال إن منجزات الثورة لا تزال تثير حفيظة خصومها، مشيرًا إلى ما قدمه قادتها وشخصياتها البارزة مثل عبد الجبار عبد الله، عبد العزيز الدوري، محمد حديد، إبراهيم كبة، والشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، وغيرهم، في بناء الدولة العراقية الحديثة.
وانتقد القريني محاولات تجاهل هذه الذكرى وطمسها من الذاكرة الوطنية، واصفًا إياها بـ"الشوكة في خاصرة من رفض التصويت على جعلها يومًا وطنيًا". وشهدت الأمسية مداخلات من عدد من الحضور، بينهم الدكتور عدنان عبيد المسعودي، الذي عبّر عن اعتزازه بالمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا على "أهمية إعادة قراءة التاريخ، خاصة لأبناء الريف الذين عانوا من ظلم الإقطاع"، محذرًا من أن "القادم أسوأ ما لم تُواجه قوى التخلف بسياسات بديلة". واختُتمت الأمسية بمشاركة عدد من الرفاق والأصدقاء، في أجواء احتفالية جمعت بين الحنين إلى الماضي واستذكار دروسه، والدعوة إلى استعادة روح الثورة في مواجهة التحديات الراهنة.
********************************************
في بهرز.. ندوة حول ثورة 14 تموز
بهرز – طريق الشعب
شهد مقر اللجنة الأساسية للحزب الشيوعي العراقي في قضاء بهرز بمحافظة ديالى، أخيرا، ندوة حول ثورة 14 تموز 1958، في مناسبة ذكراها الـ67.
الندوة التي حضرها عدد من الرفاق، أدارها الرفيق عبد اللطيف أسد محمد، وألقى خلالها الباحث قاسم البيك محاضرة أوضح فيها الملابسات التي أحاطت حركة تموز، من حيث اعتبارها ثورة أو انقلابا.
وأشار إلى التفاف الجماهير حول الثورة التي غيرت التشكيلية السياسية والاجتماعية، وحررت البلاد من الاستعمار وخلصتها من المعاهدات، وأحدثت نقلة نوعية في حياة الناس، وأتاحت تأسيس تنظيمات نقابية ديمقراطية.
فيما تطرق إلى اسباب انتكاسة الثورة، وأبرزها فردية الحكم وعدم استغلال فرصة التفاف الجماهير حول الثورة لتكون طوق حماية لها، إلى جانب عدم اصدار دستور دائم يضمن اقامة انتخابات ديمقراطية، وعدم الاعتماد على المخلصين للثورة، فضلا عن عوامل أخرى داخلية وخارجية ساعدت في حصول الانقلاب الدموي في 8 شباط 1963.
*******************************************
زارت مؤرخ ثورة تموز المحلية العمالية تتفقد الرفيق نعمان رجب
بغداد - عامر عبود الشيخ علي
زار وفد من اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي صباح أول أمس الجمعة، الرفيق نعمان رجب (ابو علي) في منزله، للاطمئنان عليه بعد خضوعه لعملية جراحية.
ونقل الوفد الذي ضم سكرتير المحلية وعددا من اعضائها، الى الرفيق رجب تحيات قيادة الحزب ورفاقه وتمنياتهم له بوافر الصحة والسلامة.
من جانب آخر، وتزامنا مع ذكرى ثورة 14 تموز 1958، زار وفد المحلية مؤرخ الثورة هادي جواد الطائي، للاطمئنان على صحته، والاستماع إلى حديثه عن مساهمته في الثورة.
ونقل الوفد إلى الطائي تحيات الحزب.
جدير بالذكر أن المحلية العمالية رفعت في عدد من مناطق بغداد، شعارات في ذكرى ثورة تموز.
******************************************
الصفحة التاسعة
نقد الأداء الوظيفي هل يعتبر جريمة؟
سالم روضان الموسوي*
"الثقافة تنوع معرفي وابداعي، من هنا نُعنى بتقديم كل الثقافات المجاورة للأدب والفن والفكر.. وبهدف اغناء المثقف بالقوانين، نقدم هذه الدراسة القيمة للقاضي الاستاذ سالم روضان الموسوي، بوصفها على تماس بالنقد والقانون" المحرر الثقافي.
ان النقد كما عرفه فقه القانون والقضاء بانه (إبداء الرأي في أمر من الأمور أو عمل من الأعمال دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل، أي لا يمس بشرفه أو اعتباره)، والنقد له نطاق محدد لا يمكن تعديه والا انقلب الى جريمة قذف وسب بحق صاحب الرأي ومن الممكن ان يخضع للعقوبة التي تقررها القوانين العقابية، وهذا النطاق يحدده نوع العمل محل النقد حيث له مجالات عديدة منها النقد السياسي والتاريخي بل حتى على مستوى النقد الأدبي. ويقول طه حسين، ان النقد هو منهج فلسفي لا بد أن يتجرد الناقد من كل شيء وأن يستقبل النص المطلوب نقده وهو خالي الذهن مما سمعه عن هذا النص من قبل.
وفي النقد السياسي ان بعض من امتهن عمل التحليلات السياسية وانتقاد الحكام أو وزير ما في شؤون تتعلق بعمله، الا ان هذا النقد أو التعليق تضمن عبارات قد يراها البعض شائنة، مثال: انه وزير ضعيف أو انه وزير للأغنياء فقط ورجال الأعمال، أو انه يتعجل بيع الشركات الناجحة أو انه مسؤول عن أرواح الضحايا أو أن وزارته فاسدة أو يجب إقالته.
هذا النقد الذي وجه للمسؤول اذا كان متعلقا بأعمال وزارته ولم يلحق بشخصه، إلا بالقدر الذي يمس عمله وكان الغرض منه هو النقد، حتى ولو كان لاذعا أو به شطط أو حتى عبارات شائنة لا يعد جريمة، طالما أن الغرض منه إبراز وتوضيح هذه التصرفات للجمهور، وبشكل يستطيع أن يفهمها ويدرك أبعادها وحقيقتها، فلا عقاب عليه، ويترك الأمر لسلطة المحكمة التقديرية من ظروف وملابسات الدعوى، بل ان هذا النقد يسري حتى على الذين لا يشغلون وظائف عامة مثل المرشحين في الانتخابات ونحن على أبواب انتخابات برلمانية، وفي تطبيقات القضاء الفرنسي الذي قضى ببراءة صحفي من تهمة القذف على اعتبار إن العبارات التي تحوي قذفاً في حق احد المرشحين بإنها لم تنشر بغرض الانتقام أو الكراهية، وإنما بهدف إعلام الناخبين عن ماضي المرشح، وعلى وفق ما جاء في قرار الغرفة الجنائية في محكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ 28/6/2017 والذ جاء فيه تأكيد على أن النقد الموجه لمرشح في سياق حملة انتخابية أو نقاش عام حول قضية ذات مصلحة عامة فان هذا النقد يتمتع بحماية واسعة، وانه نقد مبرر لأنه يسعى لإعلام الناخبين بالمعلومات المتعلقة بالمرشحين، حتى لو كانت هذه المعلومات سلبية، طالما أنها تخدم المصلحة العامة الحقيقية .
ان مصدر هذا الحق (حق نقد الأداء الوظيفي) متوفر في عدد من الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية والإقليمية، كما وجدت له مرجعية في التشريعات الوطنية (المحلية) وكانت له إشارات ضمنية في النصوص الدستورية والقانونية تحت عنوان (حرية التعبير، او حرية الرأي، وكذلك حرية المعتقد) ومنها ما ورد في المادة (36) من دستور العراق لعام 2005، التي تنص على ما يـأتي (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون). وفي المادة (42) من دستور العراق لعام 2005 التي تنص على ما يأتي (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة).
بل وجدنا إن المشرع العراقي عد القذف الموجه إلى الموظف العمومي يكون بمثابة الفعل المباح، في حال توفر بعض الشروط التي تتطلبها المادة (433) من قانون العقوبات العراقي، ويشترط أن يكون متعلقا بشخص عام، ويتعلق بعمل من الأعمال المسندة إليه في وظيفته، والا كلف بإثبات الواقعة المنسوبة اليه وتقديم الدليل على ذلك، وبخلافه يعتبر مرتكبا لجريمة القذف التي تصل عقوبتها الى الحبس لمدة خمس سنوات.
وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي الميدان الاوسع للنقد حيث اعتبرت هذه المواقع ظاهرة اجتماعية لها حضور وتأثير في مجمل نواحي الحياة الخاصة والعامة، وان كانت حديثة العهد نسبياً من حيث التكوين والتأثير، إلا انها أصبحت ظاهرة تكتسب كل يوم آفاقا جديدة وأصبحت قائمة الشعوب والمجتمعات التي استخدمته تطول وتكبر يوما بعد يوم، بل يرى البعض إننا في عصر الفيسبوك واعتبرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها (الفيسبوك) وسيلة من وسائل الإعلام، وتسمى بالإعلام الجديد أو البديل ( new media) فهي تعتبر مرحلة في انتقال أدوات الإعلام والاتصال من المؤسسات إلى الجمهور كونها مصدراً لرفد الوسائل التقليدية في الإعلام بالأخبار والمعلومات.
لكن هل الواقع الراهن يمنح الأشخاص ومنهم الإعلامي والمختص فرصة توجيه النقد الى الأداء الوظيفي؟
الجواب ليس بالمطلق نفياً او بالإيجاب، لأن القضاء المكلف بتوجيه الاتهام وفرض العقوبة على المتهم هو الذي يحدد الفعل هل هو ضمن نطاق النقد المباح ام انه تعدى ذلك الى الاعتداء على الشخص محل النقد، لذلك نجد هناك تفاوتا في الاحكام حسب كل قضية.
لكن لوحظ وجود مشترك بين جميع قضايا النقد الموجه الى الأداء الوظيفي في الفترة الأخيرة، وجود ميل نحو التغليظ والتشديد تجاه هكذا نوع من النقد، حيث صدرت عدة احكام قضائية اعتبرت ان هذا النقد يعد إهانة للسلطات، وكيفت الفعل على انه ينطبق واحكام المادة (226) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها (أولا: يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى الطرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية. ثانيا: لا يعد إهانة وفقا لما ورد في البند ( أولاً ) أعلاه كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية أو حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية). والإهانة كما عرفها الفقه الجنائي بانها الاعتداء على شرف ومكانة المعتدى عليه.
وحيث ان القانون يسعى لحماية الأفراد والأشخاص المعنوية من أي اعتداء، ولان فعل الإهانة يعد من الأفعال التي تتضمن شتيمة فيها إذلال واحتقار موجه إلى شخص المهان، فكان على المشرع ان يحمي شرف ومكانة الهيئات النظامية وكذلك العاملين فيها. إلا انه فرّق بين إهانة الكيانات التي تمثل الهيئات النظامية وبين إهانة الموظفين العاملين فيها، حيث اعتبر إهانة الكيانات اشد ضرراً من إهانة الموظفين العاملين فيها لأنه جعل عقوبة جريمة إهانة رئيس الجمهورية اقسى من جريمة إهانة الهيئات النظامية، كما جعل عقوبة تلك الجريمتين اقسى واشد من عقوبة الاعتداء على العاملين في تلك الهيئات، وعقوبة جريمة إهانة رئيس الجمهورية السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس، وعلى وفق ما ورد في المادة (225) عقوبات وعقوبة جريمة إهانة الهيئات النظامية السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس او الغرامة وعلى وفق ما ورد في المادة (226) عقوبات. كذلك عقوبة جريمة إهانة الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة وعلى وفق ما ورد في المادة (229) عقوبات، ومن خلال عرض النصوص أعلاه نجد ان المشرع قد تعمد التفريق بين إهانة الهيئات النظامية والعاملين فيها، كما انه شدد العقوبة على فعل إهانة بعض العاملين في تلك الوظائف وهذه الفئات.
الا ان التطبيق القضائي لم يميز بين إهانة الموظف واهانة المؤسسة، حيث ربط أي نقد موجه لشخص الموظف في المؤسسة سواء كان على رأسها او عضوا فيها، بانه اعتداء على المؤسسة، وكأنما المؤسسة أصبحت ملكاً للموظف فيها، ومن ثم لا يجوز توجيه النقد الى رئيسها والموظف الفاعل فيها، وهذا قوض حرية التعبير عن الرأي الى اقصى حد، ما جعل من النقد نحو الأداء الوظيفي معدوماً في الاعلام او يكون بالمواربة، او باتخاذ أسماء وهمية. ويرى احد المختصين في علم الاجتماع ان هذا الأسلوب هو من اثار تقمص اساليب الطغاة والديكتاتورية الذين يسوقون الامة لإعلاء مجده الشخصي، ويريق الدماء لإحياء ذكراه هو لا ذكرى امته او المؤسسة التي يتولى ادارتها، وهذه هي شهوة الحكم التي ميزت الطغاة والفاسدين.
لذلك ان منح فرصة للمواطن او الإعلامي بالتعبير عن الرأي هو أسلم وسيلة لمنعه من الانجرار إلى اتباع وسائل غير سلمية، أو يتبع أسلوب المواربة والتواري خلف أسماء وهمية تمنع صاحب القرار من التمييز بينها وبين أصحاب الغرض السيء، والتقيد وتجريم النقد الموجه الى المؤسسة طال عدة اشخاص منهم من كان من قادة الرأي العام وكانت هذه الاحكام قد صدرت بناءً على شكوى من كبار المسؤولين في الدولة العراقية تجاه أشخاص وجهوا نقداً للأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، ولم يكن موجها لشخص من يتربع على عرش تلك المؤسسات. وهذه المادة من نتاج عقلية ديكتاتورية تنتهج سياسة تشريعية تأثراً ببعض القوانين العقابية في البلدان العربية وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون العقوبات واغلب تلك الأنظمة العربية هي شمولية ديكتاتورية بطبيعتها ولم تمارس اي ديمقراطية وكان الحاكم فيها غير قابل للعزل أو مستعداً لتداول السلطة سلميا، وإنما جميعهم تركوا السلطة إما بعد موتهم أو بانقلاب عسكري، ويرهن مصير البلد بشخوصهم، ويجعل من مقدراته وموارده ومؤسساته ملكاً صرفاً واي نقد يوجه إلى تلك المؤسسات هو اعتداء على شخصهم، وهذه هي العقلية التي أنتجت لنا المادة (226) من قانون العقوبات، لكن كنا نأمل خيراً في الفترة الزمنية التي تلت عام 2003 والفترة التي تلت دستور العراق لعام 2005 للمبادئ الديمقراطية التي وردت فيه، ومنها تجاه حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النقد البناء تجاه الأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، لكن استمر العمل بتطبيق تلك المادة وبوتيرة عالية في بعض الأوقات، وما ظهر للإعلام في الفترة الأخيرة من إسراف في تطبيقها بحيث جعل من النقد الموجه الى الشخصيات العامة بمثابة الجريمة، وتمت محاكمة أشخاص وإدانتهم بموجبها، بعضهم من عامة الناس والبعض الآخر من قادة الرأي العام، وكانت ردود فعل الجماهير غاضبة ومستغربة من تفعيل هذا النص الجائر في ظل وجود نص دستوري يضمن للمواطن حقه في التعبير عن وجهة نظره تجاه الأوضاع السائد التي يعاني منها. ومن حقه ان يوجه النقد إلى شخص المسؤول لأنه هو من يملك سلطة القرار، ولا بد من ان يتحمل هذا المسؤول مسؤولية تردي الأوضاع التي يعاني منها المواطن المحتج، وعلى وفق المادة (38) من الدستور.
وحتى عندما سعى المختصون لإصدار قانون جديد للعقوبات فان السياسة الجنائية التي انتهجها القائمون عليها تميل نحو التضييق والتشديد تجاه أي نقد بناء. وما ورد في المواد العقابية سواء التي كانت في قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل او مشروع قانون العقوبات الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية في حينه، فإنها جميعا تمثل سياسة أنظمة شمولية وعقليات ديكتاتورية تشخصن الوظيفة، وتسعى إلى شخصنة القانون وهذا امتداد للعقل المهيمن على مقاليد الأمور في البلاد، وكنا نأمل ان يكون خطوة إلى الإمام وليس العكس. والملاحظ ان هذه الأفعال التي جرمتها تلك المواد لم تكن بمثل هذه القسوة أيام الملكية في العراق، لان قانون العقوبات البغدادي الصادر عام 1918 وفي المادة (122) قد فرض عقوبة لا تزيد على الحبس ستة اشهر او بغرامة، وعلى وفق النص الآتي (من أهان بالإشارة او القول او الفعل موظفا عموميا او احد رجال الضبط او أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بالغرامة او بهما فاذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية او إدارية او مجلس او على احد أعضائهما وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة او الغرامة او كليهما). وحتى في حالة الاعتداء على المحاكم فقصر التجريم على الاعتداء الذي يقع أثناء انعقادها فقط، بينما التشريع النافذ والمشروع المقترح ترك الأمر حتى لو وجهت الإهانة إلى شخص رئيسها بوصفه الإداري وليس القضائي.
ـــــــــــــ
* قاضٍ متقاعد
**********************************************
اليسار العراقي.. ومتلازمة الشحة في الكتابات القانونية
هادي عزيز علي
شحّة مشهودة في المنتج الفكري لليسار العراقي في الحقول القانونية، وهي شحّة يرافقها طعم التقصير، توجّه خصوصا إلى العائلة الأكاديمية القانونية ذات التوجّه اليساري. فخلال قرن ونيف، لا نعثر إلا على محطتين بارزتين تكادان تكونان الاستثناء في هذا الميدان. الأولى تمثّلت في الراحل حسين الرحّال (1900–1971)، صاحب الوعي القانوني الماركسي المبكر، والذي دشّن في عام 1924 أول حلقة ماركسية عراقية وأصدر صحيفة تعدّ بمثابة أول إعلان قانوني ثقافي للفكر الماركسي في البلاد. ومع رحيله، خبت بواكير الخصب القانوني الماركسي، لتغيب عن المشهد لعقود.
ثم جاءت المحطة الثانية مع الراحل الدكتور صفاء الحافظ في سبعينات القرن الماضي، والذي قدّم مصنّفه المهم "نظرية القانون الاشتراكي". وكتب مساهمات نوعية في إصلاح النظام القضائي نُشرت في مجلة "القضاء" الصادرة عن نقابة المحامين عام 1972، وكان عضوا فاعلا في اللجنة التي شكّلتها وزارة العدل لإصلاح النظام القانوني آنذاك. لكن برحيله المأساوي، عاد الجدب، ولم يأت بعده من يواصل المسار حتى يومنا هذا.
لا عذر للتراخي. فالفكر الماركسي خلّف تراثا قانونيا ثرياً، تعامل فيه مع القانون باعتباره انعكاساً للبنية التحتية لعلاقات الإنتاج. وقد تناولت الأجيال اللاحقة هذه الفرضية بالدراسة والتحليل، فأنجبت مدارس فكرية متعاقبة أثّرت في الفكر القانوني العالمي، ولا تزال تعدّ مصدر إلهام للباحثين ومنظّري القانون، خصوصاً في ظل التحولات الاجتماعية المستمرة.
واللافت أن هذا الفكر، رغم عدائه المعلن للرأسمالية، لم يبق حكراً على اليسار، إذ استنجدت به حتى بعض الدول الرأسمالية في لحظات أزماتها الكبرى، لما يحمله من أدوات تحليلية نافذة وقابلة للتطبيق النقدي.
هنا، نحن بأمسّ الحاجة إلى إعادة النظر في حالة التراخي التي تطبع الحقل القانوني اليساري في العراق، خاصة وأن الفكر الماركسي قد خلّف إرثاً نظرياً عميقاً، وترك لنا قامات فكرية يشار إليها بالبنان، شكّلت علامات بارزة في إعادة تعريف القانون ضمن بنية الهيمنة والصراع الطبقي. نمرّ على بعض منها، على سبيل المثال لا الحصر:
- يوجين بازوكانيس (Evgeny Pashukanis) (1891–1937)
المنظّر القانوني البارز في سياق الثورة البلشفية، تولّى عدة مناصب بعد ثورة أكتوبر 1917، منها منصب "قاضي الشعب" عام 1918. قدّم بازوكانيس قراءة مغايرة تماما للقانون، حيث صاغ "براديغما" قانونياً ماركسياً من خلال دراسته الأصيلة لفلسفة القانون، ما جعله موضع تبجيل لدى فلاسفة القانون الغربيين حتى اليوم. يعد كتابه الشهير "النظرية العامة في القانون والماركسية" (1924) منجزه الأهم، حيث يقول فيه (الإنسان في المجتمع هو الفرضية التي تنطلق منها النظرية الاقتصادية، ويجب على النظرية العامة في القانون أن تنطلق أيضا من الفرضيات الأساسية ذاتها).
- أنطونيو غرامشي (Antonio Gramsci)
في رسالة كتبها من سجنه بتاريخ 3 تشرين الأول 1927 إلى والدته، يقول (تخليت عن قراءة الصحف لن أتمكن من قضاء بعض الوقت رفقة معتقلين آخرين غير مسموح لي أن أزور معتقلين سياسيين يتعلق الأمر إذن بسجناء الحق العام). تلك الرسالة تعكس موقفه النظري القانون في جوهره أداة قمعية (الشرطة، الجيش، المحاكم) وأداة للهيمنة، إذ يسهم في الامتثال الطوعي عبر ما يسميه الوظيفة التربوية، ويضيف أن القانون ليس مجرد آلية ضبط، بل هو أيضا "كتلة تاريخية" تسهم في تحقيق النفوذ السياسي والاستقرار الاجتماعي.
يؤكد غرامشي أن التغيير لا يتحقق بالقوة فقط، بل من خلال بناء نموذج ثقافي بديل لدى الجماهير أدواته الأساسية هي الثقافة والوعي.
- لويس ألتوسير (Louis Althusser) (1918–1990)
من أبرز منظّري العلاقة بين الدولة والقانون في مقاله المهم "الأيديولوجيا وأجهزة الدولة الأيديولوجية" (1970)، يدرج القانون ضمن أجهزة الدولة القمعية مثل الشرطة والمحاكم، لكنه يرى أيضا أن للقانون وظيفة أيديولوجية الحفاظ على النظام الرأسمالي، من خلال إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة.
وفق ألتوسير، القانون ليس محايداً، بل أداة لإعادة إنتاج البنية الفوقية، التي تخدم وتشرعن مصالح الطبقة الحاكمة، ويخضع بالتالي لأيديولوجيا الدولة.
- بيير بورديو (Pierre Bourdieu) (1930–2002)
عالم الاجتماع الفرنسي الذي قدّم رؤية نقدية عميقة لدور القانون، يرى أن القانون لا يُنتج العدالة، بقدر ما يُنتج اللامساواة المقنعة بشرعية شكلية. يصف القانون بأنه خطاب يضفي الشرعية على التمايز الطبقي والجنسي والعرقي، ويعمل من خلال اللغة والسلطة الرمزية لإعادة إنتاج الهيمنة، لا بالقسر المباشر، بل عبر القبول والامتثال الطوعي، أي بالشرعية الرمزية.
بذلك يختلف بورديو عن ألتوسير إذ يرى القانون ليس مجرد أداة أيديولوجية قمعية، بل حقل رمزي للهيمنة يعمل على تثبيت النظام الاجتماعي القائم تحت غطاء "الموضوعية" و"الحياد".
أزمة الفكر القانوني اليساري لا تكمن في غياب المنطلقات النظرية أو ندرة الأدبيات المرجعية، بل في القطيعة المزدوجة التي يعيشها، قطيعة مع الإرث الماركسي الغني في فهم القانون كأداة صراع طبقي وهيمنة رمزية، وقطيعة مع الواقع الاجتماعي القانوني المحلي الذي تتعمّق فيه مظاهر الظلم واللامساواة والعدالة الشكلية.
لقد استسلم هذا الحقل على قلّته إما للنقل الأكاديمي الجاف، أو للخطاب الحقوقي المجتزأ الذي يفرّغ القانون من محتواه البنيوي والسياسي، ويحوّله إلى تقنية إجرائية أو مطلب إصلاحي معزول عن التناقضات الطبقية وموازين القوى الفعلية.
إن غياب الاجتهاد النظري، وانكفاء اليسار عن خوض معركة إعادة تعريف القانون بوصفه ميداناً للصراع الاجتماعي، جعلا من الفكر القانوني اليساري طرفاً غائباً في لحظة تاريخية تتكثف فيها أدوات السيطرة القانونية، وتتعمّق فيها الحاجة إلى نقد جذري للنظام القضائي والتشريعي بوصفه جزءا من بنية السيطرة لا أداة حياد من هنا، فإن إحياء هذا الحقل ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة نضالية لاستعادة أحد ميادين الصراع التي هجرتها القوى التقدّمية لعقود.
هذا غيض من فيض الثروة الفكرية التي يمكن الاشتغال عليها، والتي ينبغي أن تدرج ضمن متبنيات اليسار العراقي، الملزم اليوم أكثر من أي وقت مضى بمغادرة حالة التراخي المزمنة التي طال أمدها في هذا الحقل الحيوي.
************************************************
الصفحة العاشرة
الناصرية 1969 قصة منع أول مهرجان للشعر الشعبي
علي كرم الخليفة
في تموز 1969، اجتمع الشعراء الشعبيون في الناصرية، ليطلقوا أول مهرجان للشعر الشعبي. مهرجانٌ بدأ من المقاهي، وامتلأت به القاعات، وكانت قصائده أقرب إلى بيانات ثورية.
لماذا خافت السلطة من الشعر؟
صيف عام 1969، وبالتحديد في 7 تموز، شهدت مدينة الناصرية حدثاً غير مسبوق في تاريخ الشعر الشعبي العراقي، حيث عُقد مهرجان هو الأول من نوعه، جرى تنظيمه من دون دعم رسمي مباشر، وبمبادرة من مجموعة من الشعراء الشباب الحالمين بمنصة تعبّر عن لغتهم ولهجتهم وتجاربهم اليومية، على غرار منصات الشعر الفصيح. لم يكن ذلك المهرجان مجرد فعالية ثقافية، بل كان - كما يروي منظموه وشهود عيان- لحظة فارقة في التعبير الشعبي، جمعت بين الحماسة الشعرية، والحس السياسي المتصاعد في عراق ما بعد هزيمة حزيران 67، عندما كانت القصيدة تُكتب وتُنشر في الصحف بدلاً من أن تُلقى من على المنصات وجهاً لوجه مع الناس، كما لو أنها بيان احتجاج. اليوم، بعد أكثر من خمسة عقود، نستعيد تلك التجربة الأولى: كيف بدأت؟ من شارك فيها؟ ولماذا انتهت تلك السلسلة من المهرجانات فجأة بعد خمس سنوات فقط من إنطلاقتها؟
الفكرة من المقاهي إلى مكتب المحافظ
أواخر ستينييات القرن الماضي، كان الشعر الشعبي بشكله المتجدد - بعد قصيدة للريل وحمد للشاعر مظفر النواب - قد بدأ يجد طريقه إلى المقاهي والنوادي العامة. وفي مقاهي الناصرية، كان هناك ثلاثة من الشعراء الشباب، كاظم الركابي وعادل العضاض وجبار الغزي- يتحاورون بشكل متكرر حول الحاجة إلى مساحة علنية تُكرّس للشعر الشعبي، تماماً كما تُقام مهرجانات للشعر الفصيح. في إحدى تلك الجلسات، اقترح كاظم الركابي تنظيم مهرجان للشعرالشعبي في الناصرية، ووجّه رفاقه إلى صديق له يُدعى جاسم الركابي، كان يشغل منصب مدير بلدية المدينة، ويتمتع بنفوذ حزبي وإداري. لم يتردد المدير في دعم الفكرة، لكنه سأل عن “شعار المهرجان”، ليأتيه الرد من جبار الغزي: “كل شيء من أجل المعركة”، في إشارة إلى الهزيمة العربية في حرب حزيران، ومشاركة الجيش العراقي فيها. كان الشعار سياسياً ووطنياً، وهو ما جعل المدير يتحمس أكثر للمشروع، ويعدهم بعرض الفكرة على محافظ ذي قار. جاءت الموافقة بسرعة، إذ كان المحافظ صديقاً لوالد عادل العضاض، ووافق على الفور على دعم المهرجان بمبلغ خمسين ديناراً، وهو مبلغ كبير آنذاك، فيما ساهم مدير تربية ذي قار بمبلغ مماثل. وإلى جانب هذا الدعم، كانت البطاقات التي بيعت للجمهور مصدراً تمويلياً أساسياً أتاح للمهرجان أن يرى النور، بحسب ما يروي عادل العضاض، أحّد منظمي المهرجان. بعد التأمين المالي، بدأ تقاسم الأدوار: كاظم الركابي، الذي كان يعمل في الإذاعة ببغداد، تولى مهمة دعوة شعراء العاصمة، فيما توجّه جبار الغزي بنفسه لدعوة شعراء البصرة والعمارة، أما العضاض فتولى إدارة التفاصيل الإدارية والفنية. كما جرى الاتفاق على أن يتولى الشاعر الأستاذ عبد الواحد الهلالي استقبال الشعراء الوافدين.
الشعراء يصلون إلى الناصرية
جرى اختيار “نادي الموظفين” وسط مدينة الناصرية لإقامة المهرجان، فيما حُجز لإيواء الضيوف وللقراءات واللقاءات فندق “بغداد” في شارع الجمهورية قرب المقهى الذي يتردد عليه الشعراء والفنانون. وهكذا وبميزانية بسيطة، وبشغف عالٍ، تحوّلت الناصرية عاصمة ذي قار إلى محطة أدبية مزدحمة.
إضافة إلى الأمسيات الشعرية المسائية، أطلق المهرجان في الصباح رحلات ميدانية للمشاركين إلى أماكن قريبة، أبرزها أهوار الجبايش، و مدينة أور الأثرية. كان هناك حرص على إظهار الوجه الثقافي والتاريخي للجنوب، إلى جانب النص الشعري، ما أضفى على المهرجان طابعاً شبه احتفالي، واسعاً ومنفتحاً.
جاء المشاركون من أغلب محافظات العراق، واختيروا بعناية من مختلف الاتجاهات والتيارات، وإن كان صوت “اليسار” حاضراً بقوة. ومن بين الأسماء التي حضرت المهرجان، ابو ضاري، شاكر السماوي، عزيز السماوي، طارق ياسين، علي الشباني، كاظم الرويعي، كاظم الركابي، وآخرون من البصرة والديوانية وبغداد، شكلوا معاً نواة جيل شعري كان يبحث عن صوته وسط زمن متقلب. استمرت فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أيام، وشهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً، كما يتذكر خضر خميس، الشاعر الفصيح، “كنت في مركز مدينة الناصرية، وسمعت بالمصادفة عن مهرجان للشعر الشعبي، سيقام في نادي موظفي الناصرية، فأسرعت بالذهاب إليه. ولما وصلت وجدت المهرجان غاصاً بالناس، والحضور كان غفيراً، فجلست واستمتعت كثيراً بالشعر الذي سمعته، على الرغم من أنني لم أكن أعرف أحداً من الشعراء وقتها”.
أجواء المهرجان والقصائد: اليسار يتقدّم المنصة
تحوّل مهرجان الناصرية عام 1969 من تجمع شعري إلى حدث جماهيري. جمهور واسع غصّت به قاعة نادي الموظفين، حيث شهدت المدينة احتفاءً نادراً بالشعر الشعبي بوصفه خطاباً فنياً وسياسياً في آنٍ معاً. ما ميز ذلك المهرجان - بحسب شهادات المشاركين - لم يكن فقط الحضور الجماهيري، بل النبرة العالية للقصائد، التي كانت تحمل قضايا وطنية وإنسانية، بلغة مشحونة ورمزية. يقول عادل العضاض، الشاعر الذي كان أحد منظمي المهرجان، إن جميع القصائد “كانت يسارية”، وإن “اللغة الرمزية” التي استخدمها الشعراء آنذاك، كانت غامضة على العامة، وكذلك على كثير من القيادات الحزبية، وهو ما سمح بتمرير رسائل احتجاج وتحدٍّ من تحت الطاولة. واقع الحال، لم يكن هذا غريباً في مرحلة كان فيها اليسار العراقي لا يزال فاعلاً ثقافياً، ولم تكن أجهزة السلطة قد أحكمت قبضتها بعد على كل المنابر. من القصائد اللافتة التي قُرئت في ذلك المهرجان، وفق ذاكرة العضاض، هي قصيدة “مناجل” للشاعر كاظم الركابي، وهي قصيدة شديدة الرمزية، تمجّد الفلاح والثورة والتحدي، وتُقرأ باعتبارها نشيداً يسارياً مقنّعاً.
“لولي على مسعدك … اِبصوت الذي اِيريَحه/ وشّرع ارموشك هله…. للمعتني اِبجرحه/ ولولي لگطع النفس…. لولي لمن يصحه/ الليل موش اِيحصد ليله … ايحصد صبحه/ والحصو موش ايحصد روحه… ايحصد جدحه/ اجرحني يمن عتبه لك… جرح المحب فرحه / ولولي اعله روج البحر…. تالي البحر ملحه”.
الشاعر علي الشباني بعد خروجه من سجن الحلة عام 1968، شارك في مهرجان الشعر الشعبي الأول في الناصرية بقصيدة “خسارة”، التي تعتبر قصيدة متفردة في العامية العراقية. كانت مشاركته علامة فارقة، إذ نقل إلى المنصة تجربة الاعتقال والمقاومة، بصوت متماسك، وقصيدة تستنهض الحزن والتمرّد معاً.
” موطفح شوك الضوه/ ومامش نده اليفرع شجرها/ مو نشف سباحها، وساكت نهرها/ كلنه جذابه بلياليها… بصبحها … وبكمرها / يموت شاعر، يشعل السلطان شمعه/ يموت جاهل، تعتلك بالكوخ دمعه".
ألقيت هذه القصائد بأسلوب أدائي مؤثر، أمام جمهور متحمّس، وفي لحظة مشحونة بالسياسة والتمرد والخذلان. ويبدو أن هذا التوتر العام انعكس على أجواء المهرجان، وجعل منه فعلاً أقرب إلى مظاهرة شعرية، ما أثار قلق بعض الجهات الرسمية لاحقاً، رغم أن المهرجان نُظم بموافقة ودعم من شخصيات حكومية محلية.
قصص جانبية: “يا نجمة” و“قصيدة لا تحتمل التصفيق“
من اللحظات التي احتفظ بها التاريخ الثقافي العراقي، تلك التي جمعت بين ثلاثة أسماء في مهرجان الناصرية: الشاعر كاظم الركابي، والفنان الشاب حسين نعمة، والملحن كوكب حمزة. خلال فعاليات المهرجان، قدّم الركابي قصيدته “يا نجمة” إلى كوكب، الذي لحنها بأسلوب عاطفي جديد، ثم غناها حسين نعمة بصوته الدافئ، لتصبح فيما بعد واحدة من أشهر الأغاني العراقية، وجواز مرور نعمة إلى ذاكرة الناس.
لم تكن “يا نجمة” مجرد تعاون فني، بل كانت تمثيلاً لمزاج ثقافي جديد بدأ يتكوّن آنذاك، وهو مزاج يربط الشعر الشعبي بالغناء الملتزم، ويحوّل القصائد إلى أناشيد وجدانية متمردة، تماماً كما فعل مظفر النواب في الضفة الأخرى من الشعر الشعبي السياسي.
ورغم أن الشاعر ذياب كزار (أبو سرحان) لم يشارك في مهرجان الناصرية الأول، إلا أن حضوره في المهرجانات التالية كان لافتاً. ففي مهرجان البصرة 1970، قرأ قصيدته “صلاة الدم”، وفي مهرجان العمارة عام 1971، قدّم واحدة من أشهر قصائده: “يحاديني”، وسبقها بعبارة شهيرة باتت تُردَّد كثيراً: “يحاديني.. قصيدة لا تحتمل التصفيق”. “وسكتنه … وسولفت روحي/ العذاب يهون، وانته تهون/ واخبرنك يحاديني.. هاي وجوه ماتحزن/ هاي وجوه ماشكَت سججها دموع/ واحنه شطوط بينه الماي مدوهن لچن سكتاوي تطفيني/ وأظل أطفه! … وأشب وطفه! … ويشب بيه الحريج النوب يطفيني… وأظل أطفه/ وأكَلك اي يحاديني: حلاة الموت لو مات الرجل وكَفه”. كان أبو سرحان من شعراء الأغنية أيضاً، كتب أغنيات شهيرة مثل “خيو بنت الديرة” و”شوك الحمام” و”الگنطرة بعيدة “، لكنه في المهرجانات الشعرية كان يتجرد من عذوبة الكلمات وسحرها، ويقدم نصاً غاضباً، حاداً، مترعاً بالحزن والشجن.
لماذا مُنع الشعر الشعبي من المهرجانات؟
استمرت مهرجانات الشعر الشعبي بعد انطلاقتها الأولى في الناصرية عام 1969، متنقلة بين مدن الجنوب، البصرة (1970)، العمارة (1971)، الديوانية والسماوة (1972)، ثم العودة إلى الناصرية عام (1973). لكن هذه السلسلة لم تُكتب لها الاستمرارية. فعند السنة الخامسة، توقفت المهرجانات فجأة، وصدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة عام 1975 تقضي بمنع الأدب الشعبي من الإذاعة والمسرح والنشر، بدعوى “حماية اللغة العربية الفصحى” من “المفردات الدخيلة”، على حد تعبير السلطات آنذاك.
ورغم أن الذريعة الرسمية كانت لغوية، إلا أن الشهادات المتواترة تشير إلى أن السبب الحقيقي كان سياسياً بالدرجة الأولى. فبحسب روايات المشاركين والمنظمين، كان مهرجان عام 1973 - وهو الأخير في السلسلة - قد شهد تنافساً محموماً على المنصة بين شعراء اليسار وممثلي التيار البعثي الذي كان يستأثر بالسلطة، وكانت القصائد اليسارية أكثر تأثيراً، وأكثر تصفيقاً، وأكثر جرأة. هذا الاختلال في توازن الخطاب على المنصة الشعرية، أثار حفيظة سلطة البعث الصاعدة حينها، والتي بدأت بترسيخ خطابها العقائدي الموحد، ولم تكن مستعدة لترك المساحات الثقافية مفتوحة أمام تعبيرات (غير منضبطة). وقد أُرفق المنع الثقافي بتضييق أوسع على الشعراء الشعبيين، ومنع طباعة دواوينهم، وملاحقة بعضهم سياسياً. في صيف 1973، كان كاظم غيلان، الشاعر والصحفي المعروف، واحداً من الأصوات الفاعلة في النسخة الخامسة من مهرجان الشعر الشعبي، إلى جانب شعراء مثل رياض النعماني، كاظم إسماعيل الكاطع، رحيم الغالبي، ومجيد الخيون. يتذكر غيلان تلك اللحظة بوصفها نهاية مرحلة وبداية أخرى، حين بدأت السلطة تنظر بعين الشك والقلق إلى الشعر الشعبي الذي ازدهر خارج مظلتها.
يقول غيلان، إن النظام، بعد أن أدرك الشعبية المتصاعدة لشعراء العامية من غير الموالين، وبعد التحالف المعلن بين البعثيين والشيوعيين وما رافقه من عودة إعلام الحزب الشيوعي إلى العلن، بدأ بمراجعة تأثير الشعر الشعبي على الشارع.
كان الإفلاس الثقافي الذي تمرّ به السلطة واضحاً، بحسب غيلان، ولذلك سارعت إلى تمرير “قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية”، ليس حباً بالعربية، بل بحثاً عن غطاء قانوني لحظر الشعر الشعبي.
لكن المفارقة أن السلطة نفسها، بعد سنوات فقط، وفي خضم الحرب مع إيران، عادت لتستدعي هذا الشعر من جديد، ولكن هذه المرة بوصفه أداة تعبئة وتحريض. راحت تدعم الأصوات الرخيصة التي تقبلت هذا الدور، وشيئاً فشيئاً تحوّل هذا الفن، الذي عرف بجماليته وببعده الإنساني، إلى وسيلة دعاية وعدوان، وتحوّلت مهرجاناته إلى منصات للارتزاق والتكسب، لا أكثر، وفق كاظم غيلان. هكذا انتهت واحدة من أنضج لحظات التعبير الشعبي الحر، بعدما بدأت من مقهى، وبلغت المنصة، ثم اختنقت تحت قبضة الخوف السياسي. وكما هو الحال في كثير من لحظات الثقافة العراقية، لم يكن المنع قراراً لغوياً، بل كان إسكاتاً للفنون حين تُصبح خطرة.
***********************************************
{الزعيم}
يوسف المحمداوي
منو مثلك
يالمطلگ المناصب لجل حب الناس
زعيم وخادم الاهلك …
يمزغر الصور ومكبر الصمون ….
ما ينسى الضمير العدل ضي عدلك…
ياضحكة الفقره ودمعة الطاغوت…
صعبه تموت يالتاريخنه يجلّك ….
منو بحلّك….
يا قصر الصريفه وبالسمه نجمات نرسملك….
وزنّه القيادة من زمن هارون
يا قائد وصل ظلك…
وجرّبنه النزاهة بحقبة الماضين
شو محد گدر ياصافي يوصلك…
رادوا يوصلون المئذنة طاريك…
وصلوا بعض بعضك مادروا كلك…
منو مثلك…
شجاعة وتشهد الجبهات
بغزه شگد الك صولات تضحكلك…
شهيد بلا قبر لا مال
بس شعبك شچم تمثال
حي بگلبه ناصبلك….
يلماتمل حب الناس حب الناس ماملك..
الزعامه بس عليك تلوگ
وسفرطاس الشريف انذار لهل البوگ
وكل هم الغدر عزلك…
عفا الله شو گلتها أزماط…. وتدري محد يگلك…
وعفيته بكل رحابة صدر يالتدريه باچر يامر بقتلك…
لا ثروة لصوص ابليس
طاهر رافض التدنيس
روحك أرض يا عريس
والفضل اليعيشه الشعب من فضلك…
يا عرس الفلح يا نكبة الإقطاع…
يا ضحكة بساطة بوجه المزعلك…
يادمعة فگد ظلت بعين الروح…
ماترضه المروه ارواحنه تهلك…
لان ما مش بعد مثلك…
****************************************************
الصفحة الحادية عشر
أحدث ترجمات د. علي عبد الامير صالح
يواصل الكاتب والمترجم التقدمي البارز د. علي عبد الامير صالح؛ اصدار عدد من الكتب المعرفية والابداعية.
وقد اصدر مؤخراً عن دار اهوار- بغداد كتاب "ادباء نوبل يتكلمون" ترجم فيه حوارات مع عشرة من الفائزين بجائزة نوبل بدءاً من 1982- 2000.
فيما جاء الكتاب الثاني بعنوان "عيون العدو" وفيه ترجم (15) قصة قصيرة لعدد من كتاب العالم، بينهم: (ايتالو كالفينو، دينو بوتزاتي، اورهان باموق، إليف شفق، لورنس، جيمس بالدوين وغيرهم".
وكان د. علي عبد الامير صالح، قد نال جائزة وزارة الثقافة عام 2000 عن ترجمته رواية غونتر غراس "طبل الصفيح"، وجائزة الابداع العراقي من وزارة الثقافة ايضاً عن ترجمته رواية جويديب روي (باتا جاريا/ وادي مراكش) عام 2017.
كما ترجم عدداً من الروايات العالمية المهمة، وأصدر من تأليفه عدة مجاميع قصصية ورائية منها: (الهولندي الطائر، يمامة، الرسام، خميلة الاجنة، ارابيسك، العوالم الثلاثة) وقد سبق له وان نشر كتاباته وترجماته في "طريق الشعب" و "الثقافة الجديدة".
************************************
ذاكرة الصحافة الشيوعية الصحافة الشيوعية والحركة العمالية
عادل الياسري
لاشكّ أن الكتاب والمؤرخين أشبعوا صحافة الأحزاب الوطنية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية درساً وتمحيصاً ، لكنني مع علمي بهذا آثرت أن أتناول صحافة الحزب الشيوعي العراقي ومواقفها من النضالات المطلبية للعمال. ففي أواخر العشرينيات توسعت المؤسسات الصناعية نتيجة إضافة مؤسسات جديدة، تتطلع لبناء وتشكيل نقابات مهنية تتبنى النضالات المطلبية للعمال ،وترعى حقوقهم المشروعة ،فتباينت مواقف الأحزاب الموجودة آنذاك من هذا الأمر ،من متحفظٍ الى معارض له ،لكن الحزب الشيوعي العراقي كان موقفه واضحاً ومتجلّياً ،حيث بادر الى دعم ورعاية الصحافة العمالية التي كانت في دور الظهور والتي منها ( مجلة العامل ، مجلة الصنائع، ومجلة نداء العامل )، ودعت جريدة "الشرارة" العمال الى تنظيم صفوفهم في نقابات تدافع عن حقوقهم ، كما انعكست على صفحاتها نضالات العمال ونشاطاتهم، وصارت تنشر أنباء الاضرابات العمالية كأضراب عمال الأحذية وعمال معامل الدقيق ،وعمال المياه الغازية وعمال البرادة في معسكر الرشيد.
ونهجت جريدة القاعدة نهج جريدة الشرارة فدافعت عن حقوق العمال ،ووجهت نضالاتهم ورسمت لهم الطريق الذي يجب أن يسلكوه للحصول على حق التنظيم النقابي، والضغط على الحكومة في جميع المناسبات للاعتراف بهذا الحق . ووفقاً لما جاء في رسالة الماجستير الموسومة( الصحافة العراقية والحركة الوطنية ) التي تقدم بها الباحث الدكتور" قيس الياسري " الى كلية الأعلام في جامعة القاهرة والتي نال بها درجة الماجستير من الكلية المذكورة ،"ووقفت جريدة "القاعدة" الى جانب عمال السكك والميناء الذين تقدموا بطلب لتكوين نقاباتهم أوائل عام 1944.
وعندما أضرب عمال القاعدة الحربية في البصرة ( الشعيبة ) في 21\4\1955 كتبت جريدة "القاعدة" بعددها لشهر أيلول 1955 بأن ضابط المنطقة الفرعية لعمال السكك الحديدية في المعقل قام بطرد ما يقرب الثلاثين عاملاً دون أن يكون هناك أي سبب مع العلم أن هؤلاء العمال يعيلون كل واحد منهم عائلة قد قضوا زمناً طويلاً في العمل في هذه الدائرة .غير أن سبب الطرد غير خافٍ على العمال . ثم واصلت دعمها لقضية العمال وسائر فئات الشعب الأخرى بعد قيام الجمهورية من خلال ما كانت تنشره من مقالات إفتتاحية وكتابات تخص نضالات العمال المطلبية ، ومن أعمدة صحفية تصبّ في الموضوع ذاته ، فمن خلال ما دأبت عليه صحافة الحزب بعد الثورة ممثلة في "إتحاد الشعب" وصحف الحزب الأخرى التي كانت تصدر في فترات النضالات السرية ووصولاً لجريدة طريق الشعب التي تحتلّ فيها حياة العمال ومطاليبهم مساحة واسعة تتعدى الصفحة الكاملة أحياناً لتصل الى حدّ الصفحتين .
أنّ الجهد الكبير الذي كرّسه الحزب الشيوعي وصحفه الناطقة بلسانه لقضية العمال ومطالبهم وحقوقهم المشروعة كان ولايزال كبيراً وفاعلاً في نضالهم وتوحيد صفوفهم من أجل الفوز بتحقيق هذه المطالب والحقوق. كما أنّ صحافة الحزب دأبت التركيز على ضرورة رفع الوعي السياسي للعمال بوصفه السلاح الفعّال الذي يمكنهم من تحقيق طموحاتهم وحقوقهم الشرعية .
وكالعادة فانّ كل المواظبين على تتبع مواقف الحزب من نضالات الطبقة العاملة وسائر الشغيلة يلمسون دعمه عن طريق الاحتفال بالأول من أيار في كل عام باعتباره عيداً عالمياً لها، وما تنشره صحافتنا في أيّام هذا العيد من الدراسات والقصائد والمقالات الممجّدة للعمال وعيدهم إلاّ مؤشراً واضحاً على دعم الحزب ومؤازرته لنضالات هذه الطبقة المجيدة.
**********************************************
الموسيقى وتحولات الصوت والمعنى
حسين علي الوائلي
الموسيقى ليست مجرد فن للّهو أو التسلية، بل منتج ثقافي مركب، يحمل في نسيجه الصوتي سرديات المجتمع، وتمثيلات الهوية، وأصداء التحولات السياسية والاجتماعية.
إنها وسيلة سرد موازية، تتجاوز الكلمات أحيانًا لتكون تعبيرًا عن المكبوت، وعن الأمل، والتمرد، والانتماء. وقد شكّلت التجربة الموسيقية في العراق منذ سبعينات القرن العشرين نموذجًا غنيًا لفهم هذا التفاعل الجدلي بين الموسيقى والهوية.
وفي سبعينات القرن الماضي، عاش العراق ذروة تألق المدرسة المقامية، حين كانت أصوات مثل يوسف عمر وسليمة مراد تجسّد هوية فنية ذات طابع كلاسيكي رصين. الأغنية آنذاك كانت مطوّلة، ذات أبعاد تطريبية عالية، وكلماتها مشبعة بالوجد واللغة الشعرية وكانت تعبيرًا عن انتماء قومي جمعي، وعن مركزية بغداد الثقافية. لكن مع الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، بدأ الفن يُوظّف كأداة تعبئة، وبرزت الأغاني الوطنية والمجيدة للبطولة, ومع ذلك ظلّ التيار الشعبي يعبر عن الحنين والانكسار. وفي الحرب العراقية الإيرانية (1980–1988) لم تكن مجرد صراع عسكري طويل، بل شكّلت مرحلة مفصلية في تشكيل الوعي الجماعي، وفرضت على الدولة والمجتمع أطرًا جديدة للتعبير، كانت أكثرها مركزية هي الفن والموسيقى. وفي ظل النظام السابق , وجدت الأغنية كوسيلة تعبئة وتحشيد شعبي، فانتشرت الأغاني الحماسية التي تمجّد الحرب و البطولة، وقد ساهمت في صناعة صورة رمزية للمقاتل وقد أُنتجت هذه الأغاني باشراف المؤسسة الرسمية، وغالبًا ما كانت تُكتب من قبل شعراء محسوبين على السلطة، وتُلحّن وتُغنّى بأسلوب يُشبه “البلاغة الخطابية”,و أُفرغت الأغنية من بعدها الشخصي لصالح المعنى الجمعي المرتبط بالمعركة، فأصبحت آلة دعائية بامتياز.
وعلى الرغم من هيمنة هذا الخطاب الرسمي، لم تتوقف مشاعر الحنين و الفقد والانكسار عن الظهور، وإن بشكل غير مباشر أو عبر قنوات غير رسمية. كانت هناك أغانٍ تُعبّر عن الغياب و الفقدان و الحب المفجوع، والتي يمكن فهمها كمقاومة صامتة أو “احتجاج عاطفي” على الحرب. ولم يكن الفن خاضعًا كليًا للدولة، بل ظهرت فيه تعبيرات خافتة من الحنين لحياة مدنية مفقودة، وعن الحب في زمن الحرب، وهو ما شكّل أرضية لظهور أصوات جديدة. في منتصف الثمانينات، بدأ كاظم الساهر رحلته الفنية في مناخ يتأرجح بين الرسمي والوجداني و جمع في أعماله الأولى بين القصيدة الرومانسية، ذات النزعة العربية الكلاسيكية، وبين اللحن العاطفي القريب من الذوق الشعبي التي تُظهر حسًا شعريًا مرهفًا، لكنه محاط بلحن شعبي قريب من نبض الناس. وكان بذلك يعبّر عن “حنين شخصي” في زمن الهيمنة العسكرية، مما جعله يحظى بقبول واسع بين الجمهور الباحث عن خطاب بديل، أكثر إنسانية، وأقل شعاراتية. هذا "الحنين" يُبرز كيف أن الحرب، على الرغم من محاولتها قولبة الفن، لم تنجح تمامًا في احتواء كل التعبيرات. بل إن الفنانين مثل كاظم الساهر , وجدوا مساحات داخل الهامش ليعبّروا عن مشاعر تتقاطع مع تجارب الناس اليومية، من دون الاصطدام المباشر مع السلطة، وهذه المساحات تجعل من الموسيقى في زمن الحرب ؛ مرآة دقيقة للذات الجمعية. وكان فرض الحصار الدولي بعد 1991 عزلة ثقافية واقتصادية على العراق، مما أضعف البنية المؤسسية للإنتاج الموسيقي و بدأت الأذواق تتجه نحو الأغنية الشعبية والبسيطة، وسادت موسيقى “الكاسيت المهرب”، حيث برزت أصوات تمزج الإيقاع الشعبي بالحزن المبطّن, كما ظهرت أنماط هجينة، غير خاضعة للرقابة، استثمرت في الشعر الشعبي والموضوعات اليومية من فقر وغربة. وبعد غزو الكويت عام 1990، فُرض على العراق حصار دولي خانق بدأ عام 1991 واستمر حتى الغزو الأميركي في 2003. هذا الحصار لم يكن فقط اقتصاديًا، بل ثقافيًا واجتماعيًا أيضًا، إذ انهارت مؤسسات الدولة الإنتاجية، بما فيها مؤسسات الإذاعة والتلفزيون، والمعاهد الموسيقية، وتأخر الإنتاج الفني الذي كان يمول رسميا . " ان انكسار المركز” يعني تعثر الحضور الثقافي المتمثل بالمؤسسة الرسمية كمصدر رئيس للإنتاج الموسيقي الموجه، وفقد سلطته وتماسكه، ولم يعد قادرًا على فرض ذوق عام أو إنتاج موحّد.
مع تراجع قدرة المؤسسة ، اتجه الناس إلى الأغاني البسيطة والمعبرة عن معاناتهم اليومية، فبرزت ما يعرف بـ “أغاني الكاسيت المهرب” وهي تسجيلات تُوزّع عبر السوق السوداء أو تُسجّل محليًا بإمكانيات بدائية، بعيدًا عن الرقابة الرسمية. هذه الأغاني غالبًا ما كانت قصيرة ومباشرة وتعتمد على إيقاعات شعبية مألوفة مثل (الجوبي) أو( البستة) وكلاهما يعبران عن الحرمان و الفقر و الغربة و الهجرة و الحب المستحيل. ولم تكن هذه الأغاني تبحث عن الجمال المجرد أو الشكل الفني، بل كانت تسعى إلى التعبير عن الوجدان المكبوت في ظل واقع اجتماعي قاسٍ.
في هذا السياق، ظهرت أنماط موسيقية “هجينة” لا تنتمي تمامًا إلى الذوق الرسمي ولا تنتمي بالكامل إلى الموروث الفولكلوري، بل هي خليط من الشعر الشعبي العراقي، خصوصًا شعر الحنين والمظلومية والإيقاعات الشرقية والبدوية، المفعمة بالشجن، مع الاستعانة بالتقنيات البسيطة في التسجيل والتوزيع، مثل “الأورغ” الإلكتروني. كانت هذه الأنماط تعد شكلًا من أشكال “مقاومة اليأس بالموسيقى”، أو حتى “تطبيع الحزن” فنيا. ان أصوات مثل حسين نعمة، رياض أحمد، وحاتم العراقي، قاسم السلطان في بداياتهم، وأصوات لاحقة مثل محمد عبد الجبار وآخرين، بدأت تكتسب شهرة، لأنهم لم يخاطبوا النخب، بل خاطبوا الشارع و الريف و الفقراء و الجنود المسرّحين والنساء الوحيدات و المهاجرين.. وهكذا لم تعد الأغنية تعبيرًا عن المؤسسة، بل عن الهامش الجماهيري. في التسعينات، تحررت الموسيقى العراقية من المركز السلطوي، ولكن بثمن: انهيار الجودة التقنية، و تصاعد الصدق التعبيري. وأصبحت الاغنية تُنتَج من قاع المجتمع، وتعكس بشكل صادق وجع العراقيين في الحصار والاغتراب والحرمان , و كان ذلك بداية تحول جذري في الذائقة .
ومع سقوط السلطة في عام 2003، دخلت البلاد مرحلة من الفوضى السياسية والانهيار الأمني , مما فتح المجال لحرية التعبير، وانطلقت اصوات غير مسبوقة في الأنماط الموسيقية، عكس تنوّع التجارب العراقية، مما أدى الى تشظي الهوية الوطنية.
ولم تعد هناك رقابة رسمية مركزية على الإنتاج الموسيقي , فظهرت مئات الأصوات المستقلة، وتعددت القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، وبدأت الأغنية تُنتج بعيدًا عن المؤسسة الرسمية.
هذا الانفتاح، وإن بدا ديمقراطيًا، أدّى إلى تشظي الذوق العام وغياب “البوصلة الثقافية”، حيث انتشرت أغانٍ تتراوح بين الحنين والوجد، وبين الغرائبية والابتذال
وفي ظل الحرب الأهلية (2006–2008)، واحتدام الصراعات الطائفية، بدأت تظهر أغانٍ تعكس الانتماءات الدينية والمناطقية، بل أحيانًا راحت تُستخدم للتحريض أو للتعبئة ضمن جماعات معينة , كما برزت أغانٍ تتبنى مفردات الموت والشهادة والثأر.. متأثرة بسياق مليء بالدمار والاقتتال.
هذه الأغاني لم تقتصر على التعبير، بل شاركت في إنتاج مزاج جماعي قائم على الحزن والغضب
وبرزت موسيقى إلكترونية هجينة تُنتج داخل الاستوديوهات المنزلية و تعتمد بشكل كبير على آلة “الأورغ” وتستخدم إيقاعات سريعة وكلمات مباشرة ومواضيع حياتية يومية كالحب و الفقر و الهجرة والعلاقات الاجتماعية.
هذا النوع على بساطته، أدى الى انتشار جماهيري واسع بين الشباب حيث وجدوا فيه ملاذًا من تعقيدات الواقع السياسي .
وبعد تظاهرات تشرين 2019، عادت الأغنية لتلعب دورًا سياسيًا واضحًا و ظهرت أغانٍ احتجاجية ورافضة للفساد والطائفية، أهمها أغنية "وطن" لرحمة رياض أحمد والتي حصدت ملايين المشاهدات على قنوات يوتيوب ، مستعيدة روحًا كانت قد خفتت.
هذه الأغاني، التي غالبًا ما تُنتج وتُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمثل امتدادًا لتقاليد قديمة في توظيف الموسيقى كأداة مقاومة، لكن بلغة شبابية عصرية .
اليوم، يعيش المشهد الموسيقي العراقي بين تيارات متنافرة: من الأغنية الفولكلورية التي تُعيد إنتاج التراث، إلى موسيقى الراب والتكنو المتمردة، ومن الأغنية التجارية السريعة إلى الأصوات التي تسعى لإحياء القصيدة.
مما يعكس حراكًا هوياتيًا معقّدًا، للاجيال المختلفة بهدف إعادة تعريف الانتماء و الذاكرة والمستقبل.
الموسيقى في العراق ليست مجرد فن، بل مرآة للتحولات السياسية والاجتماعية والوجدانية التي عاشها البلد. إنها صراع بين الرسمي والشعبي، بين الحنين والاحتجاج، بين المركز والهامش. وكما كان العراق دائمًا، فإن صوته الغنائي يبقى مشبعًا بالحزن والجمال، والبحث الدائم عن المعنى.
********************************************
في رواية "رأس القرية" ذاكرة المكان ورصد الواقع
د. سمير الخليل
انطلاقاً من سيميائية العنوان تحيلنا رواية (رأس القرية) للروائي (أحمد القيسي) إلى هيمنة هالة المكان ونوستالوجيا الماضي، من خلال وضع المتلقي إزاء المفارقة التي عبّر عنها الحدث الاستهلالي والمركزي المتمثل بمعاناة الشخصيّة المحورية في الرواية أو الشخصيّة الرئيسة (حافظ)، وشعوره السلبي والممض مع ذاكرته التي تحوّلت إلى بؤرة للإحساس بالوجع والهيمنة المرتبطة بالواقع الشخصيّ الفادح بالألم، مما جعل حالة الصراع السايكولوجي داخل الشخصيّة، وقد استحال إلى صراع حاد بين الذات والذاكرة، وبما يوحي بنوع من الأنسنة والانشطار الذاتي داخل الشخصيّة.
إنّ الفضاء الذي استهل به الروائي عالم الشخصيّة تأطّر باشتغال سايكولوجي محض حين يرصد الواقع بل أبعاده الاجتماعية والسايكولوجية والسياسية والعاطفية، لأنّ الذاكرة هي البؤرة التي تشتبك وتتصارع بها هذه الأبعاد المتعدّدة. وتستفحل أزمة (حافظ) مع مكابدة وعناء الذاكرة التي تضغط على ذهنه ووجدانه وتحيله دوماً إلى مناجاة الماضي البعيد بكل تداعياته وشخوصه، مما يؤدي إلى هيمنة النزعة (النوستالوجية)، على الشخصيّة إذ تتحوّل الذاكرة بكل هيمنتها وتدفقها إلى وسيلة لسحب الشخصيّة إلى ماضيها، وإلى أزقّة بغداد وحواريها الشعبية القديمة، وإلى ثلة الأصدقاء المقرّبين منه (حسن) و(باسم) و(كمال)، ويتضمن هذا الالتفات أو النكوص الماضوي كلّ الأحداث والمنعطفات في حياة (حافظ) بوصفه الشخصيّة المركزية التي تدور حولها الأحداث، وتدور حولها شخصيّات الرواية وعقدتها وحبكاتها الثانوية.
فالرواية تتّسم بالسعة والتفاصيل المكانية القديمة والحديثة، وإنّها تجسّد مسافة زمنيّة تمتد لأكثر من نصف قرن، وخلالها يتم التطرّق عبر منظور الذاكرة الى الأحداث والمفارقات والشخصيّات على المستوى السياسي والاجتماعي والوجداني، مما جعل الرواية مساحة أو فضاء بانورامياً لمتابعة ثنائية التراتب السردي ومساراته بين الحدث الماضي والحدث العام بين اليومي والتاريخي.. وعلى وفق هذا المسار فإن الكاتب يرتكز في بنائه السردي على تقنيّة الاسترجاع أو (الفلاش باك) لاستعادة الماضي بكلّ تفاصيله وتداعياته ودلالاته، وتمثل شخصيّة الطبيبة النفسية شخصيّة موازية لشخصيّة (حافظ) بوصفها الملجأ أو الملاذ للتخلّص من اشباح وكوابيس الذاكرة، بعد أن اضطّر (حافظ) للبحث عن الحلّ أو ايجاد العلاج للتخلّص من (فوبيا) التذكّر وهيمنة النوستالوجيا إلى الماضي السحيق بكل مراراته، ومباهجه وأزماته وهو يستعيد الشخصيّات الاجتماعية الغرائبية، والأحداث السياسية والانقلابات وصور الاستبداد والفقر وأزمات الإنسان المتعدّدة، وقد برز دور الطبيبة لتخليص (حافظ) من فوبيا الذاكرة وهيمنة الماضي السحيق إذ تتحوّل علاقته معها إلى جلسات طبيّة بغية العلاج وتحريره من هذه الأزمة السايكولوجية الحادة، "وبعد فترة غير طويلة تم الاتصال بحافظ لمراجعة المستشفى في الزمان والمكان ليجد الطبيبة التي استقبلته ولتطمئنه بميسور الحالة، فما كان عليه إلاّ أن يكون واثقاً من امكانية الوصول الى نتائج مرضية تماماً عبر جلسات طبية ستحدّد وفقاً لجدول زمني، ومن هنا بدأت المباشرة بجلسات الاسترخاء والتفاصيل المسهبة الشفافة من حياته وأنْ لا يغادر أو يهمل صغيره أو كبيره من تلك الذكريات العالقة بذاكرته، وتلك التي تقضّ مضجعه ليبدأ بسرد حكاياته عن حياته وعما أحاط بها من حوله في زمانها ومكانها... مثل كلّ صباح تدب الحركة في أطراف بغداد، وازقتها، والمقاهي والدكاكين والأسواق فما بين مبكر لعمله أو مسرع لشراء فطوره مع صرير وفرقعة (كبنكات) الدكاكين وأزيز أبوابها الخشبية..." (الرواية: 10)، وتتحوّل الرواية إلى فضاء لثنائية (حافظ والطبيبة) النفسية، وتمثّل الذاكرة العنصر أو الدالّة المشتركة بينهما، وذلك بحثاً عن العلاج والتحرّر من نزعة التذكّر واجترار الماضي الذي تحوّل إلى حالة مرضيّة مؤذية، وتجد الطبيبة نفسها إزاء مفارقة أو أزمة انسانية لابدّ أن تتصدى لها وتخلص مريضها من (فوبيا) ووساوس التفكير القهري، وعدم التلّبس بالماضي لكنّها تستخدم وسيلة علاجيّة ونفسيّة لتخليص الشخصية من أعراض المرض المرتبط بوجع وهيمنة الذاكرة، بأن تجعله يتدفّق ويفرط في سرد الماضي وحكاياته ومنعطفاته كوسيلة لتطهير الذات، فالبوح النفسي وسيلة من وسائل التحرّر من عبء المعاناة والمكابدة، وذلك يُعدّ نوعاً من التفريغ أو التنفيس وصولاً إلى ادراك اللّحظة الراهنة، ورسوخ الإدراك بماهيّة الماضي الذي اندثر، ولا يعود، وما على الإنسان سوى العيش أو الاستغراق في الراهن، ولحظة الحاضر، وتوظيف الماضي بكلّ تداعياته لجعل الحاضر متدفقاً ومستقرّاً، قائماً على حقيقة الديمومة واستمرار الحياة التي تمثّل بطبيعتها مراحل متعدّدة متضادّة ومتناسلة، وتسعى الطبيبة إلى رسوخ هذا الادراك والنظر إلى الماضي بوصفه طاقة وليس نكوصاً أو مجموعة كوابيس، وهذا هو الحل للاستمرار بالحياة، وعدم التقوقع على الماضي واجتراره.
***********************************************
الصفحة الثانية عشر
بمشاركة قرّاء بارزين كركوك تحتضن {ملتقى المقامات} بنسخته الثانية
متابعة – طريق الشعب
شهدت مدينة كركوك خلال اليومين الماضيين، فعاليات النسخة الثانية من "ملتقى المقامات"، وسط أجواء ثقافية وفنية متميزة.
الملتقى الذي احتضنته قاعة مركز كركوك الثقافي يومي الأحد والاثنين، والذي نظمته اللجنة العليا للمقامات في المحافظة بدعم "فرقة موسيقى كركوك"، يأتي في إطار جهود رامية إلى الحفاظ على التراث الغنائي والموسيقي في المدينة، وتسليط الضوء على فن المقام العراقي، الذي يعدّ أحد أبرز الرموز الثقافية الكركوكية.
وحضر حفل الافتتاح شخصيات رسمية وثقافية وفنية، وجمع كبير من المهتمين في الموسيقى التراثية.
وافتتح الفنان نور الدين الجاف، الملتقى بكلمة قال فيها أن الهدف من هذا الحدث هو إعادة الاعتبار لفن المقام في كركوك، وتعريف الأجيال الجديدة بهذا التراث العريق.
وشارك في الملتقى فنانون من مدن كركوك وكرميان وخانقين والسليمانية وأربيل، فضلا عن مدن كردستان إيران. وقد ساهمت في فعاليات اليوم الأول نخبة من قرّاء المقام المعروفين، أمثال چنار كركوكي، أحمد نجيب، يونس توتنجي، شمال محمد توفيق، وحمه هيوا، الذين قدّموا مقامات متنوعة باللغات الكردية والتركمانية والعربية، عكست غنى المشهد الثقافي والفني في كركوك، وأبرزت تنوعه القومي واللغوي. كما تم خلال الحفل تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي كان لها دور بارز في دعم وإنجاح هذا الملتقى.
أما في اليوم الثاني والأخير، فقد تواصلت الفعاليات بمشاركة أسماء أخرى من قرّاء المقام.
وفي حديث صحفي قال رئيس "فرقة موسيقى كركوك" الفنان جالاك صدیق، أن فرقتهم تضم نحو 20 عازفا ومغنيا، مبينا انهم استعدوا لهذا الحدث بمستوى عال من الالتزام الفني "فالمقام ليس مجرد أداء موسيقي، بل هو هوية ثقافية وانتماء حضاري لكركوك والمنطقة".
وأشار إلى ان "هذا الملتقى يُمثل تظاهرة مقامية وموسيقية واسعة"، لافتا إلى ان "كركوك منبر لفن المقام، وانه من المهم أن نعيد لها هذا الدور من خلال فعاليات نوعية، تجمع أهل الفن وتفتح أبواب الحوار الموسيقي بين المناطق المختلفة".
*******************************************
اتحاد الأدباء يستذكر الفنان الراحل جواد محسن
متابعة – طريق الشعب
نظم الاتحاد العام للأدباء والكتّاب أخيرا، جلسة استذكار للفنان الراحل جواد محسن، حضرها جمع من الأدباء والمثقفين والفنانين.
الجلسة التي التأمت على قاعة الجواهري في مقر الاتحاد، أدارها د. علاء كريم، واستهلها بتقديم سيرتي الفقيد الذاتية والإبداعية، معرجا على نشاطاته في ميادين الأدب والثقافة والموسيقى.
وفي كلمة له، ذكر نائب الأمين العام للاتحاد الناقد علي الفواز، أن "محسنا كان كتلة من الحياة، وحلماً يمشي على قدمين. كما كان يؤمن بأن الجمال هو الذي يجعل الحياة أبهى، منذ بداياته في سبعينيات القرن الماضي كاتباً وأديباً، حتى توجهه إلى الموسيقى".
بعدها ألقى الفنان عماد نافع كلمة باسم عائلة الفقيد، أشار فيها إلى أهمية محسن كصوت مثقف شهد له كبار الملحنين والموسيقيين في العراق، إبان فترة نضوج الأغنية العراقية في سبعينيات القرن الماضي.
وفي سياق الجلسة عُرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الراحل، تضمن كلمات وشهادات بحقه قدمها عدد من الفنانين والكتّاب.
هذا وساهم عدد من الحاضرين في الحديث عن الفقيد وتجربته.
************************************************
فيلم عراقي إلى {مهرجان لوكارنو}
متابعة – طريق الشعب
اختير الفيلم العراقي "إركالا – حلم كلكامش"، جديد المخرج السينمائي محمد جبارة الدراجي، للمشاركة في الدورة الـ78 لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في سويسرا، والتي من المقرر أن تُنظم في الفترة من 6 إلى 16 آب المقبل.
وجرى اختيار الفيلم للمشاركة في المهرجان، من قبل المركز العراقي للفيلم المستقل، وشركة "هيومن فيلم" للإنتاج الفني في الدنمارك وأستوديو "إيمج نيشن أبو ظبي" و"بيت أمين" للإنتاج الفني في السعودية وشركة "يونسو فيلم" للإنتاج الفني.
وإلى جانب الفيلم العراقي، ستشارك ثمانية أفلام عربية في المهرجان من فلسطين ولبنان وتونس.
وتدور أحداث فيلم "إركالا – حلم كلكامش" في بغداد، حيث يهرب طفل شوارع يُدعى "جم –جم"، مصاب بداء السكري، إلى عالم الأسطورة، ساعيًا إلى استعادة والديه للحياة. وبينما ينزلق صديقه نحو العنف، يجد "جم – جم" نفسه مضطرًا لإنقاذه، مستعينًا بظلال كلكامش والثور المجنح، في مدينة تأبى أن تموت.
ويمزج الفيلم بين الرمزية والأسلوب الواقعي، ويُسلّط الضوء على رحلة طفل وسط الفوضى السياسية والاجتماعية، مستخدمًا أسطورة كلكامش كقالب سردي لإعادة قراءة مصير الطفولة العراقية وإنتاج المعنى من الألم.
ويُعد اختيار الفيلم للمشاركة في هذا المهرجان إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل المخرج محمد جبارة الدراجي على الساحة السينمائية العالمية، بعد مسيرة حافلة أخرج خلالها أكثر من 6 أفلام طويلة ووثائقية، وشارك في أكثر من 500 مهرجان عالمي، حاز خلالها على أكثر من 100 جائزة دولية.
ويُعتبر الدراجي ومجموعته السينمائية من أبرز روّاد السينما العراقية الحديثة بعد 2003. حيث أنتج أكثر من 15 فيلمًا بين طويل وقصير ووثائقي. ويُعتبر فيلمه "ابن بابل" من أبرز أعماله. وقد نال الدراجي لقب أفضل مخرج في الشرق الأوسط عام 2010، وفق استفتاء لمجلة "فارايتي" العالمية.
*******************************************
تبرع سخي
قدمت عائلة الفقيد عباس حسون الربيعي (ابو بسام) دعماً مالياً لبناء بيت الحزب الجديد، مقداره (150) الف دينار عراقي.
فألف شكر لعائلة الفقيد العزيز على وقفتها لدعم الحزب في اكمال مشروع بناء بيت الحزب.. بيت العراقيين.
جاء هذا الدعم بناء على وصية الفقيد (ابو بسام) لعائلته بمواصلة دعم الحزب ونضاله واسناد مسيرته لتحقيق خير الشعب والوطن والانتصار لقضايا الفقراء والمهمشين والكادحين، والسير الى امام نحو وطن حر كامل السيادة، يتمتع ابناؤه وبناته بالعيش الرغيد الآمن.
**************************************************
يحتفي الاتحاد العام للأدباء والكتّاب ودائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة، هذا اليوم الثلاثاء، بالشاعر والمترجم الكبير ياسين طه حافظ، في مناسبة اختياره رمزاً من رموز الشعر العربي للعام ٢٠٢٥ من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).
جلسة الاحتفاء التي سيديرها الشاعر عمر السراي، تبدأ في الساعة 6 مساء على قاعة الجواهري في مقر الاتحاد بساحة الأندلس.
***************************************************
ليس مجرد كلام.. عيدنا الوطني!
عبد السادة البصري
يوم قرأت خبر عدم إدراج يوم 14 تموز ضمن العطلات الرسمية وإلغائه، ترقرقت الدموع بعيني وضربت كفاً بكف متسائلا مع نفسي: الى أين ذاهبون، وكيف سيكون حالنا كمواطنين بلا عيد وطني لبلادنا أسوة بكل بلدان العالم (الكبيرة والصغيرة، المتقدّمة والمتأخرة، الغنيّة والفقيرة)؟!
لحظتها عدتُ بذاكرتي الى أيام الطفولة والصبا والشباب في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم حين تشرق علينا شمس يوم 14 تموز مع صفّارات البواخر وهي تعزف موسيقى الفرح بالعيد الوطني للعراق، وتنطلق الدفوف والمزاهر والزغاريد ليمتلئ الشطّ بالزوارق والبواخر مزهوة بأعلام الزينة ورافعة بأعلى صواريها العلم العراقي يرفرف عالياً مع (الصفكة) البصراوية المحبّبة للنفوس، ويتمّ فيه ختان مجانيٌّ للأطفال وتوزيع كسوة الفقراء وغيرها.. لحظات لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الأجيال التي سبقتنا والتي لحقتنا كذلك لما لها من وقعٍ في النفوس وزهوٍ وطنيٍّ لا مثيل له!
في يوم 14 تموز من عام 1789 قامت الثورة الفرنسية بأحداثها الجسام، ليظلّ هذا اليوم منذ تلك اللحظة والى هذه الساعة عيداً وطنياً للفرنسيين يحتفلون به كل عام، لم تلغه أي حكومة جاءت ضمن هذه المدة والتي تربو على 334 سنة سواء اتفقت أم لم تتفق مع مبادئ الثورة وأهدافها كون تاريخها هو العيد الوطني للبلاد!
وفي 14 تموز عام 1958 قامت الثورة التي حرّرت العراق من ربقة الاستعمار والتحالفات الإمبريالية والرجعيّة مثل حلف بغداد وغيره، وتم إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية وإخراج العراق من التبعية والهيمنة البريطانية وغيرها، وإنهاء الإقطاع ليتحرّر الفلاّحون الذين أكل الإقطاعيون أعمارهم وساموهم أشدَّ أنواع الاستغلال والعبودية والاذلال ويصدر قرار توزيع ملكية الأرض بالعدل والإنصاف (الأرض لمن يزرعها) لتنطلق ابهى حملات الإصلاح الزراعي وتلبس أرضنا حلّة خضراء قشيبة مزهوة بالفرح والإنتاج. كما تم السماح بتأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات الفلّاحية وغيرها لينبثق منها اتحاد الأدباء والكتّاب ونقابة الصحفيين العراقيين عام 1959، إضافة الى نقابات العمّال وما إلى ذلك، ليبدأ عصر جديد من العمران والبناء والتقدّم على كل المستويات وفي كل الاتجاهات اجتماعياً وتعليمياً وصناعياً وزراعياً وغيرها رغم ما كانت تُحاك من مؤامرات لتفتيت وحدة العراق حيث توحّدت مكوناته تحت راية الجمهورية بعراق موحّد خالٍ من كل أنواع الطائفية والمحاصصة المقيتة ، التي عاد شبحها الآن يهيمن على مقدّرات الوطن للأسف الشديد!
هذا التاريخ لم يلغه الذين قاموا بانقلابهم الأسود عام 1963 وما فعلوه بقادة الثورة والرجال الذين نذروا أرواحهم في سبيل وطن حر وشعب سعيد، بل ظلّ عيداً وطنياً حتى بمجيئهم للهيمنة على الرقاب والعباد مرة أخرى عام 1968 وحكمهم الدكتاتوري الدموي الفاشي!
في التاريخ شواهد حقيقية لا يمكن محوها أبداً، وثورة 14 تموز 1958 ستظلّ عيداً وطنياً عراقياً لأنها حرّرت الأرض والناس من ربقة التحالفات والاستعمار والهيمنة الرجعية وفتحت آفاقاً جديدة في حياة العراقيين لن تمحوها أي محاولة مهما كانت، لأنها مغروسة في الضمير والوجدان والنفوس!
*******************************************
قف.. الهاوية
عبد المنعم الأعسم
يتكرر الحديث عن "مستقبل العراق" حتى اصبح هذا المستقبل كما لو انه قطعة ارض بجادرية بغداد، لا احد يعرف كيف نُهبت، ولا كيف يمكن استعادتها، ويذهب البعض الى استخدام جرعة مخدرة عنوانها "لا يصح إلا الصحيح" حتى بعد ان يُهزم الصحيح وينتصر الخطأ في اكثر من امتحان، والغريب ان ثمة دعاة احترفوا ترويج بدعة بالية بين جمهرة من ضحايا الخوف والتهديد اليومي بالقول انه كلما تشتد الازمة، وتعمّ الاهوال، وتسيل الدماء، وتنتشر المظالم والجثث والمفاسد سيأتي الفرج ويحلّ المستقبل الوضاء للعراق. وفي كل مرة يتعافى السؤال ويصبح جادا، وواضحا، ومُلحّا (كما هو الان) عن المسؤول الذي تسبب في تعريض العراق ومستقبله الى الخطر، يستنفر اصحاب الشأن والمعنيون وبعض المستشارين والدعاة وخطباء الجوامع في البحث عن دربونة يختبئون فيها من استحقاقات هذا السؤال، الذي يتضمن ايضا تسمية المسؤول عما حصل ويحصل.
وبوجيز الكلام، يمكن القول دون الشعور بالاستعجال، ان ملامح مستقبل العراق ليست واضحة ولن تتضح، ويشرف على الهاوية، في حال استمرت قبضة سلطة الفساد تمسك بعقارب الساعة.. وعقارب الساعة تتوقف، لكنها لا تعود الى الوراء، لو يعلمون.
قالوا:
"يا لهاويتنا كم هي واسعة".
محمود درويش
***********************************************
{طريق الشعب} في رسالة ماجستير
النجف – طريق الشعب
جرت السبت الماضي على "قاعة الدكتور محمد بحر العلوم" في معهد العلمين للدراسات العليا في النجف، مناقشة رسالة ماجستير عنوانها "الكفاية الرقمية في المؤسسات الصحفية العراقية - دراسة ميدانية لصحف الصباح والزمان وطريق الشعب"، تقدم بها طالب قسم الإعلام في المعهد حيدر علي حمود.
وجرت مناقشة الرسالة من قبل لجنة ضمت أ.د. عبد السلام السامر رئيسا وأ.د. اكرم فرج الربيعي عضوا وأ.د. راجي نصير عضوا وأ.م.د صفد حسام حمودي مشرفا وعضوا.
وبعد مناقشة استمرت أكثر من 4 ساعات، قُبلت الدراسة بتقدير جيد جدا عال.
************************************************
خلال العام 2025 دار الكتب والوثائق ترمّم ألفي وثيقة تاريخية
متابعة – طريق الشعب
أعلنت دار الكتب والوثائق إنجاز ترميم أكثر من ألفي وثيقة تاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الدار في بيان صحفي، أنه في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الإرث الوثائقي العراقي بعد تعرضه إلى أضرار جسيمة نتيجة أعمال الحرق والتخريب التي طالت الدار عام 2003، تم إنجاز ترميم أكثر من ألفي وثيقة خلال النصف الأول من هذا العام، تعود إلى العهد العثماني وتخص ولايتي بغداد والموصل.
وأضافت الدار أن عمليات الترميم تجري بوتيرة منتظمة منذ عام 2006، بمتوسط سنوي يبلغ نحو ثلاثة آلاف وثيقة.
من جانبها، قالت مسؤولة المركز التدريبي لحفظ وصيانة الوثائق، أزهار وليد، أن "عمليات الترميم تتم وفق سياقات فنية ومهنية دقيقة، تبدأ بتشخيص الأضرار بدقة عالية، تليه مراحل متخصصة تشمل التعقيم والمعالجة، ثم اختبار الأحبار المستخدمة لتحديد مدى حساسيتها للماء، ليتم بعدها ترميم الأجزاء التالفة باستخدام الورق الياباني عالي الجودة".